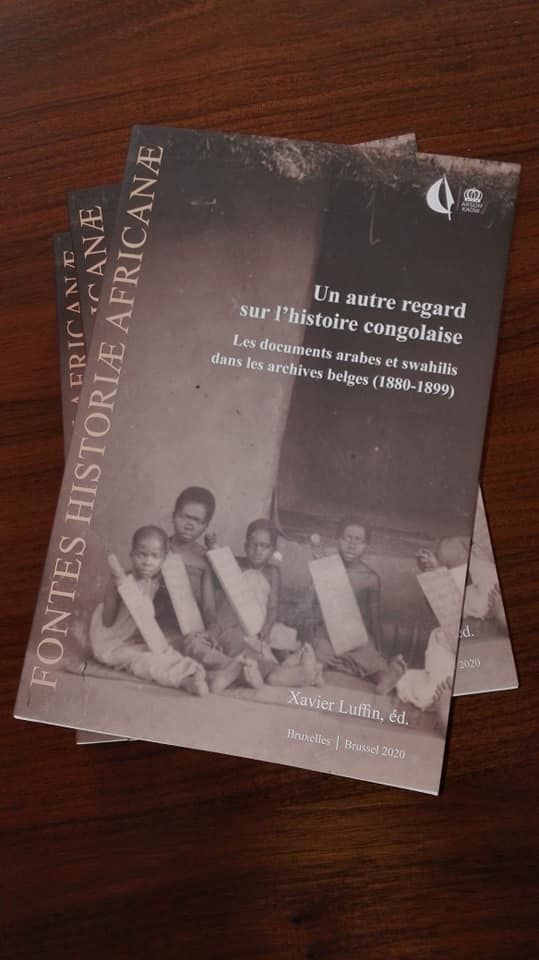نال البروفيسور والمستشرق البلجيكي كزافييه لوفان (50 عاماً) الذي نقل بأمانة وسلاسة عشرات الكتب العربية إلى الفرنسية، وبحث في مكنونات الأدب العربي المعاصر، جائزة الترجمة الكبرى لمدينة "آرل" خلال الملتقى الأدبي للترجمة في نوفمبر الماضي.
كما نالت ترجمة لوفان الفرنسية لرواية "الجنغو- مسامير الأرض" للكاتب السوداني عبدالعزيز بركة ساكن جائزة "الأدب العربي – لاغاردير". وهو اليوم رئيس قسم اللغات والأدب في جامعة "بروكسيل الحرة" منذ عام 2013.
تتمّيز أعماله المترجمة بالتقاط روح النص العربي مهما صعبت حكاياه أو تعقدت لغته الشعبية أو المحكية، ونقله إلى لغة موليير بشكل دقيق وجميل وسهل قد يفوق جمالاً اللغة الأصلية للكتاب.
لغة الشارع الموسيقية
من خلال أعماله، يبدو مترجم نصوص أمير تاج السرّ وأحمد الملك ورانيا مأمون وطه عدنان ومنصورة عزالدين ورشيد الضعيف ونوال السعداوي وسمير النقاش، شغوفاً باللغة العربية وثقافاتها (الشامية، الإفريقية في مصر والمغرب، والخليجية). كيف لا وهو نشأ في مجتمع متنوّع في حيّ شعبي في بروكسيل، يسكنه عرب وأتراك وأفارقة وبشر من العالم، كما يسرد في حديث لـ "الشرق".
"كانوا أصدقائي ورفاقي في المدرسة يتكلمون كل هذه اللغات على مسمعي وكنت أسمع العربية في الشارع وفي الدكاكين وفي المواصلات، فاعتادت أذنيّ نغماتها، وكنت مشغولاً دائماً باكتشاف ثقافة أصدقائي العرب التي تكمن وراء تلك اللغة"، بحسب قوله.
ويضيف: "قبل دراسة اللغات الشرقية في الجامعة درستُ الآثار، ومنذ طفولتي كنت مهتماً بها خصوصاً آثار الشرق الأوسط، لذا ذهبت إلى بلدان عربية عدة لأشارك في حفريات أثرية، مثل منطقة الجزيرة في الشمال السوري، فبدأت دراسة العربية لأعرف اللغة التي تستخدم في البلدان حيث سأعمل، فزرت تقريباً الدول العربية كافة، ولكن عشت في كثير منها فترات قد تصل إلى السنة (اليمن، سوريا، مصر والسودان)".
وقبل 30 سنة، عندما اكتشف لوفان العربية، ترك الآثار ودخل عالم لغة الضاد التي يتحدثها بطلاقة أصحاب البلاد.
بين مفترق العامية والفصحى
كثيرون هم الشباب العرب المتغربون عن لغتهم الأم اليوم، وغير متصالحين معها على اعتبارها لغة معقدة وغير عصرية، فكيف يقيّم وضعها الباحث في أسرارها؟ يجيب لوفان: "عندما نقرأ الأدب العربي، نجد أن هذا الوصف صحيحاً، فهناك شرخ بين اللغة الفصحى الأدبية المنمّقة وواقع الأحداث وعالم الكاتِب".
ويضيف: "برأيي عندما نقرأ حوارات علينا أن نتخيل الحوارات كما هي في الواقع، وهذا سهل جداً في رواية مكتوبة بالفرنسية أو الإنجليزية مثلاً، لأن الاختلاف بين المحكية والمكتوبة بسيط. مثلاً عندما نقرأ رواية لنجيب محفوظ تقع أحداثها في حي شعبي بالقاهرة، نقرأ الحوارات بالفصحى، وهذا لا يعكس الحقيقة والعالم الواقعي. فأظن أن لهذا السبب مثلاً الجيل الجديد يرى في الفصحى لغة معقدة، لأنها ليست ما يستخدمها القارئ".
يعتقد لوفان أن العربية اليوم "أمام مفترق الخيار بين الاستمرار في الوضع الحالي (استخدام لغتين الفصحى والعامية) أو استخدام لغة واحدة موحّدة، وهي ستكون مثلاً العامية أو هذه اللغة الثالثة بين العامية والفصحى".
يقول: "حل هذه المفارقة هو خيار لغة جديدة كما فعل الفرنسيون أو الفرانكوفونيون في نهاية القرون الوسطى مثلاً، فكانوا يستخدمون اللاتينية كلغة رسمية، وفي النهاية تبنّت السلطات اللغة الشعبية محل اللاتينية".
ويتابع: "ولكن هناك نتائج سلبية لتلك الخطوة، مثلاً الفرنكوفونيون اليوم لا يستطيعوا قراءة نص كُتب باللاتينية قبل 500 أو 1000 سنة بسهولة، وكذلك الأتراك من المستحيل أن يفهموا نصاً كُتب في القرن 19 مثلاً بسبب اللغة العثمانية وبسبب الحروف المستخدمة في ذلك الوقت أيضاً"، كما شرح لوفان معلقاً: "في الغرب ابتكرنا ثقافات جديدة ولكن فقدنا جزءاً من ثقافتنا".
في المقابل يؤكد لوفان أن "القارئ العربي المثقف يمكنه فهم المعلّقات التي كتبت في الجاهلية لأن اللغة الفصحى المستخدمة اليوم قريبة جداً من اللغة القديمة، فإذا العرب قرروا اختيار العامية بدلاً من الفصحى في الأدب مثلاً، سيسبب ذلك مشاكل، يعني القارئ العربي سيخسر ثروة أدبية وتراثاً كبيراً، وسيكون من الصعب جداً، بعد جيل أو جيلين أن يفهم النصوص المكتوبة بالفصحى إذا لم يدرسها في المدرسة".
يقول: "هذا الخيار صعب فلا أعرف إلى أي حد هو سيئ أو جيد، وما إذا كان سيحصل أم لا، لكنه يحتاج إلى البحث".
حركة أدبية خاصة
يلمس لوفان نوعاً من التجديد اللغوي منذ فترة طويلة في الأدب العربي. يقول: "كثير من الكتّاب المعاصرين يسردون الرواية بالفصحى والحوارات بالعامية، وهذا بداية حل في رأيي؛ لأن استخدام العامية في الحوارات يعطي القارئ الانطباع أن هذه الحوارات تلقائية".
ويلفت لوفان إلى نموّ حركة أدبية خاصة تتجسد في كتابة رواية كاملة بالعامية، يتّبعها قلّة من الكتّاب خصوصاً في مصر، متسائلاً: "هل هي بداية حركة ستتسع في المستقبل أم لا من جديد، لا أعرف الجواب، ولكن على الأقل هي تجربة وكل تجربة شيء جميل ومفيد لثقافة ما".
جسور ثقافية
تجسّد الازدواجية بين الفصحى والعامية واختلاف المستويات اللغوية في لغة الضاد، إشكالية يواجهها مترجم النص العربي، بحسب لوفان. الأمر الذي يشكل "تحدّياً للمترجم وهو ما يدفعه لحُب عمله، فعندما يكون على المترجم التفكير كيف سيعكس روح الرواية أو البعد اللغوي الموجود فيها، من لغة عربية إلى لغة مختلفة جداً كاللغة الفرنسية هذا يعطي نوعاً من التحدي، وهذا الشيء جميل"، بحسب قوله.
وهناك مشاكل أخرى تواجهه، "كالاختلاف الثقافي الشديد في بعض الأحيان، وهذا يعتمد طبعاً على الرواية الأصلية". ويعطي مثلاً من الأدب السوداني، "فالمَشاهد الموصوفة في بعض الروايات بعيدة عما يمكن أن يتخيل القارئ الفرنسي، إذاً على المترجم أن يجد الجسور التي ستساعد القارئ الفرنسي ليفهم بالتفصيل ما يوصف في الرواية، وهذا ينطبق أيضاً على الأدب السوري والعراقي والأدب العربي بشكل عام". ولكن، "هذا ليس شيئاً خاصاً باللغة العربية، فأمام كل مترجم يوجد هذا النوع من التحديات".
المترجم مرآة للكتاب
هل يعود لوفان المدرك لأسرار العربية ولهجاتها إلى الكاتب نفسه عندما يُترجم نصاً؟ يجيب: "في كثير من تجاربي أتواصل مع الكاتب أدبياً وإنسانياً، خصوصاً عندما تواجهني صعوبة في نقل التفاصيل أو عندما أشك في معنى أو تعبير معين، مثلاً عندما كنت أترجم أعمال عبدالعزيز بركة ساكن ذهبت إليه في السودان ثم التقينا في بلجيكا وفرنسا وكندا والكونغو، وأصبحنا أصدقاء وما زلنا، وكذلك فعلت مع رشيد الضعيف، لكن ليس مع الجميع".
أما سرّ نجاح ترجماته فيكمن في "معرفتي عن قرب لبيئة هذه البلدان وتاريخها الذي قرأت عنه الكثير، ومعاينتي السياقات الموصوفة في الروايات والقبائل والشعوب وأحياناً نماذج لشخصيات الروايات خصوصاً في السودان واليمن ومصر وسوريا حيث عشت لفترات"، بحسب قوله.
ويضيف: "مثلاً في حالة رواية (الجنغو) التي فازت ترجمتها بجائزتين، لو لم أسافر إلى شرق السودان لما كانت ترجمتي على المستوى نفسه من الدقة".
هل يحق للمترجم التدخل بلغة الرواية أو البنية أو الأسلوب، فيحذف منها كما حصل مع "التجليات" لجمال الغيطاني؟ يقول لوفان بحزم: "إطلاقاً لا، المترجم هو مجرد مرآة للكتاب، فلا يعطي رأيه الشخصي، ومن ميزات المترجم الجيد أن يكون مخلصاً للكاتب والكتاب ولأدق التفاصيل وألا يمسّ هوية النص الأصلي، على الأقل هي استراتيجيتي الشخصية وأي حذف هو من المحرّمات".
ويضيف: "أحاول أن أبقى قريباً جداً من لغة الرواية، من أسلوب الكاتب، معاني الكلمات، غاية الكاتب، ولكن أحياناً يستخدم الكاتب العربي 4 كلمات مترادفة في الجملة، وفي الفرنسية نتجنّب ذلك، فتفرض علينا الحالة إيجاد استراتيجية لنعكس الفكرة بطريقة أخرى".
يميل كزافييه لوفان إلى ترجمة الرواية على اعتبارها غنية بالمعلومات وواسعة الأفق، أكثر من الشعر والقصص القصيرة.
ترجم لكتّاب من مختلف البلدان العربية إلا أن اسمه واهتمامه ارتبطا بشكل وثيق بترجمة الأدب الإفريقي خصوصاً في مصر والسودان وإريتريا والصومال والمغرب وتونس. فهو يعتبر نفسه "منفتحاً على كل الثقافات العربية وأتابع عن كثب الأدب السوري والعراقي واليمني والخليجي". فهو يحب "عبده خال من السعودية، وأطمح لترجمة السوري سليم بركات".
هل تقوده هذه الترجمات للبحث في غمار الأدب العربي الذي كتب عنه دراسات نقدية مثل "الربيع العربي والأدب" و"الدين والأدب العربي المعاصر- بعض ملامح نقدية" و"صورة الأفارقة وإفريقيا في الأدب العربي المعاصر"؟
يردّ: "أحياناً تقودني الترجمات إلى تأليف هذه الكتب والعكس صحيح، وأكتشف من خلال الدراسات بعض النصوص لترجمتها كما تساعدني لإغناء ثقافتي العربية ومحاضراتي في الجامعة، إذاً هي عملية في أكثر من اتجاه".
حروب وثورات وخيال
كيف يقيّم البروفسور لوفان الأدب العربي اليوم، خصوصاً بعد ثورات وحروب مستجدة في المنطقة، من بين الآداب الأخرى؟ يقول: "هذه الأحداث المأساوية، أدت في مجال الأدب إلى روح ابتكار روائي جديد عميق جداً. هناك كتّاب عراقيون وسوريون استوحوا من هذه الأحداث ليكتبوا روايات عميقة مهمة جداً منفتحة على العالم، مثل (فرنكشتاين في بغداد) لأحمد السعدوي أو (سبايا سنجار) لسليم بركات"، كما يصرّح.
ولكن، "المؤسف أن الكتّاب العرب وجدوا إلهامهم في هذه الأحداث المأساوية التي حرّضت مخيلتهم، على عكس ما نجد في الأدب الفرنسي الذي أراه فقيراً اليوم، وإن كان هناك استثناءات جميلة، لكن بشكل عام فإن الكتّاب الفرنسيين ينحصرون في وصف حياتهم الشخصية ويومياتهم من دون أن نجد في رواياتهم بعداً عالمياً أو روحاً ابتكارية عالية كالتي في الأدب العربي المتعلق بالأحداث التي يعيشها اليوم". وهو ما قد يفسر تلقي القارئ الفرنكوفوني "بلهفة وترحاب للكتاب العربي المترجم للفرنسية وبالتالي إيجاد سوق لهذه الروايات بعد الربيع العربي".
أفكار مسبقة تمتدّ عبر التاريخ
يلمس المتابع أن المشهد الروائي العربي الذي يترجم إلى الفرنسية، يخضع لمعايير غير واضحة المعالم قد تكون تجارية أحياناً، خصوصاً في ميله إلى الرائج و"الإكزوتيك" مثل التطرّف والإسلام والجنس والمثلية والقمع والتحرّر النسوي، فهل لا تزال الصورة التي رسمها الاستشراقيون قديماً مترسخة في لا وعي القارئ الفرنكوفوني؟
يقول لوفان: "طبعاً للقارئ الأجنبي ميل، أو يبحث عن هذه المواضيع، ولكن لا أرى في ذلك ظاهرة خاصة للتلاقي بين العالم العربي والغرب، هذا صحيح في كل الحوارات بين الثقافات، للأسف الأفكار المسبّقة أو التحيّزات موجودة في كل ثقافة".
ويضيف: "أي قارئ من أي ثقافة عندما يقرأ كتاباً من ثقافة أخرى نعم له توقعات ويبحث عن شيء معين. وأنا ضد الفكرة المبسطة الموجودة في كتاب إدوارد سعيد، ولا أتفق إطلاقاً مع كلامه عندما ينتقد الاستشراقيين، طبعاً كان لديهم بعض الأفكار المسبقة، بعض التحيزات ولا تزال موجودة حتى اليوم، ولكن هذا كان صحيحاً في الاتجاه المعاكس أيضاً. وإذا أخذنا أدب الرحلة في اللغة العربية أو في اللغة التركية في القرن 19، هناك بعض الشرقيين الذين زاروا أوروبا أو أميركا، فجاء وصفهم لما رأوا مليئاً بالأفكار المسبقة، إذاً هذا الأمر طبيعي وهي ظاهرة عالمية".
ولكن المهم بالنسبة للبروفيسور لوفان أن الأدب العربي له سوق كبيرة في البلدان الفرنكوفونية بمواضيع مختلفة والكتب تساعدنا لنكتشف الآخر، وفي نفس الوقت كل هذه الكتب المترجمة التي تتحدث عن الجنس أو عن الحرب أو عن الإسلام هي كتب حقيقية كُتبت باللغة العربية إذاً أين المانع من ترجمتها؟ فهي جزء من التراث. والقارئ الفرنسي الذي يريد اكتشاف الأدب العربي الحديث لديه كثير من الفرص والإمكانات".