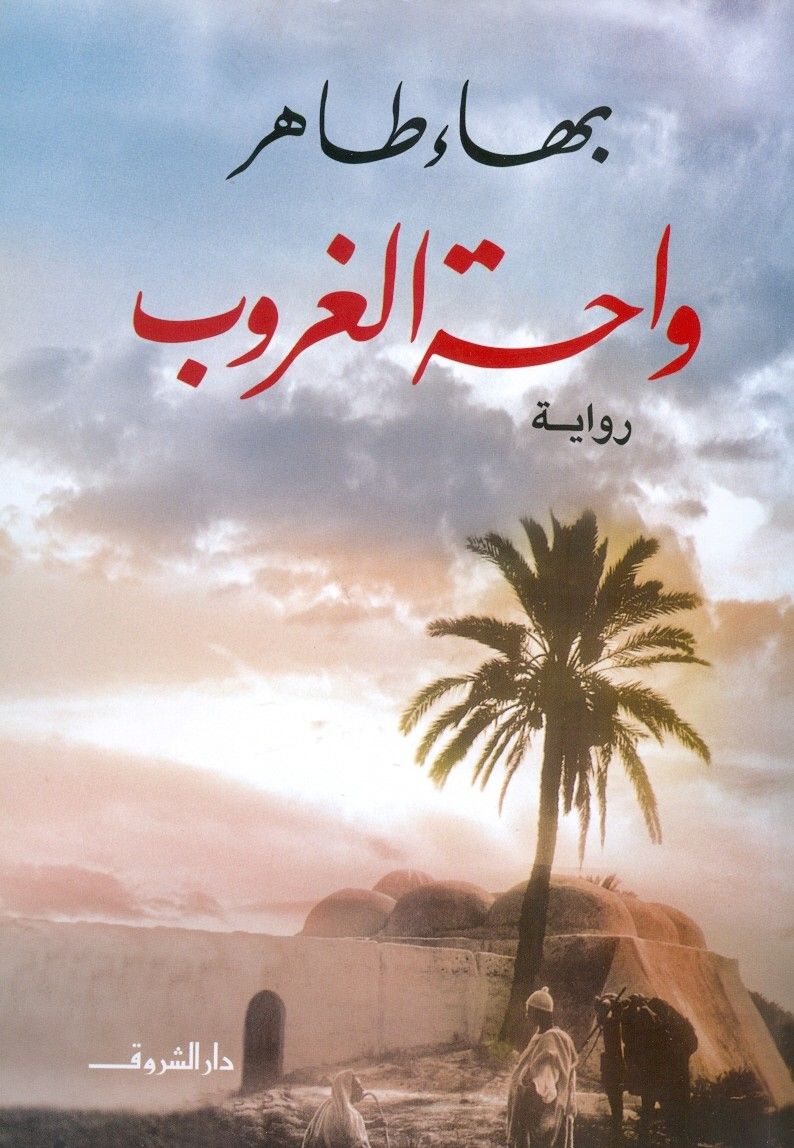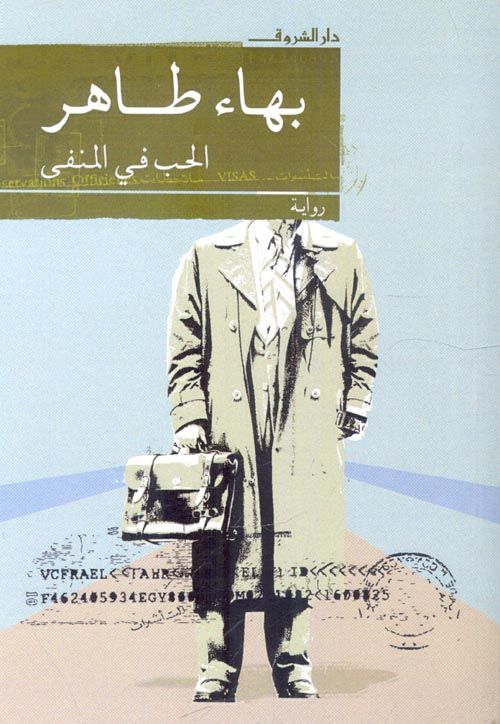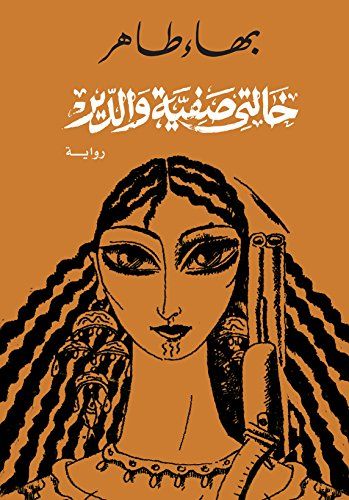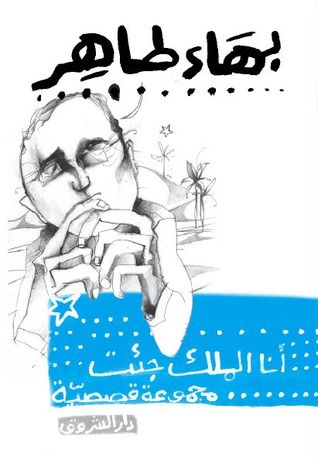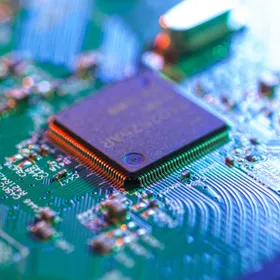في روايته الأخيرة "واحة الغروب"، كتب الأديب المصري بهاء طاهر الذي رحل الخميس عن عمر 87 عاماً، "لا أفهم معنى للموت.. لكن ما دام محتّماً فلنفعل شيئاً يبرر حياتنا. فلنترك بصمة على هذه الأرض قبل أن نغادرها".
لم تكن هذه العبارة مجرد جملة عابرة على لسان بطل الرواية، بقدر ما كانت تعبيراً عما يفكر فيه بهاء نفسه وهاجساً انشغل به منذ أن بدأ الكتابة، إذ كان حريصاً على أن يترك بصمات عديدة في كل المجالات التي أسهم فيها روائياً وكاتباً للقصة، ومترجماً، وناقداً مسرحياً، ومفكراً، ومخرجاً مسرحياً، وراعياً لأجيال من الكتاب الشباب.
فالكتابة بالنسبة لصاحب "الحب في المنفى" كانت رسالة لا نزهة، دعوة للتفكير وطرح الأسئلة القلقة، وهو الأمر الذي حرص عليه منذ أن نشر في مارس 1964 بمجلة "الكاتب" قصته الأولى "المظاهرة"، وهي القصة التي احتفى بها وقتها الروائي المصري يوسف إدريس (1927 -1991) وكتب يبشر بالكاتب الشاب الجديد "الذي لا يستعير أصابع غيره".
مؤلف "النداهة" وصف طاهر بأنه "إنسان مختلف، استطاع أن يدلف إلى قصر القصة المسحور، وأن يعثر في سراديبه المظلمة على الخيط الأساسي لصناعة القصة، وهي مسألة مهمة وخطيرة، فالإنسان لا يعثر على نفسه أو على الخيط الأساسي لقصته هكذا بسهولة ومن أول ضربة أو قصة، إن ما أعجبني في هذا العمل أنه بهائي طاهري إلى درجة كبيرة، وإذا استطاع الإنسان أن يكون نفسه الحقيقية تماماً في أي عمل يزاوله فإنه بهذه الاستطاعة يكون قد وصل إلى مرتبة الفن، وأصبح كل ما يلمسه ويكتبه - كالأسطورة الإغريقية المشهورة - ذهباً فنياً".
بعد نشر قصته الأولى، احتاج بهاء طاهر 6 سنوات لكي ينشر مجموعته القصصية الأولى "الخطوبة" (1972) التي اعتبرها النقاد وقتها "فتحاً في الكتابة الجديدة"، مخالفاً لما كان سائداً وقتها.
كان عالم قصص بهاء طاهر - حسبما وصفه الناقد صبري حافظ - "عالماً عارياً من الزوائد والإضافات، شديد الكثافة والاقتصاد، يبدو وكأنه بالغ الحياد أو واقع على حدود اللامبالاة، ولكنه مترع تحت هذا الرداء الحيادي الخادع بالعواطف والأشواق والصبوات الإنسانية البسيطة والمستعصية معاً".
"شيوعي دون أن أعرف"
في منتصف السبعينيات، حمل بهاء طاهر حقائبه ليبدأ رحلة منفى إجباري، في إطار "تغريبة المثقفين" التي بدأت مع وصول السادات إلى السلطة ولم تنتهِ باغتياله في 1981.
الأديب المصري يوسف السباعي (1917 - 1978)، الذي كان وزيراً للثقافة في السبعينيات، رفع شعار "تطهير الإذاعة من الشيوعيين" ولم يجدوا غير بهاء طاهر الذي سرد في كتابه "السيرة في المنفى" تفاصيل ما جرى: "أُبلغت أني الوحيد الذي أُهدر دمه في الإذاعة، توقفت طويلاً، تأملت هذا الاستنفار العدائي تجاهي بدهشة، لم أكن أعرف أني شيوعي إلا عن طريق هذا القرار.. كان يمكن أن يصبح الأمر مجرد قرار عليّ تقبله لو أني شيوعي بالفعل.. ولكني سألت نفسي: هل أنا شيوعي؟ ثم قلت لنفسي: لعلهم يعرفونني أكثر مما أعرف نفسي!"
بعدها غادر بهاء طاهر مصر تاركاً خلفه أشياء كثيرة: "صدق وجموح وبراءة ووجوه كأنها منقوشة على حجارة معبد".. ولكن كانت هناك أشياء أخرى كان من الصعب أن يتركها خلفه، لا يمكن إلا أن ترتحل معنا أينما كنّا.. ذكريات ربما، مواقف بعينها، حكايات عن الأب والأم، المكان الأول والحب الأول، عن القرية والناس والبيوت والجبل والمعبد والزرع والطين.
جمع بين كل هذه الحكايات أنها عن الغربة والحنين، ومنها صاغ عالمه الإبداعي وسيرته الذاتية أيضاً.
غربة قبل الولادة
غربة بهاء بدأت مبكراً، حتى من قبل أن يولد، عندما ترك والده قريته "الكرنك" في الأقصر (جنوب مصر) مرتحلاً بين المحافظات المختلفة، ولكنه ظل في حنين دائم إلى أرضه: "ظل أبي يصبو لبناء بيت في قريتنا في الصعيد حتى مماته".
يسأل بهاء: ماذا لو لم يترك أبي الأقصر ويرتحل بين البلاد ليستقر به المقام في الجيزة؟ هل كان مصيري سينصرف لسكة مغايرة؟ هل كنت سأعرف معنى الغربة مبكراً؟"ربما، كما يقول: "كنت سأظل كما أنا، "محمد بهاء الدين طاهر" ابن الناظر، أفندي في غالب الأمر لو استتب الأمر".
الإشارة إلى الاسم تكشف عن غربة أخرى، اختار له الأب اسم "محمد بهاء الدين" اسم مركب كعادة الأسماء في تلك الفترة، كان دائماً يشعر تجاه هذا الاسم بغربة. يسأل والده: لماذا هذا الاسم يا أبي؟
لكن غربة المكان ومعها ترحال الأب لم تجعل من بهاء مجرد "أفندي" أو "مزارع"، إذ دفعته إلى التعليم ثم إلى الكتابة ليختار هو اسماً جديداً "بهاء طاهر".
صاحب "خالتي صفية والدير" كتب في سيرته: "قبل أعوام كان اسمي محمد بهاء الدين طاهر. أجل هذا الاسم المركب. وهذا أنا، أو لعله ما سيتبقى ولو بعد حين". وكأن في العودة إلى الاسم القديم مصالحة مع ماضٍ من الترحال.
طائر يسافر دون حيلة
ربع قرن قضاه بهاء طاهر مغترباً، بينها 6 سنوات متنقلاً بين نيروبي وباريس وروما مترجماً بالقطعة، كان مثل طائر يسافر من غير حيلة بين السماوات، ولم يجد له موطناً كذاك الذي غادره، قبل أن يستقر به الحال في جنيف عام 1981 مترجماً فورياً في الأمم المتحدة. وهي تجربة كانت عامرة بالأسى، وعامرة بالتجربة الحية والمخزون الوفير.
وكانت زوجته ستيفكا أناستاسوفا تقول له: "بهاء إن ما زرعته في الغربة كان مثمراً دوماً". فيجيبها: "لم أزرع شيئاً هناك يا ستيفكا، صدقيني، أنت الشيء الوحيد الذي يمكن أن أزعم بصدق أن الغربة منحتني إياه".
وتقول له: "لكنك كتبت كثيراً هناك يا بهاء.. كثيراً". يجيبها: "وضاع عمري أكثر، أهدرته الغربة". فتضحك وتقول: "لو أن الطواويس تطير يا بهاء!" ويضحك هو أيضاً معها!
في أوائل التسعينيات، عاد بهاء من غربته حاملاً أسئلته التي حاول أن يبحث لها عن إجابة عبر الكتابة: "هل تركت الغربة بمحض إرادتي وعدت بهذا الكم من الحنين؟ أم أن الغربة لا زالت تسكنني وتستوطن أفكاري، بل مصيري كله؟ كم أحتاج إلى التقصي عن آثار تلك الغربة التي خلقتها في روحي؟".
سيرة الحب
كان الحب لا محاولة تغيير العالم، هو مدخل بهاء طاهر إلى الكتابة، بل كان رهانه الدائم أن الحب وحده ينقذ الأرواح التائهة.
في روايته " نقطة النور" يسأل أحد أبطال الرواية:
- حدّثني ماذا يقول جدك عن الأرواح؟
- يقول: الأرواح كلها جميلة وكلها طيبة.
- وهل قال لك، يا سالم، ما الذي ينقذ هذه الأرواح؟
- نعم، قال الحب.
يحكي بهاء في سيرته عن حبه الأول "سندس"، غجرية تكبره بعشر سنوات، كان صبياً يخطو أولى خطوات الرجولة، وكانت بالنسبة له مثل "الحلم الذي لا يمكن أن يستفيق منه عاشق أزلي"... "عيناها خضراوان، ولضحكتها وقع يشبه نغماً شجياً، تدور بين البيوت بربطة القماش الثقيلة، وصندوق ضخم تحمله على كتفيها من أجل حفنة نقود".
بسبب حبها انفتحت طاقة الكتابة لديه، كتب من أجلها الشعر، ولكنه - حسب وصفه - شعر رديء، وكما ظهرت فجأة اختفت أيضاً لتترك في قلب العاشق الصغير "حباً لا يمكن نسيانه، يظل وافراً وبهياً داخل أرواحنا بعبق زمانه" كما كتب.
ربما كان وجه "سندس" أساسياً في تجربة بهاء الإبداعية، وهي تظهر دائماً بأسماء متعددة، وقصص حب دائماً ما تكون غير مكتملة.
اللغة.. المعركة الرئيسية
على مدى نصف قرن، كتب بهاء 11 عملاً إبداعياً، 6 روايات هي (شرق النخيل، قالت ضحى، خالتي صفية والدير، الحب في المنفى، نقطة النور، واحة الغروب)، و5 مجموعات قصصية (الخطوبة، بالأمس حلمت بك، أنا الملك جئت، لم أكن أعرف أن الطواويس تطير، ذهبت إلى شلال)؛ وهو ما يراه البعض إنتاجاً ضئيلاً.
لكن بهاء لم يكن يقلق من ذلك، فكان شعاره "ألا أكتب إلا عندما يكون لديّ ما يستحق أن يقال".
كانت معركة بهاء الأساسية معركة مع اللغة، كان يكتب الجملة الواحدة عشرات المرات حتى تصل إلى درجة معيّنة من السهولة والبساطة، وتتميز بالصفاء والاقتصاد. لغة شفافة ليس فيها نوع من "فرد العضلات اللغوية"، أو "استخدام محسّنات بديعية شكلية"، ومع ذلك تحتوي على شحنة جمالية تغذّي القارئ.
مؤلف "واحة الغروب" قال في أحد حواراته: "لن تجد في كل كتاباتي كلمة واحدة يسأل القارئ عن معناها"، وكان هذا أحد الدروس التي تعلّمها من أستاذه يحيى حقي (1905 - 1992).
ورغم إخلاصه للرواية والقصة بمعناهما الكلاسيكي حيث البناء المحكم والسرد المتسلسل والإخلاص للحكاية إلا أن كتابته تميزت بثراء دلالي، حيث يتشكل النص من طبقات متعددة وبالتالي دلالات متعددة أيضاً، حيث يسعى بهاء بذلك إلى إشراك القارئ في إنتاج دلالات النص ومن ثم تأويله.
وبخلاف الأعمال الإبداعية، ترك بهاء عشرات الترجمات التي قُدمت في الإذاعة ولم تنشر في كتب، فضلاً عن إسهاماته في الفكر المصري، واهتمامه بقضايا الحرية والنهضة، ومسيرة التنوير المبتسر، والعلاقة بالغرب.
رحل بهاء طاهر.. وتتحوّل كلمات بطل روايته "واحة الغروب" إلى سؤال كبير: "سنموت بالطبع في النهاية، سنموت مثل كل الناس، ولكن يجب ألا نموت مهزومين".