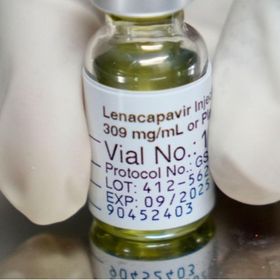ناجورنو قره باغ، إقليم في جنوب القوقاز، تقطنه غالبية من الأرمن، لكنه يبعد نحو 50 كيلومتراً عن أرمينيا ويقع جغرافياً في جنوب غربي جارتها اللدود أذربيجان.
تبلغ مساحة الإقليم نحو 4400 كيلومتر مربع، وتقع غربه أرمينيا التي شقت ممراً بين الجانبين، وإيران جنوبه، وعاصمته ستيباناكيرت. وإذا كانت ناجورنو قره باغ هي التسمية الشائعة للمنطقة، فإن سكانها بدّلوا اسمها إلى أرتساخ، وهي كلمة أرمينية.
يفيد موقع PopulationData.net بأن نحو 148 ألف شخص يقيمون في قره باغ، وفق إحصاءات عام 2019، كما أن إجمالي ناتجه المحلي يبلغ نحو نصف مليار دولار (2017)، وحصة الفرد منه تبلغ 3821 دولاراً (2017)، فيما ارتفع النموّ في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15.6% في 2017.
ويشير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ومقرّه العاصمة البريطانية لندن، إلى أن المنتجات المصنّعة في "قره باغ" تحمل ختم "صُنع في أرمينيا"، علماً أن الأخيرة لا تعترف رسمياً باستقلال الإقليم.
ويضيف المجلس أن الاستثمار الروسي المباشر في ناجورنو قره باغ، ارتفع في عام 2014، إلى 58.6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم. ولفت إلى أن الأرمن الروس هم مصدر هذه الاستثمارات إلى حد كبير، لا سيّما في السياحة والزراعة والتعدين والطاقة الكهرومائية.
"الحديقة السوداء"
تعني كلمة ناجورنو "الجبلية"، فيما أن كلمة "قره باغ" هي مزيج من اللغتين التركية والفارسية، وتعني "الحديقة السوداء". وشهدت جبال الإقليم أحداثاً تاريخية كثيرة، جعلتها بؤرة عنف ونزاع سياسي وعن الهوية، بين الأرمينيين والأذربيجانيين، يستحضر فيه الجانبان التاريخ، أو أجزاءه التي تناسب كلاً منهما.
وإذا كان التاريخ يكتبه المنتصرون، فإنه لا يخلو من تشعّبات وتعقيدات، وتفسيرات تُستخدم لخدمة سياسات ومصالح خاصة.
ويفيد معهد الولايات المتحدة للسلام، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن، بأن "مراقبين غربيين ينظرون إلى النزاعات التاريخية السابقة بين الأرمن والأتراك، في فترة 1894-1923، والنزاع الأرميني الأذربيجاني بشأن ناجورنو قره باغ، باعتبارها تطوّرات منفصلة".
ويتابع المعهد أن "أرمينيا وأذربيجان وتركيا يرون في نزاع قره باغ استمراراً للصراعات السابقة، وتعكس حساباتهم الاستراتيجية هذا الرأي".
"ليس صراعاً عرقياً"
ونقل معهد الولايات المتحدة للسلام عن فيليب ريملر، من وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن ذلك "قد يكون صحيحاً، وأن القومية ليست السبب المباشر لهذا الخلاف، وأنه ليس صراعاً عرقياً بالمعنى الدقيق للكلمة"، مستدركاً أن ذلك "قد يكون مسألة دلالات".
وأضاف المعهد أن "الصراع العرقي هو في الأساس نزاع على الموارد، إذ تنقسم الأطراف على أسس عرقية، أي أن التعبئة لهذه الصراعات تتأثر بشدة بالعوامل النفسية، وفي هذه الحالة، أشكال الهوية الوطنية".
أما الباحث في جامعة شيكاغو نسيب نسيبزاده، فاعتبر أن الحركة القومية الأرمينية، التي قادها الرئيس الأرميني السابق ليفون تير بتروسيان، أول رئيس للدولة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي (1991-1998)، أدت دوراً هائلاً في إثارة (قومية متطرفة) لدى الشعب الأرميني"، والتي بات "الأذربيجانيون هدفاً لها".
"مملكة أرمينيا"
في المقابل، يفيد موقع "أرمينيا بيديا" بأن ناجورنو قره باغ ظهر باسم "أورتيخي" أو "أورتيهيني" في الكتابات المسمارية الأورارتية. ويشير الموقع بذلك إلى مملكة قديمة باسم "أورارتو" (1500-585 قبل الميلاد). وأفادت موسوعة "بريتانيكا" بأنها شملت "المنطقة الجبلية جنوب شرقي البحر الأسود وجنوب غربي بحر قزوين، وتنقسم الآن بين أرمينيا وشرق تركيا وشمال غربي إيران".
وأشار "أرمينيا بيديا" إلى أن قره باغ بات "جزءاً لا يتجزأ من مملكة أرمينيا، بوصفه مقاطعة أرتساخ، وهي واحدة من 15 مقاطعة تقليدية في أرمينيا الكبرى".
وأضاف الموقع أن المنطقة شهدت أحياناً نزاعاً "بين أرمينيا وألبانيا القوقازية المجاورة"، التي لا تمت بصلة إلى ألبانيا المعاصرة. وأن المنطقة مثل بقية أرمينيا، كانت مطمعاً لقوى إقليمية أخرى، خصوصاً الفرس وبعد ذلك العرب. وفي العصور الوسطى، باتت موجودة بوصفها إمارة خاشين. وفي القرن الحادي عشر، دمّر السلاجقة الأتراك المملكة الأرمينية، لكن المناطق الجبلية بقيت سليمة نسبياً".
وذكر الموقع أن "الأرمينيين يقيمون في منطقة قره باغ منذ العصر الروماني"، مضيفاً أن "الأتراك المسلمين انتقلوا إلى سهولها السفلى بعد عام 1300".
وتابع أن "السيطرة على المنطقة انتقلت إلى بلاد فارس الصفوية في مطلع القرن السابع عشر"، لافتاً إلى أن أمراءها ناشدوا في القرن التاسع عشر "الإمبراطورية الروسية تحرير أراضيهم من الحكم الإسلامي". وزاد أن المنطقة انتقلت إلى تلك الإمبراطورية "بموجب معاهدة غولستان، بعد الحرب الروسية - الفارسية 1804-1813".
"طابور خامس"
في المقابل، أفاد موقع "قره باغ.أورغ" بأن "الإمبراطورية الروسية اعتبرت السكان الأرمن المسيحيين المقيمين في الإمبراطورية العثمانية وإيران، عنصراً أساسياً في تحقيق سياستها الشرقية بعيدة المدى، التي صُمّمت لتأمين وصول روسيا إلى شواطئ الخليج" العربي. وأضاف أن "السلطات الروسية بدأت باستغلال العامل الأرمني، منذ القرن الثامن عشر".
وتابع أن القيصر بطرس الأكبر سعى إلى "الاستفادة من ضعف الدولة الصفوية"، وأصدر "في 10 نوفمبر 1724 مرسوماً يتيح للأرمن الاستقرار في شريط من الأراضي الأذربيجانية على بحر قزوين"، وذلك باعتبارهم "طابوراً خامساً" في "تنفيذ خطط الإمبراطورية الروسية للاستيلاء على أراض شاسعة جنوب القوقاز، حتى الخليج" العربي.
وأشار الموقع إلى أن "معاهدة تركمنجاي"، التي أبرمتها الإمبراطورية الروسية وبلاد فارس القاجارية في عام 1828، بعد حرب بين الجانبين (1826-1828)، "نصّت على إعادة توطين 40 ألف أرميني في أذربيجان". وزاد أن 90 ألف أرميني كانوا مقيمين في الإمبراطورية العثمانية، "أُعيد توطينهم في أذربيجان" بعد إبرام الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية معاهدة أدرنة في عام 1829، والتي تلت حرباً خاضها الطرفان (1828-1829).
"صراع عرقي مفتوح"
تتعدد الروايات لكن النتيجة واحدة: النزاع الأرميني الأذربيجاني، في "قره باغ" يستنسل الأزمات، من عصر إلى آخر.
وأفاد موقع "جيوهيستوري" بأن التوتر بين سكان الإقليم تحت الحكم الروسي تحوّل "صراعاً عرقياً مفتوحاً، خلال فوضى الثورة الروسية عام 1905، وشهد مقتل آلاف من أذربيجان وأرمينيا أثناء مجازر متبادلة".
وأضاف أن "العنف تجدّد على نطاق أوسع بعد انهيار الإمبراطورية الروسية في عام 1917"، مشيراً إلى أن القوات البريطانية المتمركزة في المنطقة دعمت أذربيجان، على أمل "إبعادها عن النفوذ السوفيتي والوصول إلى احتياطاتها الضخمة من النفط".
وتابع الموقع أن "الأرمينيين في قره باغ هاجموا الحاميات الأذربيجانية في عام 1920"، فرّدت أذربيجان بـ"تدمير الأحياء الأرمينية في شوشا، أكبر مدينة في ناجورنو قره باغ"، وقتل آلاف من المدنيين.
ستالين "يذكّي الخلاف"
معهد الولايات المتحدة للسلام اعتبر أن الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين "فاقم الخلاف بوضوح وبذكاء"، مضيفاً أن الأخير أدرك في عام 1923 أن إلحاقه الإقليم الذي تقطنه غالبية من الأرمن (94%)، بوصفه "منطقة حكم ذاتي"، بجمهورية أذربيجان السوفيتية الجديدة، "سيجعله إلى الأبد بقعة نزاع بين الجمهوريتين (أذربيجان وأرمينيا)، من شأنها أن تضمن مكانة موسكو بوصفها وسيطاً" بين الجانبين، في إطار سياسة "فرّق تسد"، علماً أن البلشفيين سيطروا على الإقليم في عام 1920.
لكن اللعب بالنار يحرق أحياناً أصابع اللاعب. فمع وهن الاتحاد السوفيتي، إثر سياسة "غلاسنوست" (الشفافية) التي انتهجها الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، ناشدت الغالبية الأرمينية في "مجلس السوفييت الأعلى"، وهو المجلس التشريعي في قره باغ، ضمّ الإقليم إلى أرمينيا، وفق "المعهد".
وبعد رفض أذربيجان، والحكومة المركزية في موسكو، شهدت المنطقة عنفاً عرقياً عام 1988، أسفر عن سقوط قتلى وفرار وطرد مئات الآلاف من الأرمن والأذربيجانيين. وفي عام 1989، أصدر "مجلس السوفييت الأعلى" في أرمينيا قراراً بتوحيد الجمهورية مع قره باغ.
غورباتشوف وقره باغ
ويروي الباحث البريطاني توماس دو فال، المتخصص في شؤون القوقاز وأوروبا الشرقية، أن غورباتشوف انتقد قادة الحزب الشيوعي الحاكم، في باكو ويريفان، وشكا خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب، عُقد لمناقشة أحداث قره باغ، من أن "الجانبين يخفيان معلومات" في هذا الصدد، واتهمهما بـ"التورّط" بما حصل.
وأشار دو فال إلى أن "أدلة تُظهر أن موسكو فقدت سيطرتها الكاملة على أرمينيا وأذربيجان منذ عام 1988"، مضيفاً أن غورباتشوف أبدل آنذاك قادة الحزب الشيوعي في باكو ويريفان، ليتبيّن له أن "خلفاءهم اتخذوا خطاً أكثر تشدداً في ملف قره باغ".
وبعد إعلان أذربيجان وأرمينيا استقلالهما عن الاتحاد السوفيتي، في عام 1991، تحوّل نزاعهما حرباً شاملة، أسفرت عن مقتل نحو 30 ألف شخص من الجانبين وتشريد مليون، وانتهت بهدنة عام 1994.
الأذربيجانيون الذين شكّلوا آنذاك نحو ربع سكان قره باغ، أُرغموا على مغادرة الإقليم، كما احتلّ الأرمينيون مناطق محيطة بالإقليم، تشكّل 13.6% من أراضي أذربيجان.
لكن دو فال، وهو باحث في معهد "كارنيغي"، رفض اعتبار أن النزاع في قره باغ صدام بين "أحقاد قديمة" أو نزاع ديني، لافتاً إلى "روابط في الثقافة والأعمال والزواج" تجمع الجنسيتين.
وتحدث الباحث عن 4 عوامل أحدثت شرخاً بين الجانبين، هي "سرديات وطنية متباينة، وحدود إقليمية متنازع عليها، وترتيب أمني غير مستقرّ، وانعدام الحوار بين الطرفين". وأضاف أنهما يعتقدان بأن "البقاء من دون ناجورنو قره باغ يعني هوية وطنية غير مكتملة"، معتبراً أن "جمود الدولة السوفيتية فشل في إدارة التناقضات السياسية الكامنة" في الإقليم.