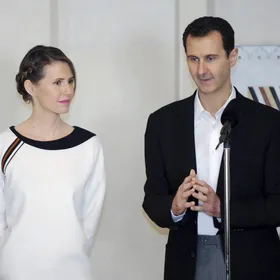يطرح الانقلاب العسكري الأخير في بوركينا فاسو، الذي قاده النقيب إبراهيم تراوري في 30 سبتمبر 2022، تساؤلات كثيرة بشأن عودة النمط الانقلابي الكلاسيكي في السياسة الإفريقية.
ويُلاحظ أن منطقة غرب إفريقيا وحدها، منذ أغسطس 2020 إلى مطلع أكتوبر 2022، سجّلت 5 انقلابات ناجحة، بما في ذلك اثنان في مالي، واثنان في بوركينا فاسو، وانقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في غينيا، إضافة إلى محاولتين انقلابيتين.
شهدت القارة الإفريقية بحلول عام 2012، أكثر من 200 انقلاب ومحاولة انقلاب منذ الاستقلال في أواخر خمسينيات ومطلع ستينيات القرن العشرين. كانت هناك محاولة انقلابية كل 55 يوماً، في الستينيات والسبعينيات، وعانت أكثر من 90% من دول القارة تجربة انقلابية واحدة على الأقلّ. وأُطلق على ذلك تسمية "متلازمة الرجل القوي"، في إشارة إلى أهمية دور الجيش في السياسة بإفريقيا.
لماذا عادت ظاهرة الانقلابات؟
بعد انتهاء الحرب الباردة، أُطلقت برامج للتحوّل نحو التعددية السياسية في إفريقيا. وكان المأمول تحرير القارة من ظاهرة الانقلابات العسكرية، لمصلحة التعددية السياسية وسيادة القانون.
وفي عام 2000 أُقرّ "إعلان لومي"، في مواجهة التغييرات غير الدستورية في الحكومات الإفريقية، و"الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة"، وكلاهما يرى في الانقلابات أبرز تهديد للسلام والأمن في القارة.
وبعد عقود، كان يُفترض أن تتراجع وتيرة الانقلابات العسكرية، إن لم تصبح شيئاً من الماضي، وأن تختفي ظاهرة "الرجل القوي" التي ميّزت نمط العلاقات بين المدنيين العسكريين في إفريقيا منذ الاستقلال.
بات من الأقوال المأثورة المرتبطة بفقه الدولة المدنية في التراث الليبرالي الغربي، أن "الجيش والسياسة لا يجتمعان، فإذا دخل الجيش من الباب خرجت السياسة من الشباك"، وهذا دليل على موت السياسة في حالة سيطرة الجيش على السلطة.
ومع ذلك يثير دور الجيش في إفريقيا تساؤلات، بينها: ما درجة الفصل الذي يجب أن تكون بين الحكومة المدنية والجيش؟ هل يجب أن يكون الجيش خاضعاً تماماً للنظام السياسي وفقاً لمبدأ حياد المؤسسة العسكرية؟ أم ينبغي السماح للجيش بمقدار من الاستقلال الذاتي من أجل حماية الأمن القومي؟
في الآونة الأخيرة، باتت واضحة أخطار الانقلابات العسكرية، كما شهدتها دول غرب إفريقيا. ومع ذلك، تتسم المجتمعات الإفريقية غالباً بوجود دولة هشّة أو فاشلة، تكون عاجزة عن أداء مهماتها والحفاظ على عملها، بطريقة منظمة وممكنة اقتصادياً من دون تدخل عسكري.
يمكن الحديث عن عوامل كثيرة تفسّر تصاعد مدّ الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا خلال العامين الماضيين.
أولاً: هشاشة الأمن وتحدّي "القاعدة" و"داعش"
لم تعُد الأسباب العرقية والإثنية هي الحافز الأساسي للانقلابات، كما في الستينيات. ففي يناير 2022، أطاح المقدّم بول هنري داميبا وبعض وحدات النخبة في جيش بوركينا فاسو، بالرئيس المُنتخب ديمقراطياً روش مارك كريستيان كابوري، المُتهم بالفشل في كبح عنف متصاعد لمسلحين متشددين.
تماماً كما حدث بعد الانقلاب السابق، أعلن إبراهيم تراوري والجنود المتمردون أن حكومة داميبا فشلت في معالجة تمرد المتشددين بالشكل المناسب.
وأفاد "مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية" بأن بوركينا فاسو لا تسيطر على نحو 40% من أراضيها، نتيجة انعدام الأمن الذي تفاقم على مدار العام.
كما أن المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر لا تزال نقطة ساخنة لجماعات إرهابية، مثل جماعة نُصرة الإسلام والمسلمين التابعة لـ"القاعدة" وولاية داعش في الصحراء الكبرى، فيما تزيد وتيرة الهجمات في شمال وسط بوركينا فاسو، وجنوب شرقها وجنوب غربها.
وأدى العنف إلى نزوح نحو مليونَي بوركينابي في الشمال، كما أثارت التكاليف الإنسانية المترتبة على ذلك تظاهرات في كل أنحاء البلاد، ندّدت بعجز الحكومة عن وقف العنف، ناهيك عن غضب من عدم كفاية الموارد للجنود وأسر العسكريين.
يأتي انقلاب النقيب تراوري في ظلّ تصاعد العنف في شمال بوركينا فاسو، إذ تعرّضت مدن، مثل جيبو، لحصار دام أشهراً من جماعات إسلامية مسلحة، ممّا تسبّب بنقص حاد في الغذاء. كذلك سقط ما لا يقلّ عن 11 جندياً في 26 سبتمبر 2022، وأُبلغ عن فقدان 50 مدنياً، بعدما هاجم مسلّحون قافلة إغاثة إنسانية.
ويأتي ذلك بعد هجوم مماثل في 5 سبتمبر، أسفر عن مصرع 35 مدنياً. وتفيد تقديرات بأن بوركينا فاسو شهدت أكثر من ثلثَي أحداث العنف المرتبطة بالتشدد الإسلامي في منطقة الساحل عام 2022.
ثانياً: قواعد التأييد الاجتماعي
في كل الحالات الانقلابية المذكورة بغرب إفريقيا، استفاد الانقلابيون من ظروف مواتية بشكل موضوعي لأفعالهم، إذ إن سياق الاضطرابات الاجتماعية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، منح المجموعات العسكرية شرعية قوية، فاستفادت من دعم كبير من سكان المناطق الحضرية.
ويتمثل ذلك عادة في خروج ثلة من المتظاهرين، معربين عن فرحتهم بإطاحة الزعماء السابقين ومرحّبين بالحكام العسكريين الجدد. وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى عودة ناشطين سابقين في غينيا، نفاهم ألفا كوندي.
وفي مالي، تمكّن العقيد عاصمي جويتا من إضفاء شرعية على انقلابه الأول، في أغسطس 2020، من خلال تعهده بمكافحة الفساد، وحلّ مشكلة الأمن، بما في ذلك مسألة الطوارق في شمال البلاد وأزمة الفولاني في وسطها، اللتين استغلتهما الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة.
هذا هو السبب في أن المجلس العسكري في مالي كان قادراً على الاعتماد على دعم المعارضة، في 5 يونيو، وزعيمها الكاريزمي جداً، الإمام محمود ديكو، أحد قادة المعارضة السياسية للرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، والمعروف عنه مواقفه الحازمة المعادية للغرب.
أما في بوركينا فاسو، فقد كانت المعضلة الأمنية وملفات الفساد، المبرّر لتنفيذ الانقلابَين هذا العام.
ثالثاً: انقسام جيش بوركينا فاسو
كشف الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو هذا العام، انقساماً داخل الجيش في التسلسل الهرمي العسكري، إذ شعر الجنود في جبهة القتال والصفوف الأمامية لمحاربة الجماعات الارهابية، بالتخلّي عنهم وتركهم من دون إمدادات كافية.
يُضاف إلى ذلك انعدام ثقة جزء كبير من الرأي العام، بعد عودة الرئيس المخلوع بليز كومباوري إلى البلاد، في يوليو 2022، إذ أراد بول هنري داميبا ترسيخ "مصالحة وطنية" لمحاربة عنف المتشددين بشكل أفضل.
ورحّب أنصار بليز كومباوري بهذه المبادرة، معتبرين أنها تسعى إلى تخفيف التوترات السياسية، لكن كثيرين رأوا فيها إنكاراً للعدالة في "أرض الرجال الشرفاء"، إذ حُكم غيابياً على كومباوري، المقيم في المنفى بساحل العاج، بالسجن المؤبد لدوره في قتل الرئيس السابق توماس سانكارا، الذي يبقى الأيقونة والشخصية الملهمة التي لا يمكن تجاوزها في البلاد.
عدم احترام القانون قد يكون الخطأ الاستراتيجي الأكبر الذي ارتكبه داميبا، وساهم في تمرّد ضباط ذوي رتب متدنية بقيادة إبراهيم تراوري، لا سيّما أن شخصيات من النظام القديم، الذي أطيح به في انتفاضة 2014، عُيّنوا في مناصب أساسية بعد انقلاب يناير.
رابعاً: ضعف الجيوش في غرب إفريقيا
لا تمتلك بوركينا فاسو ومالي وغينيا أدوات عسكرية يمكن الاعتماد عليها كلياً في الحرب على "الإرهاب"، وهي دول هشّة اقتصادياً. تشكّل إساءة استخدام الموازنات المخصّصة للدفاع، المرتبطة بالفساد النظامي، وضعف تخطيط الموازنة، إضافة إلى ممارسات تثير شكوكاً في المشتريات العامة، عوامل جوهرية تكبح أي تعزيز مستدام للإدارة والقدرات والسلطة التشغيلية.
ولذلك، تعاني أغلبية الوحدات العسكرية بشكل عام من ضعف في التدريب، وانخفاض المرتبات، والبعد عن روحية العمل الجماعي. وبذلك، يعتمد استقرار النظام في دول إفريقية كثيرة فقط على ولاء القوات الخاصة والحرس الجمهوري لرئيس الدولة.
لدى هذه الوحدات كوادر مدرّبة في كليات عسكرية غربية. ورغم صغر حجمها، إلا أنها تمسك، بحكم الواقع، بأغلبية إمكانات القوة الإكراهية في تلك البلدان. وعندما تواجه الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل مباشر، كما في مالي أو بوركينا فاسو، فإنها تتمتع أيضاً بمكانة معيّنة.
لذلك، من وجهة نظر بحت عملياتية، يصبح الاستيلاء على السلطة إجراءً شكلياً تقريباً. ولعلّ ذلك هو ما تُجسّده الصورة الكلاسيكية لمجموعة من جنود النخبة في شاحنات صغيرة تعبر العاصمة لبلوغ قصر الرئاسة، بالتزامن مع السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون والإعلان عن "البيان رقم واحد" للانقلابيين.
خامساً: تصاعد الاستياء من فرنسا
واضح أن ثمة مداً شعبوياً في دول الساحل وغرب إفريقيا، ضد الوجود الفرنسي الذي بات مرتبطاً في المخيّلة العامة بإرث الاستعمار والسعي إلى اكتساب الثروة والنفوذ. واستغلّت النخب العسكرية، كما في مالي، هذا الشعور المناهض لفرنسا من أجل كسب شرعية ثورية وتبنّي أيديولوجيا وطنية تُلهب حماسة الشعوب.
لم يكن الاستياء من الفرنسيين أمراً جديداً في بوركينا فاسو. ففي نوفمبر 2021، أوقف متظاهرون قافلة عسكرية فرنسية مرات أثناء عبورها البلاد، نتيجة اقتناعهم بأنها تحمل أسلحة مخصّصة للجماعات المتشددة التي تُرهب مجتمعات الساحل منذ سنوات. وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم تصرّفات الجنود الفرنسيين في بوركينا فاسو، وهي ظاهرة سبقت ملاحظتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.
سادساً: روسيا والحرب الهجينة
استغلّت وسائل الإعلام الرسمية الروسية، مثل "سبوتنيك" و"روسيا اليوم"، تنامي غضب شعبي ضد الوجود الفرنسي والغربي في إفريقيا، لتعزيز النفوذ الروسي في المنطقة، في ما يكشف بوضوح أهمية الحرب الهجينة في هذه المواجهة الجديدة بين موسكو والغرب.
من المفارقات أن فرنسا، من خلال فشلها في تحييد الجماعات المتشددة في المنطقة، ورغم حجم "عملية برخان"، تُعتبر مسؤولة، بل وحتى متواطئة، بحسب شعوب غرب إفريقيا ومنطقة الساحل.
وتنشر مواقع التواصل الاجتماعي بلا كلل، شائعات تروّج لهذا التواطؤ المفترض، والذي تتبنّاه صراحة بعض النخب السياسية الحاكمة، كما في مالي التي أعلنت طلاقاً بائناً مع فرنسا.
خلال الانقلاب الأول في بوركينا فاسو في يناير، أشاد رجل الأعمال الروسي يفجيني بريجوجين، المقرّب من الكرملين والذي اعترف بتأسيسه مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية، بالانقلاب باعتباره مؤشراً إلى حقبة جديدة من إنهاء الاستعمار.
هل بات الباب مفتوحاً أمام "فاجنر" في دولة إفريقية أخرى؟ يبدو من البيان الذي وقّعه النقيب تراوري أن لدى الانقلابيين الجدد "رغبة راسخة في الذهاب إلى شركاء آخرين مستعدين للمساعدة في مكافحة الإرهاب".
ورغم أن روسيا لم تُذكر صراحة، فقد طالب متظاهرون في واجادوجو بتبنّي نهج مالي في هذا الصدد، علماً أنهم حاولوا إحراق محيط السفارة الفرنسية ورفعوا أعلاماً روسية.
ولجأ جيش مالي إلى مدربين من "فاجنر"، استولوا أحياناً بشكل مباشر على قواعد تركها الجنود الفرنسيون أثناء إنهائهم "عملية برخان". وبات وجود أفراد هذه المجموعة المقرّبة من الكرملين، ذراعاً مسلّحة لنفوذ روسي متزايد في كل أنحاء دول إفريقيا الناطقة بالفرنسية.
آفاق المستقبل
ليس مرجّحاً أن يؤدي التغيير في الطبقة الحاكمة، من خلال تدخل عسكري، إلى تحسين الاستجابة الأمنية لحكومة بوركينا فاسو، نتيجة تحديات هيكلية مديدة، كما أن العلاقات المتوترة مع فرنسا قد تؤدي إلى ظهور نقاط ضعف وثغرات أمنية جديدة.
ويُرجّح أن تتواصل القيود المفروضة على التدريب والمعدات والموارد والجنود، كما ستستمر روحية الانقسام داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية في بوركينا فاسو.
ويعني ذلك أنه رغم الخطاب البليغ المفعم بالروح الشعبوية للنقيب تراوري، مؤكداً قدرة حكومته على وقف عنف المتشددين بوسائل لم تكن تمتلكها حكومة داميبا، سيواجه مجلسه العسكري الجديد التحديات ذاتها التي واجهها سلفه، ما يجعل القضاء على فصائل "داعش" و"القاعدة" مستبعداً جداً.
إضافة إلى ذلك، يبدو أن تصريحات المجلس العسكري بقيادة تراوري، تشير إلى عدم الموافقة على الشراكة الأمنية لبوركينا فاسو مع فرنسا، بعكس الحكومة السابقة. وعرقلت مشكلات التنسيق بين القوات الفرنسية والجيوش الوطنية، عمليات مكافحة الإرهاب لسنوات، وقد يؤدي تدهور العلاقات الثنائية إلى تفاقم هذه المشكلات، ما يجعل جهود كل جانب أقلّ فاعلية.
ويعني ذلك أن المتشددين قد يحظون ببيئة مواتية لتنفيذ عملياتهم الإرهابية في بوركينا فاسو وبلدان مجاورة، في حين أن الوضع الأمني في بوركينا فاسو يمكن أن يمسّ المدنيين بشكل متزايد، وبالتالي يقوّض الدعم المحلي، ويجعل هذه المجتمعات أكثر عرضة للتجنيد في صفوف المتطرفين.
أما إذا تبنّى المجلس العسكري الجديد في بوركينا فاسو نهج مالي، وأنهى كل الاتفاقات الأمنية المُبرمة مع فرنسا، فسيُصبح مرجّحاً أن توسّع الجماعات المسلحة نطاق عملياتها ونفوذها الإقليمي، إذ تُعدّ فرنسا الأقوى من حيث الوجود العسكري في البلاد والمنطقة. ويُحتمل أن يؤدي ذلك لاحقاً إلى رفع مستويات التهديد الإرهابي في الساحل الغربي لإفريقيا، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في الهجمات العام الماضي، في شمال غانا وتوغو وبنين.
حلقة مفرغة
يجدر وضع حدّ فوري للميل إلى إضفاء شرعية بسهولة على ظاهرة الانقلابات في المنطقة، من خلال استخدام الذريعة التبسيطية المتمثلة في "فشل السياسة"، لدرجة أن أيّ ضابط طموح بات يعتقد بأنه مخوّل بالإطاحة بالسلطة القائمة، ولو من قبيل الاحتيال السياسي.
وفي ظلّ عدم وجود رادع إقليمي ودولي ضد قادة الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، حيث باتت عبارات الإدانة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى، مجرد تصريحات بلاغية مكررة، فقد أصبح الجيش في دول غرب إفريقيا أكثر سرعة وقوة في طرد الرؤساء من قصورهم، بشكل يفوق قدرته على التصدي للجماعات الإرهابية التي تروّع الآمنين، وترهب حتى الجنود.
والأسوأ في ذلك، أن قادة الانقلاب لا يمتلكون حلولاً إبداعية لمواجهة التحديات. يمكن الحديث عن حلقة مفرغة من الانقلابات والانقلابات المضادة، التي ستُفضي في النهاية إلى إضعاف المؤسّسة العسكرية نتيجة تسييسها، وهذا ما تستغلّه جماعات العنف المنظمة في بسط سيطرتها على مناطق تفتقر إلى وجود السلطات في الدول الإفريقية.
وفي الوقت ذاته، لا يمكن البحث عن حلول للمشكلات الإفريقية، في باريس أو واشنطن أو موسكو. نشهد الآن بوادر حرب باردة جديدة، في ظلّ تنافس دولي، قد يصبح الأفارقة الخاسر الأكبر فيها.