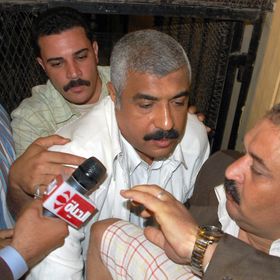هذا المقال جزء من سلسلة "2023.. عام الأسئلة الصعبة".
بقلم البروفيسور مارك لافيرن

- بروفيسور فخري في جامعة تورز بفرنسا وباحث رئيسي بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي.
- التحق بوزارة الخارجية الفرنسية كرئيس للتعاون العلمي والتقني الفرنسي السوداني ومقره جامعة الخرطوم عام 1982، وعمل لاحقاً كرئيس لمركز الدراسات والأبحاث الفرنسية حول الشرق الأوسط المعاصر في بيروت وعمان عام 1988.
- في عام 1991، انضم إلى المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، وشغل عدة مناصب في المؤسسات الأكاديمية الفرنسية التي تتعامل مع الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك القرن الإفريقي. وفي 2008، تم تكليفه مرة أخرى من قبل وزارة الخارجية الفرنسية برئاسة المركز الفرنسي المصري للبحث العلمي والتعاون ومقره القاهرة.
- كما تم تعيينه في العديد من البعثات الدولية لبناء السلام كمستشار قانوني وسياسي أو خبير إنساني ومنسق لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وترأس فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دارفور بالسودان، وعمل كذلك ضمن المراقبين الميدانين للاضطرابات والصراعات المسلحة في أفغانستان وجنوب السودان وكردستان العراق.
خلف الحرب الدائرة في أوكرانيا يُرسم هدف آخر: وقف تمدد أوروبا شرقاً، بالطريقة التي تتمكن من خلالها روسيا من استعادة المكانة المتنازع عليها في العالم.
الطريقة التي ردّت بها أوروبا كانت بمثابة اختبار توطدت إثره الروابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتمخض عنه دعم جماعي لأوكرانيا من قبل القادة والرأي العام.
ومن الثابت أن العديد من المصالح المتباينة والاستراتيجية، كان يجب الفصل فيها: فألمانيا قدمت التنازلات فيما يتعلق بالغاز الروسي، وأورسولا فان دير لاين، الرئيسة الألمانية للمفوضية الأوروبية، اضطرت إلى زيادة مصادر التوريد البديلة، ووضع سقف لأسعار الغاز الروسي.
ربَّ ضارة نافعة
يمكن للتحدي الذي فرضه فلاديمير بوتين على أوروبا أن يأتي بأثر عكسي، وذلك بتقوية أوروبا في مواجهة تحدٍ وجودي: فكل الدول الأعضاء، القريبة أو البعيدة، تشعر بالتهديد الذي فرضه العدوان الروسي على أوكرانيا.
فالدول القريبة التي فرّت قبل ثلاثين عاماً من قبضة الاتحاد السوفيتي، هي بالتأكيد الأكثر قلقاً، ولكن الأعمال التخريبية الروسية تمتد إلى أبعد من ذلك، من خلال دعم الحركات الشعبوية التي تستقطب شرائح واسعة من المجتمعات التي أصبحت ضحايا تراجع أوروبا الاقتصادي على مستوى العالم.
لقد ولّى عصر القادة الذين شهدوا الحرب العالمية الثانية، وأنجيلا ميركل التي كانت تعرف الجانب الآخر من الستار الحديدي، هي الأخرى تقاعدت. لكن تعبئة الدول الواقعة على خط المواجهة يظهر أن الفترات الفظيعة التي شهدها القرن الـ20 لم تندثر تداعياتها بعد، إذ أصبحت أوروبا تعي جيداً الخطر القاتل الذي يحدق بها في مواجهة التهديد الذي أحدثه فلاديمير بوتين.
وإن الأحزاب الشعبوية التي تلقت دعماً سرياً من روسيا، وتتقاسم معها مبادئ السياسة القومية وكره الأجانب، أظهرت الكثير من التريث.
إلا أن هذا الانقسام بشأن الموقف من روسيا لم يكن الأول الذي يزعزع البناء الأوروبي. فمنذ توقيع معاهدة روما عام 1957، لم يكن الطريق مفروشاً بالورود، فبعد عودة دول البحر الأبيض المتوسط إلى الديمقراطية في سبعينيات القرن الماضي، جاء الانفتاح على الشرق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، بالإضافة إلى الحروب المهولة التي مزّقت أوصال يوغوسلافيا.
كما أن ألمانيا، التي اضطرت لتحمل ثقل إعادة توحيدها، كانت قلقة بشأن تكلفة عودة هذه البلدان إلى اقتصاد السوق، بدورها كانت فرنسا متوجسة من تحوّل أوروبا إلى منطقة نفوذ جرمانية. وعليه، حاول الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي، من دون جدوى، إنشاء اتحاد من أجل المتوسط لموازنة ميل مركز الثقل الأوروبي نحو الشمال.
الوحدة الأوروبية.. نصف قرن من التقدم
على الرغم من كل التحديات، تحوّلت السوق المشتركة إلى اتحاد أوروبي، تمكّن من بناء تضامن مالي، ونظام قانوني، ونموذج اجتماعي مشترك.
وأظهر الاتحاد الأوروبي التزاماً قوياً في مواجهة البريكست ومساعي بريطانيا لإيجاد هيكل جديد بديل للتكتل الأوروبي.
وتأكدت الهوية الأوروبية عبر مؤسسات أصبحت مركزية في الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين، وفي عالم الأعمال، ومن خلال رؤية وعمل منسق على مستوى العالم.
واكتسبت أوروبا أيضاً بعداً استراتيجياً، فالناتو الذي وُلد من مخاوف أميركية من انزلاق أوروبا نحو المعسكر الشيوعي، أصبح السبب الذي تذرعت به روسيا لغزو أوكرانيا.
مما لا شك فيه أن الهوية الأوروبية قد رُسمت، خلال "الحرب الباردة"، ضد النموذج الشيوعي المنافس.
ولم يخفف سقوط الشيوعية من الموقف الأوروبي، فالنموذج الديمقراطي يتناقض مع النظام الذي أعقب الشيوعية في روسيا، والذي فشل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على النقيض من ذلك، تمكنت أوروبا من اكتساب سلطات جديدة، واقتربت من مواطنيها من خلال البرلمان والمفوضية الأوروبية التي تعد الحكومة الفعلية للاتحاد. وفوق ذلك، فإن البرلمان لا يتجمع فيه النواب حسب البلد، ولكن من خلال الانتماءات السياسية، وهو ما يشكل عنصراً إضافياً للوحدة.
وتعززت الشراكة الأوروبية من خلال هذه الشرعية الديمقراطية التي تحوّلت إلى اتحاد فوق وطني يتجاوز القوميات، ما يعني أنه أصبح مجموعة من القواعد يلتزم بها الجميع.
من يمسك بزمام الأمور؟
شكلت كل مرحلة من مراحل البناء الأوروبي تحدياً لصلابة التضامن في المحور الفرنسي الألماني المركزي. ولم يكن لهذا المحور فرصة البقاء والمقاومة لولا تضامن القادة بين طرفي نهر الراين. غير أن هذه القيادة لا يمكن ممارستها إلا إذا كان البلدان في مرحلة اقتران للأدوار بين القوة الاقتصادية الألمانية والثقل السياسي والاستراتيجي لفرنسا.
بينما تستمر المفاوضات على جانبي نهر الراين بثبات، يبدو أن القيادة الفرنسية-الألمانية مستقلة اليوم عن الشخصيات التي تمثلها، فعصر الصداقة الوثيقة بين فرانسوا ميتران وهيلموت كول وقبلهما الجنرال ديجول وكونراد أديناور، وهي شخصيات تملك شرعية لا جدال فيها داخل بلادها، أصبح كله من الماضي.
لهذا كله، فإن ثنائية فرنسا-ألمانيا تمثل مركز استقرار في كيان واسع ومعقد بشكل متزايد، بمؤسساته ونظامه القانوني، والآن بعملة قوية هي اليورو، الذي فرض نفسه مرجعاً على نطاق دولي واسع، مدعوماً بمصرف مركزي يتمتع بأدوات تنظيمية قوية.
غير أن القيادة الأوروبية ليست وصاية يفرضها الجانب الفرانكو-ألماني على مجموعة من البلدان الصغيرة، كما أن التوجهات السياسية المختلفة تجعل الممارسة الوحدوية أمراً شاقاً على نحو متزايد.
علاوة على ذلك، فإن الجيل الجديد للقادة ينحدر من طبقة تكنوقراطية منفصلة عن التأثيرات التاريخية والثقافية، ما يعني أن أوروبا دخلت مرحلة إدارية حيث تكون الأولوية لترسيخ الوحدة أكثر من إطلاق المشاريع الكبرى، كما أن أوروبا أكثر التزاماً بالدفاع عن مواقفها في المنافسة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية، أكثر من إطلاق مشاريع للتوسع.
وهي ملتزمة أيضاً بالتعبئة العالمية بشأن تحديات الاحتباس الحراري وحماية البيئة وغيرها، والتي تتجاوز انقسامات الماضي الأيديولوجية.
في هذا النظام الديمقراطي التعددي، تضاعف عدد اللاعبين وتنوّع، مع تنامي دور "المفوضين الأوروبيين" الوزراء الحقيقيين لأوروبا، وثبات الدور المؤكد للبرلمان الأوروبي.
وتعبّر الأحزاب السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية في 27 دولة عن قضايا الحياة اليومية لأوروبا، ما يجعلها أكثر وضوحاً، وهي مألوفة بشكل أكبر للمواطنين، فضلاً عن وجود عدالة أوروبية تسمو على القوانين الوطنية.
تحديات العولمة الجديدة
داخل الاتحاد الأوروبي، ظهرت توترات جديدة تعكس مخاوف مجتمعات لم تتطور بالوتيرة ذاتها، أو وقعت ضحية للعولمة.
ويتم التعبير عن هذه الإحباطات في الانتخابات التي يسيطر عليها القوميون، كما هو الحال في بولندا والمجر ،فالحكومات التي صعدت هناك، عرفت كيف تستقطب غضب وآلام فئات مهملة في مواضيع مرتبطة بالمجتمعات المحافظة.
الأزمات لم تترك حتى بلدان الدرجة الأولى، على غرار فرنسا وإيطاليا وحتى السويد التي كانت نموذجاً للرفاهية. وحتى إن الثنائية الفرنسية ـ الألمانية باتت مهددة بالتراجع أمام المخاطر التي تحدق بالحماية الاجتماعية المكتسبة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
هذه التطورات في أوروبا تعكس تدهوراً هيكلياً، ديموغرافياً واقتصادياً، في مواجهة عالم ناشئ، متعدد الأقطاب ومعقد. وبينما تتداعى ذكريات تأسيس الاتحاد الذي حفزته الحرب العالمية الثانية والتهديد السوفيتي، فإن إنقاذ المشروع الأوروبي يتمثل في تعزيز الوحدة، وليس انطواء الدول الأعضاء على نفسها.
إعادة التفكير في المشروع الأوروبي
من المسلّم به أن المؤسسات والقوانين الأوروبية تتدخل بشكل متزايد في الحياة اليومية لمواطني الدول الأعضاء. وينظر إلى ذلك غالباً على أنه تدخل مفروض من الخارج. لذلك، فإن السياسيين مطالبون بأن يكونوا قادرين على لعب دور مزدوج، كحماة لمواطنيهم ومروّجين للوحدة والتضامن.
زعيما فرنسا وألمانيا الحاليان في وضع مختلف: فماكرون يلبس عباءة الملك الموجود في كل مكان، وذلك يتوافق مع تقاليد فرنسا في مركزية السلطة، وهو يعتمد في ذلك فقط على دعم حزبه الذي أنشأه من الصفر.
أما أولاف شولتز فإنه في موقف معاكس تماماً، فهو الأول فقط من بين نظرائه، على رأس تحالف ديمقراطي اجتماعي وليبرالي وبيئي، جاءت به انتخابات برلمانية في سبتمبر 2021.
وفي إطار دولة اتحادية شديدة اللامركزية، يجد شولتز نفسه مطالباً بأن يأخذ في اعتباره 16 رئيساً للأقاليم برتبة وزير، وثقافتين مختلفتين وُرثتا عن تاريخ طويل، ما يعطي طابعاً وأداء مختلفاً، وفي كثير من الأحيان يتسبب في سوء فهم متبادل.
الدفاع عن نموذج الحضارة الغربية
علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة الأميركية أعيد تنشيطها مجدداً على ضوء هذا التحدي. فانعزالية دونالد ترمب فشلت، إذ إن التحدي الروسي موجّه أيضاً لأمريكا، بدعم خاص من الصين برئاسة شي جين بينج، والتي تستخلص الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا، لمشروعها الخاص بغزو تايوان.
وفيما تؤكد أوروبا قدرتها السياسية والعملية، وتضع نفسها في الخط الأمامي لمعسكر الديمقراطيات؛ فإن أميركا بقيادة جو بايدن تُظهر دعماً قوياً للمقاومة الأوكرانية، وذلك أن مصير العالم ربما يكون قد تقرر من وجهة النظر هذه في 6 يناير 2021، لأن استمرار دونالد ترمب في السلطة ربما كان سيعني سحب الدعم الأمريكي للمقاومة الأوكرانية.
وبذلك تدافع أوكرانيا اليوم عن نموذج الحضارة "الغربية"، عن التعددية والديمقراطية، ضد التهديد الروسي وخلفه تهديد الصين والقوى الأخرى، من تركيا إلى إيران، والذين يرفعون هذا التحدي أيضاً ضد الغرب.
وهنا يجد المشروع الأوروبي مبرراً لوجوده، فمنذ أن تشكلت نواته الأولى بعد الحرب العالمية، مدفوعاً بتهديد الكتلة السوفيتية، استمر المشروع بالتماسك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، من خلال تقديم نموذج مجتمع تعددي وسلمي للدول السابقة في "المعسكر الشرقي".
نحو أي مستقبل؟
إذا تمكنت أوروبا من تجاوز التحدي الذي تمثله روسيا فلاديمير بوتين، فسوف تكتسب ثقلاً سياسياً أكبر على النطاق العالمي.
من المؤكد أن تراجع أوروبا في الإنتاج والكفاءة التكنولوجية لا يمكن إنكاره، لكن القارة العجوز تظل أرضاً خصبة للخبرات في إدارة الشؤون العالمية، في وقت تتراكم فيه التحديات الجديدة المتمثلة في الاكتظاظ السكاني والتلوث وتغير المناخ، فجميع الملفات المتعثرة لا يتم العثور على حلول لها من خلال القوة الاقتصادية أو العسكرية، بل من خلال تجميع الأفكار والخبرات.
ستكون أوروبا المسالمة والموحدة مصدراً لمبادرات جديدة في مواجهة إغراءات التيارات القومية، ومصدراً للسعي إلى قوة تستند حصرياً إلى السلاح.
إن النموذج الأوروبي هو نموذج اتحاد يحترم الاختلافات والتضامن على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبالتالي، يمكنه أن يكون مرجعاً، وربما نموذجاً، لتلبية التوقعات المتعددة لحفظ السلام في العالم.
لكن هذا لا يمكن أن يحدث من دون إصلاح وتقوية مؤسساتها ووسائل عملها، ومن دون حوار ثابت مع جميع اللاعبين العالميين.
ويستدعي ذلك تطويراً مؤسسياً نحو تكامل وتشاور أوسع بما في ذلك زيادة نفوذ الاتحاد على حساب الدول، واندماج الاختصاصات الموسعة، فضلاً عن تنظيم الأنشطة الاقتصادية والمالية والمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز السياسة الخارجية المشتركة، من خلال التحدث بصوت واحد في المحافل الدولية. وأيضاً، بالتشاور مع الناتو، من أجل كفاءة استراتيجية وعسكرية تتناسب مع المسؤوليات التي يضطلع بها.
وفي المحصلة، فإن التحدي الجديد لأوروبا الغد يكمن في أن تصبح عامل سلام وازدهار على المستوى العالمي.
لقراءة المزيد من المقالات ضمن هذه السلسلة: