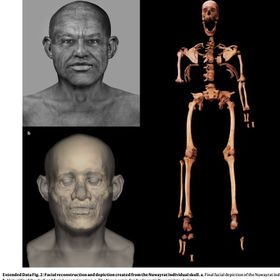هذا المقال جزء من سلسلة "2023.. عام الأسئلة الصعبة".
بقلم عبد الرحمن الراشد

- إعلاميّ ومثقّف سعودي. رئيس مجلس تحرير قناة "العربية"، ومديرها العام السابق، ورئيس التحرير السابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، حيث لا يزال يكتب عمودًا سياسيًا بشكل منتظم. وقبل ذلك كان رئيس التحرير في مجلة "المجلة" الأسبوعية الصادرة من لندن.
- خلال مسيرته المهنية، أجرى مقابلات مع العديد من قادة العالم، وأثارت كتاباته ردود فعل واسعة. وفي عام 2006، حصل على لقب الإعلامي العربي الأكثر تأثيراً ونفوذاً في المنطقة العربية والعالم بحسب تصنيف مجلة أرابيان بيزنيس. وفي 2016، فاز بجائزة "شخصية العام الإعلامية" التي يمنحها "منتدى الإعلام العربي".
على مدى العقود الأربعة من عمر الحكم الحالي في إيران لم يداخل أحد الشك في قدرة النظام على البقاء. اليوم، أصبحت كل الاحتمالات مفتوحة هناك. التطورات السريعة على الأرض تدفع للبحث الجاد، لاستقراء تأثيراتها على محيط إيران العربي، بما فيه الخليجي. وكذلك معرفة تبعاتها على القضايا الرئيسية، السلاح النووي، والعلاقة مع الغرب والصين وروسيا، ومصير نفوذها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
تسوّق طهران رواية تقول إن التمرد الواسع ضدها في الداخل مدفوع من الخارج، الغرب وإسرائيل والسعودية.
هذه الأزمة ضد النظام، صناعة إيرانية داخلية، ليست مفاجئة، والرفض العلني أصبح حالة مزمنة لا يتطلب دعماً ولا تحريضاً من الخارج. مع هذا، من المتوقع أن العواصم المتضررة من السياسة الإيرانية، وذلك يشمل معظم دول المنطقة، تراقب باهتمام، ويسرها أن ترى نظام الملالي يعيد حساباته، ويتراجع عن سياساته العدائية. وهذا يشمل قضايا شغلت المنطقة والعالم لسنين، النووي العسكري، وتدخلاته الإقليمية، وجيشه الخارجي المؤلف من ميليشيات متعددة الجنسيات. أما سياسات النظام الداخلية فتأتي في مرتبة متأخرة بالنسبة لهذه الدول.
وبداية لا بد من القول إن العلاقة السيئة مع دولة إيران ليست قدراً على المنطقة. فقد كانت إيجابية لزمن طويل، إلى قيام الجمهورية الإسلامية في طهران، في أواخر السبعينات. تميزت علاقة دول الخليج العربية مع إيران، في زمن الشاه، بالهدوء وعاشت في سلام وتعاون. وكان بينهما حلف إقليمي مشترك، وازدهرت التجارة البينية، حتى مع وجود خلافات حول قضايا الاستقلالات والحدود والنفط. سرعان ما ساءت العلاقة فور وصول الخميني إلى طهران الذي جاهر صراحة بالعداء للسعودية ومصر، واستمرت متوترة معظم العقود الأربعة إلا في فترة وجيزة خلال رئاسة هاشمي رافسنجاني.
إيران تتغير
وقبل الخوض في تحليل العلاقات بعدما طرأ على الضفة الإيرانية، أعرّج على التطورات التي قادت إلى الواقع الجديد هناك، وما يوحي به من تغييرات كبيرة. وكيف انتقلت الأصوات المحتجة من رفض سياسات، إلى رفض قيادات، وتطورت لتعلن رفضها للنظام الديني المتطرف برمته، رافعة شعارات بديلة.
من شبه المؤكد أن إيران تتغير، ولا يمكنها أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الانتفاضة الحالية، يوجد تغيير حقيقي، لكننا لا نعرف عمقه بعد.
وللتغيير النهائي المحتمل نماذج "كاتلوجات" متعددة. هناك الحالة الليبية، أي انهيار النظام الكامل والفوضى. الحالة السورية، الفوضى شبه الكاملة دون انهيار النظام الكامل. الحالة المصرية، سقوط قمة الجبل وبقاء القاعدة صلبة، وهي المؤسسة العسكرية. الحالة السوفييتية، انهيار الدولة وبقاء النظام. والحالة الصينية، انهيار الأيديولوجيا وبقاء الدولة والنظام.
أصبح جلياً للداخل والخارج، أن السلطة خسرت نسبة كبيرة من شعبيتها و"شرعيتها" وأتباعها. والخسائر جاءت تدريجية، ليست طارئة ولا وليدة غضب من مقتل مهسا أميني، في سبتمبر الماضي، بل سلسلة أزمات تراكمت وانتهت بالقمع، وبدون مصالحات مع الفئات المعترضة. كانت احتجاجات مطلع الألفية طلابية، في جامعات طهران. وفي عام 2009، دينية، عندما ثار رجلا دين، موسوي وكروبي، ضد الانتخابات ورأس السلطة، قمعها النظام ووصمها بـ "ثورة المنافقين".
احتجاجات عامي 2017 و2018 بدأت من مدينة مشهد ضد الغلاء والفساد. وتلتها بعد عامين مظاهرات متقطعة جراء استفحال جائحة كوفيد، وشح المياه، ونقص الخدمات، والفقر، شملت مناطق ريفية محسوبة على النظام. "انتفاضة سبتمبر" الحالية ثارت إثر قتل سيدة كردية لأنها لم تلبس الحجاب بما يكفي ليغطي كل شعرها، ليعم الغضب أنحاء البلاد، بما فيها طهران وقم.
ونلاحظ هنا أن السلطات اختارت دائماً الرفض والمواجهة، إذ لا تزال الجامعات المصدر للقلاقل والطرح المعادي، ولا يزال مهدي كروبي، (85 عاماً)، ومير حسين موسوي، (80 عاماً)، في الإقامة الجبرية منذ 11 عاماً. الاقتصاد ساء، والبطالة ارتفعت، والأقاليم المتذمرة التي حاولت التمرد ازداد عددها. وبالتالي لا أشياء تم إصلاحها أو التسامح أو التصالح معها، بل تتراكم. لهذا نعتقد أن النظام، فشل في إدارة أزماته، حتى أصبحت مزمنة وتكبر مع مرور الوقت.
التحدي الحقيقي لولاية الفقيه
الاحتجاجات تكبر عدداً وتتكرر وتتسع جغرافياً، شملت فئات مهنية مختلفة، طلاباً وموظفين ورجال دين وعمال نفط وسائقي شاحنات، واشترك فيها سكان المدن والأرياف، ووصلت مسقط رأس مؤسس النظام الخميني، وكذلك قم الدينية. عرقياً وإقليمياً، قادها فرس والتحق بها أذريون وأكراد وعرب وبلوش، وردد صداها الإيرانيون في المهاجر في أنحاء العالم.
لم تعد الشكوى من الأوضاع الاقتصادية المتردية، وضد تسلط رجال الدين، إنما تحولت إلى رفض السلطة الدينية، الذي هو رفض للنظام.
التحدي الحقيقي الذي يواجه نظام ولاية الفقيه، اليوم، هو تراجع قداسة رجال الدين، وتزايد الكراهية للجمهورية الدينية، والأخطر على النظام تنامي هوية بديلة مع صعود الشعور القومي الإيراني. في أربعين عاماً، استخدم النظام الدين لشرعيته، وهو الرابط الذي حكم به إيران، على اعتبار أنها بلد متعدد القوميات. إنما مع تهم الفساد، والمحسوبيات، والفشل الإداري، وتكرر أزماته تبدو صلاحية مشروع ولاية الفقيه منتهية.
الخطر الأكبر عليه هو صعود التيار القومي الإيراني، الذي يهدده ليكون البديل. وقد يجد النظام نفسه مضطراً إلى استيعابه في صيغة هجينة إن كان ينشد البقاء. وقد حاول في السنوات الماضية، مع بدايات الاضطرابات قبل عقدين، الجمع بين الإسلام والتاريخ الفارسي، من خلال المسرح والفنون والخطابة، لكنه ظهر مزيفاً بسبب التناقض الصارخ. علاوة على أن الملالي ليسوا واثقين من أنهم يستطيعون السيطرة على المد القومي الكاره للمؤسسة الدينية.
أحدث مظاهر التمرد وتحدي المؤسسة، نزع النساء الحجاب الديني، وطمس شعار النظام في العلم الإيراني. سقطت هيبة المؤسسة الحاكمة، إذ استمر المحتجون يرفعون أصواتهم عالياً، ويخطون على الجدران، "الموت للديكتاتور". وصل التمرد لاعبي المنتخب الرسمي، وتجرأوا على رفض النشيد الوطني أمام ملايين المشاهدين. منتخب الدولة يرفض الدولة، أو يتحاشى تحدي غالبية مواطنيه التي ترفض النشيد الرسمي وما يدعو إليه، الذي يقول، "شمس الشرق تلك التي تستنير بها أبصار المؤمنين بالحق، بهمن هو رمز إيماننا، ونداؤك أيها الإمام منقوش في أرواحنا، فلتبقَي خالدةً وأبية أيتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية". كان مونديال كرة القدم مسرحاً محرجاً للقيادة الإيرانية أمام العالم.
تداعيات محتملة
ماذا عن التداعيات المحتملة لأحداث إيران على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتهما دول الخليج العربية، المعنية جداً بما يحدث هناك؟
سبقت احتجاجات سبتمبر، جولات من الحوار السعودي الإيراني، عُقد معظمها في العاصمة العراقية ولم تحرز الكثير. ومع تضييق المتظاهرين الخناق على النظام صدرت عدة تصريحات من سياسيين في طهران تعلن عن الرغبة في التعاون مع الرياض، تزامنت مع تصريحات أخرى تناقضها، من مسؤولين عسكريين إيرانيين، تهدد السعودية وتتهمها بالتورط في الأحداث الداخلية. ومعظم التهم، تدعي أنها خلف حملة إعلامية موجهة للداخل ضد النظام، في الوقت الذي يملك النظام الإيراني ذراعاً إعلامية طويلة موجهة ضد السعودية وحكومات المنطقة، ضمن صراع طويل بين الجانبين. وعلى جبهة الحرب في اليمن، استمرت الهدنة وإن لم تكن مثالية، وهي نتاج تفاهمات سبقت تظاهرات إيران بخمسة أشهر.
ولا يوجد، بعد، ما يشير إلى أن السلطات الإيرانية تعتزم الانسحاب من مناطق الأزمات التي خلقتها، مثل اليمن. وعدم حماس الجانب الخليجي، السعودي تحديداً، يعود إلى التشكيك في جدية القيادة الإيرانية، التي يهمها فقط تأمين ظهرها وهي منشغلة تحاول السيطرة على أزمتها الداخلية دون أن تساهم في وقف حمامات الدم التي تسببت فيها في المنطقة. في اليمن، الحد الأدنى من التوقعات، أن تنهي تدخلها، وتسمح للحل السلمي للعمل على نهاية الحرب. الحل، وهو الذي سبق أن طرحته السعودية، كان متوازناً وواقعياً، إذ إنه يسمح للحوثيين بأن يشاركوا في النظام السياسي والحكم مع بقية مكونات البلاد.
الميليشيا الحوثية، التي تشبه حزب الله اللبناني في تبعيتها لإيران، مستمرة، حتى هذا اليوم، في فرض التغييرات على الأرض للسيطرة على البلاد. كما أن تهريب الأسلحة بحراً من إيران للموانئ الحوثية لم يتوقف.
وفي الوقت الذي تجلس الحكومة الإيرانية في الزاوية الضيقة، التي وضعتها فيها الاحتجاجات الواسعة، تريد التهدئة الخارجية المؤقتة. ولهذا سعت لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأميركي في الأردن، وسعت كذلك لاستئناف الحوار مع الرياض. إلا أن الضغوط عليها زادت نتيجة تورطها في الحرب الأوكرانية، بعدما اتضح أنها زودت روسيا بطائرات درونز، التي استخدمتها بشكل مكثف ضد التحالف الغربي، ما دفع الحكومات الأوروبية لفرض المزيد من العقوبات على طهران واعتبارها شريكاً في الحرب.
وحيال العراق، لا نلمس تحسناً في سياسة إيران تجاه جارتها. فهي تحاول تعزيز تأثيرها على بغداد منذ خروج حكومة مصطفى الكاظمي. ولم تستمع لمطالبات العراقيين بوقف قصفها لإقليم كردستان، الذي كان الأعنف منذ سنوات. السلطات الإيرانية تتهم الحكومة العراقية بأنها لا تقوم بواجباتها في حراسة حدودها، وحولت إقليم كردستان إلى جبهة حرب إيرانية مفتوحة.
دولياً، فإن من دواعي حرص القوى الكبرى، مثل الصين وروسيا، على العلاقة مع النظام اعتقادهم بصلابته، وقدرته على البقاء لعقود مقبلة. الدافع نفسه الذي ساهم في امتناع القوى الغربية، وكذلك إسرائيل، عن مواجهة مباشرة، هو خشيتهم من قوته في الداخل. الآن يرى الصينيون، الممول الأكبر للاقتصاد الإيراني، والروس، الحليف العسكري، أن النظام يعاني داخلياً. كما أن الرد العسكري على اعتداءات إيران كان يقتصر على وكلائها في الخارج. التساؤل في هذه العواصم اليوم، ماذا لو سقط، أو بقي واقفاً لكن بصعوبة؟
لا عودة للوراء
داخلياً، لا يمكن للنظام أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فالرغبة في التغيير تيار جارف. ويبدو أن خياراته، عدا استخدام القوة، محدودة. هل يحدث التغيير من داخله، قيادة بوجوه جديدة، وخطاب سياسي اجتماعي جديد، أو يلجأ لتخفيف الضغوط ويتصالح مع الخارج. وهذا يعني أن عليه أن يتعاون في الملف النووي، وينهي حروبه ومشاريعه بالهيمنة على العراق وسوريا ولبنان واليمن.
التساؤل هو حول قدرة نظام طهران على الصمود أمام الضغوط الداخلية المتكررة. الحقيقة لا ندري، إنما استمرارها حتى الآن، دون أن تظهر في الأفق بوادر نجاح النظام في إسكاتها، يعني أنه يضعف يوماً بعد يوم. ومن معرفتنا بسلوك النظام، وعناد تفكيره، فالأرجح أنه لن يتبنى التغيير، وسيفضل الإنكار الذي سيزيد من ضعفه وليس العكس. الأزمة في إيران عميقة ومتعددة ولن تتبخر، وإن نجحت قواته في إخلاء الشوارع من المتظاهرين وقطع وسائل التواصل واعتقال المزيد.
التعامل بصلف في الداخل يعكس طبيعة السلوك الفوقي والمتعجرف لدى القيادة الإيرانية، التي ترفض التعامل بواقعية مع مواطنيها، ومع جيرانها، والعالم بشكل عام. أصبحت كلفة سياساتها هذه باهظة عليها، على كل الأصعدة. فهي ترفض الاستماع والتعامل مع الاحتجاجات، وتستمر في سياساتها العدائية ضد نحو نصف دول المنطقة من أذربيجان إلى الخليج وحتى السودان، ومستمرة في مشروعها النووي العسكري الذي مر عليه نحو ربع قرن وكلفها مبالغ طائلة وتسبب في فقرها ومحاصرتها اقتصادياً. الجبهات تتسع على النظام، والنزيف يستمر في الداخل والخارج.
لقراءة المزيد من المقالات ضمن هذه السلسلة: