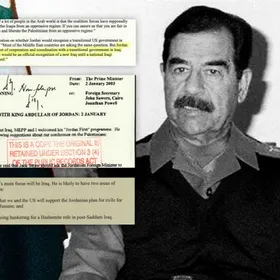تفتح "سلمى" باب منزلها وشعرها مسدل في سواد الليلة التي تقرر فيها أن تخرج، كما خرجت الدمية "نورا" بطلة مسرحية هنريك إبسن الشهيرة "بيت الدمية" قبل أكثر من قرن كامل.
تمسك "سلمى" يد ابنتها الصغيرة التي تسألها "إلى أين نحن ذاهبتان يا أمي؟"، فتنظر سلمى إلى الأفق الواسع، ويستأنس أحمر الشفاه بطيف ابتسامة أمل في أن ما ينتظرها أفضل مما تركته بكثير.
يحيلنا المشهد السابق من الفيلم الإماراتي "ما وراء سلمى" للمخرجتين مريم السركال وماريا السيد – إلى سؤال "ماذا تريد النساء؟"، وهي التيمة التي يمكن سماع خطواتها تسير في أروقة التجارب التي عُرضت ضمن فعاليات الدورة الـ5 لمنصة الشارقة للأفلام هذا العام.
عقب دورتين افتراضيتين خلال قتامة الإغلاق، تعود منصة الشارقة بتطور واضح، لتنضم إلى قائمة التظاهرات التي تنبض فيها الشاشة الكبيرة مرة أخرى بالسينما والحياة.
علامة استفهام
ومن بين 30 فيلماً توزعوا على أقسام المنصة، الوثائقي والتجريبي والروائي القصير والطويل، نكاد نلمح تجول علامة الاستفهام، فالزخم الكمي في عدد الأفلام التي قدمتها مخرجات ضمن اختيارات المنصة هذه الدورة، يوازيه زخم كيفي أظهر صانعات سينما قدمن إجابات على السؤال بتجاربهن، التي تنضح بالعبير المر للتجربة.
حين خرجت "سلمى" من منزل الزوجية ممسكة بيد ابنتها الصغيرة، ذكرتنا بهروب الجدة الشابة في الفيلم الهندي "سمخور" للمخرجة إيمي باروه.
تركت "سلمى" ورائها منزلاً رحباً وزوجاً تشير جثته الضخمة إلى فحولة مطلقة، لكنه منشغل وعصبي وحانق ومحتقن طوال الوقت، تماماً مثل مجتمع القرية التي هربت الجدة الشابة منه بحفيدتها الوليدة.
هذا المجتمع طلب ابنتها التي بالكاد تجاوزت العاشرة للزواج، لأن حيضها أشهرها امرأة، ولكن رحمها الصغير لم يطق صغيرة اخرى مثلها، فلفظت الابنة أنفاسها وقت الولادة.
وأعلن الموروث الشعبي كلمته؛ يجب حرق الوليدة الحية مع أمها الطفلة النافقة، هكذا تطلب التقاليد، كما سبق لها وأن طلبت عدم علاج أخاها لأنه "ملبوس بروح شريرة"، وليس لأن جرحه ملوث يتطلب عناية طبية.
لا تجد الجدة الشابة مفراً من الهرب بالحفيدة، بعد أن كفرت بمجتمعها الصامت على الإيذاء الروحي، تحت مظلة قهر عقائدي ومجتمعي مصمتة.
"اليد الخضراء"
ويقابل سؤال "ماذا تريد النساء؟" دوماً سؤال "ماذا يريد منهن المجتمع؟"، أو ماذا يريد المجتمع؟ أي مجتمع من النساء اللائي يشكلن نصف قوامه؟.
في مقابل ما تريده النساء من بيئات آمنة، في الشارع أو البيت أو حتى في أحلامهن، نجد المجتمع كما تم تصويره في الأفلام المعروضة بالمنصة، يسير عكس اتجاه توفير هذه البيئات.
في فيلم "اليد الخضراء" للفلسطينية جمانة مناع، تطارد السلطات الإسرائيلية المواطنين الفلسطينيين الذين يقطفون الزعتر والعقروب، وهي من النباتات البرية التي تنبت في الأرض المقدسة دون زراعة.
وبحكم القانون الإسرائيلي ممنوع على العرب قطف النبات البري –العرب فقط-، لأن هذا يضر بتجارة الزارع الإسرائيلي، الذي يريد أن يتكسب من وراء زراعة هذه النبات غصباً عن الطبيعة، حتى ولو لم يُقبل شعبه على أكلها.
تقترب المخرجة في الفيلم من جلسة مجموعة من الخالات المسنات، اللائي يمارسن سعادة مفتقدة بطبخ الأكلات الفلسطينية، التي تعتمد على نبات الأرض، يتحدثن عن استجداء النبات البري وسخافة المحتل الراغب في طمس هوية البلاد، بمنع حتى النبت الرباني الصعود من ترابها إلى شمسها إلى يد صاحبها الأصلي.
تعيد المخرجة بناء التحقيقات الهزلية مع ربات بيوت فلسطينيات، يتم التحقيق معهن لأن بيوتهن احتوت على زعتر وعقروب.
إن مجتمع دولة الاحتلال لا يريد لامرأة فلسطينية أن تتذكر، أو تذكر أن جدها كان يحصد الزعتر البري من الأرض، وكأن الأرض قبل احتلالها لم تكن ساكنة لا بالبشر ولا بالنبات.
هذا المجتمع يشبه إلى حد ما مع بعض فوارق بسيطة المجتمع المصري، الذي لا يريد للمرأة أن تسير آمنة بهيئة لا تناسب مخيلته المشوهة، بفعل تراكمات عقائدية مختلف عليها وتقاليد لوثها التخلف الحضاري.
"كما أريد"
في الفيلم المصري "كما أريد"، الحائز على تنويه خاص من لجنة التحكيم، تُدين المخرجة سماهر القاضي الظاهرة الأبرز والأحط في هذا المجتمع وهي التحرش الجنسي.
تمزج ما بين خصوصية جسدها وعمومية الأزمة السياسية والمجتمعية، التي كانت تعيشها مصر وقت حكم الإخوان، أزمة مجتمع يسير إلى الوراء ويرتد سياسياً وفكرياً واجتماعياً.
تدور أحداث الفيلم بين عامي 2012 و2013 عام حكم الإخوان والحراك الذي تلاه، تخلط ما بين رفع المجتمع شعار الدولة الإسلامية، وبين نفاقه وازدواجيته في التعامل مع المرأة.
تتابع أكثر من خط درامي للتوثيق، حملها في صبية وخوفها من أن تعيش ابنتها ما عاشته هي، علاقتها بأمها التي رفعت شعار "يا مخلفة البنات يا حاملة الهم للممات"، تحرشات الشباب العاطل والباطل في منطقة وسط البلد حيث تسكن، انخراطها في حملة إحدى الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق جسد المرأة، وأخيرا نزولها المظاهرات ضد الإخوان وما تلا ذلك.
تصور سماهر معظم فيلمها بنفسها، تتحرك الكاميرا بنفس السخونة التي تلاحق بها متحرشاً لفضحه، تصور الاضطرابات العنيفة التي أدت إلى تكسير المقهى أسفل بيتها 3 مرات في الفيلم، ردود أفعال المتفرجين على وقائع التحرش الذين يلومونها على مقاومتها، ثم فصل الخطاب حين تلتقي بفتيات صغيرات محجبات يلعبن في حديقة شعبية، لتعلن لها واحدة بكل ثقة أن (المرأة أصلا عورة).
"فقاعات السعادة"
لا يمكن لمجتمع يشاكل المرأة ويعاند وجودها الحر، أن يكون متقبلا للأخر بصورة حقيقية ودافئة.
في الفيلم الإماراتي "فقاعات السعادة" تقدم المخرجة لطيفة الخوري سؤال الآخر بصورة بسيطة، لكنها تحتوي الدفء المطلوب للإجابة؛ إذ تنشأ علاقة صداقة بين شابة جميلة وبائع كرك هندي، جاء إلى الإمارات منذ سنوات طويلة.
يمزج الفيلم ما بين الخيالي والوثائقي، فنرى الشابة تمر يومياً عليه للحصول على كوب الكرك، الذي تطفو على وجهه فقاعات الجودة –أي أنه مصنوع بإتقان-، تسميها المخرجة فقاعات السعادة، وتتابع بشكل هادئ نموها كما تنمو الفقاعات على سطح كوب الكرك الساخن.
بينما نسمع صوت الرجل الهندي وهو يتحدث عن حياته قبل المجيئ إلى الدولة، وعن شعوره بالتقبل والهدوء هنا واللذان يجعلان الكثيرين مثل هذه الفتاة وغيرها أصدقائه، نعرف من خلال دفتر الحسابات التي يدون فيها عدد الأكواب التي يستهلكها رواده يومياً قبل أن يحاسبهم في نهاية الشهر.
وفي النهاية يقول للفتاة أنه سوف يعلمها كيف تصنع كرك لذيذ مثل الذي يصنعه، فتقول له "ولكني لو تعلمت فلن أتي إلى هنا، وأنا أحب أن أمر بسيارتي عليك وأتناول الكرك"، وكأنه صار جزء من نسيج حياتها وبالتالي جزء من نسيج المجتمع، الذي يحتوي على نسبة وافدين كبيرة جداً، لكن ثمة حالة تناغم وتعايش وتقبل لا يمكن إنكارها.
"إلى الشباب"
على النقيض تماماً – فكرياً- من الفيلم الإماراتي، يأتي الفيلم اللبناني "إلى الشباب" إخراج ميرا مرعب، يتخذ الفيلم الوثائقي تقنية التعليق الصوتي المستمر على معادلات بصرية، ولقطات وتفاصيل تخص الحياة في لبنان.
التعليق عبارة عن صوتي فتاة وشاب، هو يحفز فكرة الهجرة بشكل قوي، وهي تدافع عن كونها لا تريد أن تعيش في المهجر أيا كانت حلاوته، تضعف أحيانا أمام مسوغاته المجتمعية والسياسية، التي تدفع للهرب وليس فقط للسفر، ثم تعود للمقاومة خوفاً من الانهيار في منظومة الغربة، التي تشعر أنها سوف تبتلعها.
وفي النهاية تسأله "لماذا يواجه جيلهما هذه الأسئلة، لماذا لا يكون بلدهما مغناطيسيا للبقاء؟، لا مجرد مساحة طاردة بسبب سوء حالة المواطن الروحية والإنسانية والنفسية قبل الجسدية.
وما بين الفيلمين الإماراتي واللبناني، يأتي الفيلم اليمني "لا ترتح كثيراً" للمخرجة شيماء التميمي، ليتوقف عند الرحلة نفسها ما بين قطبي المنشأ والمهجر، متتبعة حياة جدها الذي غادر اليمن قبل سنوات عبر تاريخه الفوتوغرافي، في فيلم أقرب لشكل ألبوم العائلة.
وتمنح شيماء نفسها حرية التساؤل حول معنى الطريق الذي قطعه الجد، والوجود الهش الذي اكتسبه في ذاكرة أسرته الكبيرة، ربما نتيجة ابتعاده عن وطنه الأم.
تطرح المخرجة سؤال الشتات الذي تعيشه أسرتها ممثلة في شخصية الجد، الشتات الداخلي الذي لا يلوح على سطح الحياة الطيبة والدخل الواسع والأبناء والأحفاد، ولكنه الشتات الكامن بجانب الروح في أعماق القلب، وربما لم تكن تريد إجابة بقدر ما كانت تحدق في ذاتها عبر انعكاس صوتها على صوره، التي احتفظت ببعض من حزنه القديم.
* ناقد سينمائي