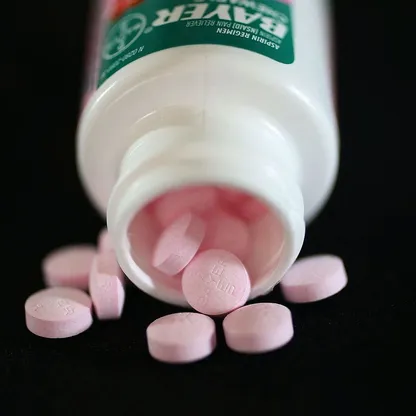ما السر وراء انصراف الجمهور بما فيها الشرائح المستهدفة عن فيلم "أهل الكهف" (معالجة أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة عن مسرحية توفيق الحكيم)؟، المعروض في موسم عيد الأضحى السينمائي.
يتفرق دم الفيلم بين عدة عناصر، أبرزها بالطبع المعالجة المتواضعة جداً لمسرحية الحكيم الذهنية، التي كتبت عام 1929، ونشرت لأول مرة عام 1933 لتصبح فتحاً في تاريخ الأدب والمسرح العربي.
تبدو مسرحية الحكيم مشغولة شكلاً وموضوعاً بسؤال الزمن وعلاقته بالبشر، في وقت كانت فيه الحياة السياسية والاجتماعية في مصر تجني ثمار المخاض الهام بعد ثورة 1919، وبدا أن الحكيم مهموماً بمعادلة التنبيه أن البقاء في كهف التاريخ دون مواكبة حركة الزمن، لم يحول شخصيات العمل إلى قديسين، بل مجرد أشباح لا تدري عن تطور الحياة والوجود سوى بقايا من ذكريات لم تعد تجدي، حتى لو تجسدت بعضها، كما في شخصية الأميرة بريسكا ابنة الملك الوثني دقيانوس وحبيبة واحد من أهل الكهف، وشبيهتها ابنة الملك المسيحي عقب 300 سنة، والتي لا تتماس معها سوى في الصورة فقط بينما الجوهر والشخصية مختلفين.
بينما لا تبدو المعالجة مهمومة بأي من هذا، وهو من حق السيناريست في حال وجود همّ فكري ودرامي آخر، يمكن أن يعاد اكتشاف النص من خلاله.
لكن ما فعله قمر هو أنه لم يترك موضوع النص الأصلي في حاله بمتانته الفكرية وتماسكه الفلسفي، ولم يتمكن من طرح زاوية تناول أخرى تتناسب عضوياً مع طبيعة الحدث الأساسي، بقاء سبعة رجال مؤمنين نائمين في الكهف 300 عام، ثم استيقاظهم ليواجهوا العالم الذي لم يعد يعرفونه ولا يعرفهم.
وليست الأزمة في زيادة عدد الشخصيات من 3 كما في المسرحية (ميليخا الراعي، ومشلينيا، ومارنوش وزراء دقيانوس)، فمن حق السيناريست إضافة إي عدد من الشخصيات لمعاجلة النص طالما أن كل شخصية مضافة لديها صلة عضوية بالفكرة الأساسية التي يطرحها النص، وإلا صارت مجرد حلية زائدة عن الحاجة تفسد الصورة العامة للفيلم درامياً وايقاعياً وفكرياً بالطبع، وهو ما يمكن أن نراه بوضوح في شخصيات مثل "عرنوش" وزير "دقيانوس" اليهودي، (قدمه صبري فواز في محاولة لاضافة تفاصيل تخص ثعبانية الشخصية)، وهي شخصية تشكل التباس كبير في توجه الفيلم ككل، الذي يحاول أن يدعي أنه يتحدث عن ضرورة فصل الدين عن السياسة، في واحدة من أكثر التجارب متاجرة بهذا الشعار وتسطيحاً له بصورة طفولية.
في البداية أبدلت المعالجة وزراء الملك باثنان من القواد العسكريين، "سبيل" الذي يأتي من أصول عربية (خالد النبوي)، و"بولا" الروماني (محمد ممدوح) دون أن يبدو أن هناك داع حقيقي لأن تكون واحدة من الشخصيات من أصول عربية، فالحكاية كلها لا علاقة لها بالعرقيات ولا تنوعها، ومسألة فصل الدين عن السياسة كما يطلق شعارها في البداية شخصية أحمد بدير الذي يحكي القصة، ويدعى إنسان، في تأطير مبتذل لقيمة الاسم والصفة.
ثم أضافت المعالجة شخصية "عرنوش اليهودي"، الذي يرغب في إفساد العلاقة بين "سبيل" و"بولا" و"دقيانوس"، الذي ليس في حاجة لمحفز مثل "عرنوس"، فيكفي أن يعلم أن قواده مسيحيين وقت عصر الشهداء، حيث كانت التهمة كفيلة بالقاء الأجساد للأسود وقطع الرقاب.
هكذا لم يستفد السيناريو لا بأصول "سبيل" العربية، ولا يهودية "عرنوش"، مع ضرورة ملاحظة أن الإمبراطور الوثني لديه وزير يهودي، في حين أنه يقتل المسيحيين، وهي مسألة مشكوك في منطقها التاريخي والدرامي.
ثم لماذا يقيم الإمبراطور في مدينة طرسوس وليس في روما؟، لأن المعالجة أبدلت اللقب حرصاً على محاكاة الفيلم الشهير Galdiator، فكما أن لدينا حلبة المصارعة الرومانية والإبهام الذي يهبط إلى اسفل من أجل القتل، ومشاهد مصارعات العبيد، والحديث الساذج عن إلهاء الشعب بالدم والعنف بدلاً من أن يتدخل في السياسة، كما يأتي على لسان "عرنوش" للأميرة، ثم محاولة قتل "سبيل" و"بولا" داخل الحلبة، في جولات دموية متتالية، كل هذا يؤكد ولاء الفيلم لتجربة ريدلي سكوت الكلاسيكية، مع بعض الإضافات من أفلام أخرى مثل Troi، وأسلوب قتال "أخيلوس" الذي يعيد النبوي إنتاجه حركياً بسيفه اللامع.
"ميليخا" التافه
تستبدل المعالجة حكمة الراعي "ميليخا "وعقلانيته، وانحيازه لفكرة أن عودتهم للكهف ضرورية، لأن الزمن تجاوزهم؛ ولأن القداسة لا تمت بصلة لأشخاص لم يعد لهم قيمة حقيقية في مجتمع متغير؛ بآخر تافه وسطحي يحاول الاستظراف طوال الوقت في خلط واضح مع مبدأ (الريليف)، أو التخفيف من حدة الصراع، وقتامة الحبكة، حيث يقدم أحمد عيد أداءً يذكرنا ببداياته الأولى، حين كان مجرد سنيد شبحي لهنيدي والسقا، وذلك في تسطيح مخل لقيمة الشخصية الرائعة في النص الأًصلي، وما تمثله من رجاحة فطرية بحكم عمله كراعي (العمل الذي مارسه الأنبياء من قبله ومن بعده)، ولا نجد أي استغلال لـ"قطمير"، إلا بحديث الراعي له وسؤاله المستمر عن خروفه أو عنزته.
وتزيد المعالجة من شعر السطحية بيت بإضافة شخصيات مثل التوأمين "نور" و"نار" (محمد فراج)، تذكرنا الأسماء بتوائم ألف ليلة وليلة، ولكن يبدو أن النص تجاهل أنهما رومان في بيئة رومية، فبدا اسميهما جزءً من حالة التشوش العامة، ولم يلجأ السيناريو لتبريرها، باستثناء مشهد "فلاش باك" غامض عن أبيهما المؤمن الذي كان يدعي الطيران أو ما شابه.
ينضم "نور" و"نار" إلى مجموعة الكهف بالصدفة، من الطريف حقاً أن "سبيل" و"بولا" يذهبان لحضور درس دين في دولة وثنية، وهما يرتديان ملابس قادة الحرب، التي تجعل الكل يعرفهما ويكتشف شخصيتهما ويبجلهما.
ثم يصحبهم الاسقف بعد استيقاظهم ليتبرك بهم شعب الكنيسة على اعتبار انهم قديسين، قبل أن يتواطأ مع مساعده من أجل التخلص من الملك، في مشهد يحاول محاكاة عرس الدم الشهير بمسلسل Game Of Thrones.
بيومي فؤاد
ربما كان أصدق ما في اختيارات الممثلين في هذا العمل الهزلي، هو بيومي فؤاد نفسه، في دور الإمبراطور المسيحي الذي يحكم روما من طرسوس لسبب مجهول، لأن المعالجة غيرت المنصب عن النص الأصلي دون أن تضعه في ميزان المنطق التاريخي أو الدرامي، فطرافة بيومي فؤاد وهزليته وسخريته المستمرة حتى وهو يتحدث حديث من المفترض أنه جاد أو عميق، جعلت السيناريو يميل إلى "البارودي" أوالمحاكاة الساخرة، منه للعمل الملحمي أو حتى الميلودرامي، والحوار العامي المخلوط بمصطلحات حديثة، مثل الحديث عن الزمن باللحظات على سبيل المثال، واللحظة هي قيمة زمنية لم تكن موجودة ولا محسوبة في وقت الأحداث.
ناهينا عن مخيلة (اللغة/الحوار) التي تتحدث عن (فصل الدين عن السياسة وإلهاء الشعب)، وما إلى ذلك من تعبيرات وألفاظ تجعلنا أمام محاولة "بارودي" لم تكتمل للأسف، فالحوار حين يأتي بلغة حديثة في أجواء تاريخية، فالغرض الواعي منه في ذهن الجمهور مباشرة، هو الهزل القائم على التناقض بين اللغة والصورة، ولهذا يلجأ صناع الدراما التاريخية إلى الفصحى أو إلى العامية الفصيحة، حتى لا يشتبك النص مع الجانب الهزلي في وعي المشاهد، الذي سريعاً ما يحلل الفارق بين المنطوق والمعروض، ويكتشف أن في الأمر طرافة ما.
وأكبر دليل على هذا أن وجود بيومي فؤاد في مشهد عرس الدم، أو العشاء الذي تم فيه قتل أطراف المؤامرة، فيما عدا الأسقف الذي يمثل السلطة الدينية، جعل المشهد بتركيبته وزوايا تصويره وتوزيع الجنود فيه خلف مائدة الطعام، أكثر منطقية من الناحية الساخرة أو الهزلية، منه للمنطق الدرامي، الذي يقول باكتشاف المؤامرة وقتل أفرادها، فأي عشاء هذا الذي يقف فيه جندي خلف كل مدعو، كأنه جلاد مستعد لقطع الرأس؟.
ميزان الموسم
إن جزء هام من تسويق أي منتج هو تحديد الجمهور المستهدف وتوقيت العرض، وكم من الأفلام الجيدة التي أفشلها سوء اختيار التوقيت، أو غياب الوعي بالشرائح التي يتوجه إليها العمل الفني، فما بالنا لو أن المنتج نفسه يعاني من هزال شديد على مستوى العناصر الأساسية، كتابة وإخراج وتمثيل، ناهينا عن أن كل محاولات المحاكاة لأعمال شهيرة، كما أشرنا، انقلبت إما إلى مقارنات لصالح الأصل، أو ضحكات لصالح الطرافة والسخرية.
وبالتالي فإن انصراف جمهور موسم العيد عن التجربة باتجاه أفلام تناسب ذوق الشريحة الأكبر، والتي لم يعد لديها رفاهية مشاهدة أكثر من فيلم في الموسم الواحد، بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار التذاكر في مصر، ومن ثم فإن الرهان أصبح على الفيلم الذي يستحق من وجهة نظر المجموع ثمن التذكرة الوحيدة التي يمكن أن يدفعها، ومن هنا يمكن أن ندرك واحدة من أسباب خسارة "أهل الكهف" في مقابل نجاح "ولاد رزق3" بإيرادات قياسية، كقيمة إنتاجية بجانب تكتل دعائي وشريحة عريضة مستهدفة وأسعار تذاكر أعلى من الموسم الماضي.
وحتى مع استبعاد ميزان الموسم في تقييم نجاح الفيلم، فإن العمل نفسه يشبه قصته، فصناعه خرجوا من كهف التقليد وفقدان الأًصالة وركاكة المعالجة ظناً منهم أن العنوان ذو الجاذبية الدينية، والاعتماد على اسم توفيق الحكيم، الذي ربما يجهله الجمهور الحالي أساساً، والملابس التاريخية والمعارك المليئة بالخوار والصراخ وقعقعة السيوف، سوف تشكل قشرة جذابة وجاذبة، ثم تبين مع الأيام الأولى للعرض أنها مجرد فصوص زجاجية هشة تفتت قداستها المفترضة، فدفعهم الجمهور دفعاً هذه المرة إلى أن يعودوا إلى كهف النسيان، لعلهم يصبحون عبرة لصناع أخرين غرتهم أماني النجاح دون اجتهاد أو إبداع.
* ناقد فني