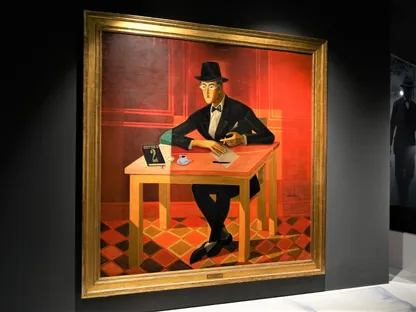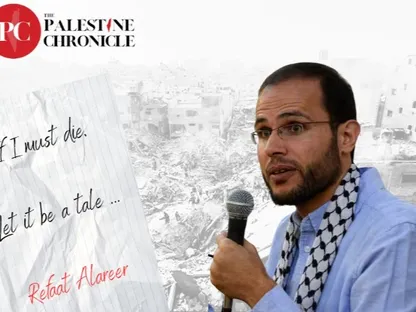يأتي ديوان الشاعر الفلسطيني سامر أبو هواش "من النهر إلى البحر"، الصادر عن منشورات المتوسط في ميلانو (2024)، ليكون توثيقاً شعرياً لحقبة الإبادة، وسجلاً أدبياً ينقش في جرح فلسطين، غير أن أبو هواش لا يكتفي برثاء الخراب، بل يحوّل الألم إلى شهادة إنسانية مدوّية.
في هذا الديوان، يصوغ الشاعر نصوصاً تجسّد التجربة الفلسطينية، فردية كانت أم جماعية، مستعيناً بلغة تتأرجح بين هدوء ظاهر أحياناً وتوترات صورية ولغوية عنيفة. وإذ ينطلق من مأساة غزة وفلسطين، فإن صوته الشعري يتجاوز الجغرافيا الضيّقة، ليصل إلى كل من ذاق مرارة التشريد وعانى قسوة القهر والاقتلاع.
عَبَر هذا الديوان حدود لغته الأصلية، وتُرجم إلى الإيطالية والإسبانية والكاتالانية، مع قرب صدور ترجمته الإنجليزية في لندن، إلى جانب الإعلان عن ترجمة فرنسية ستصدر عن دار "éditions LansKine" بتوقيع المترجم أنطوان جوكي، ما يدلّ على أن القصيدة الفلسطينية، رغم محاولات إسكاتها، استطاعت أن تفرض حضورها كجسر يصل التجربة الفردية بالضمير العالمي، وسردية إنسانية تتجاوز الحدود.
في هذا الحوار تقترب "الشرق" من تجربة الشاعر والمترجم الفلسطيني وملامح ديوانه، ودور الشعر في الإبادة، والآفاق التي يفتحها حين يصبح بديلاً عن الصمت والعجز.
بدءاً من عنوان الديوان "من النهر إلى البحر"، استحضرت عبارة مشحونة سياسياً بقدر ما هي مشبعة شعرياً، هل ترى أن اللغة الشعرية قادرة على احتواء هذا البعد السياسي دون أن تتلاشى فيه؟
عنوان الديوان مستلّ من إحدى قصائده، وهي قصيدة تعمل في الواقع عكس السياسة، إن لم يكن ضدها تماماً. في هذه القصيدة، أحاول استحضار كلّ ما فقده الفلسطيني في غزة، وفي فلسطين، وهو يتجاوز بكثير حتى فكرة الأرض، وكل ما له شأن بالسياسة والأيديولوجيا.
ما تحاول القصيدة قوله، إن الحقّ الفلسطيني لا يتوقف عند عناوين الحرية والعودة والدولة وتحرير الأرض، وهي عناوين مشروعة كبرى قام عليها نضال هذا الشعب منذ نحو ثمانين عاماً، لكنه أولاً وأخيراً الحق بالعدالة، وهذه العدالة تقتضي استعادة كلّ ما فقده الفلسطيني، على امتداد هذه العقود الطويلة، الذاكرة والمشاعر والتفاصيل البسيطة، لأقول إن كلّ ضحية هي عالم بحدّ ذاته، وهي وطن بحدّ ذاته، فكيف نعيد لها هذا الكم الهائل من الخسائر.
العدالة بالنسبة لي، هي الجواب عن ذلك كله، وهي مسألة إنسانية قبل أن تكون سياسية. جاءت التسويات السياسية السابقة، لترسّخ منطق المقايضة التي يفرضها القويّ أولاً وأخيراً، لكنها لم تتضمن اعترافاً بالجرائم السابقة، ولا اعتذاراً عنها، ولا تعهداً بوقفها وطيّ صفحتها، ولذلك وجدناها تتكرر بصور مضاعفة وأشد فداحة.
أمام مشاهد الإبادة التي تخلخل قدرة اللغة على التعبير كيف يتحدّد وعي الشاعر بدوره؟
هناك أمر ولدته الإبادة، وهو الشعور بالغضب والأسى والرفض. وهناك أمر ولده استمرار الإبادة رغم كل الغضب والأسى والرفض، وهو الشعور العميق باللا جدوى، لا جدوى الاحتجاج سواء باللغة أو غيرها، لأن الاحتجاج لم يستطع في النهاية وقف المقتلة.
لكن أي قصيدة أو رواية أو لوحة أو فيلم، استطاعت يوماً أن تمنع حرباً أو توقفها؟ أمام مأساة وقوع الحرب، وعبثية أنها تتكرر رغم كل ما اصبحنا نعرفه عن الحروب السابقة، نشعر بالضعف والانسحاق وبأن ثمّة إرادة أقوى منا تسيّر العالم، إلا أن هذا بالضبط هو السبب الجوهري للتمسك بالكتابة والفنون، والاحتجاج بمختلف أشكاله.
صحيح أننا لا نوقف حرباً بقصيدة، لكن الاستسلام لليأس وعدم الكتابة، يعني أن تلك الحرب نجحت في تحقيق أقصى أهدافها، وهو قتل الأمل فينا.
هل يكفي أن يكون للشعر دور في اللحظة ولو لم يصمد في الذاكرة الثقافية؟
ليس للشعر دور إلا في اللحظة، فالقصيدة لا تعرف مستقبلها ولا حتى تلقيها في زمنها. فكم من قصيدة اشتهرت وقت ذيوعها ثم طواها النسيان، وكم من قصيدة استحضرها الناس في أزمنة لاحقة، فعاشت حياة جديدة.
لا يستطيع أيّ شاعر الكتابة من منطلق أنه يصنع نوعاً من النصب الشعري سيظلّ صامداً بمرور الزمن، فجلّ ما يمكنه فعله، هو أن يتجاوب مع زمنه ويستجيب لانفعالاته الخاصة، بل وحتى لشعوره بالضرورة الأخلاقية كونه شاهداً على زمنه وما يحدث فيه، وأيضاً السعي الدائم لتطوير نصّه ولغته.
أما مصير القصيدة فهو في علم الغيب. ولابدّ لي من الإقرار بأني على المستوى الشخصي لا أؤمن بالخلود الأدبي أو الفني، ولا أجد أيّ معنى للانشغال به، إذ لم يعد شاعر أو فنان من الموت، ليخبرنا عن شعوره بأن الناس يرددون اسمه أو يحفظون قصيدته. إذن، فلنفعل كل ما نستطيع فعله في حاضرنا، ولنترك المستقبل لأهل المستقبل.
رغم أن قصائدك تنطلق من سياق فلسطيني لكنها لا تنسى القارئ الآخر غير العربي بوصفه شريكاً في تلقي هذه التجربة واستيعاب الإبادة؟
كلّ إبادة، كما كلّ حرب كبرى، تصبح شأن الجميع، وهم الشهود عليها، بالمعنى الأخلاقي للكلمة، وفي حالة غزة وفلسطين، بالمعنى السياسي أيضاً. نحن نرى تداعيات حرب غزة على العالم بأسره، بما في ذلك التداعيات الأخلاقية والقيمية والسياسية، العالم بعد 7 أكتوبر لا يشبه العالم قبله، والجميع في النهاية يدفعون بصور عدّة ثمن ما يجري في هذه البقعة أو تلك من العالم، وإن لم يكونوا معنيين مباشرة بها.
في حرب غزة، رأينا مثلاً حال الحرّيات الفردية والجماعية في بلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا، وهي حال تمسّ أهل تلك البلاد بقدر ما تمسّ العرب والفلسطينيين. ليس في مقدور أحد اليوم، أياً كان موقعه في العالم، القول إنه لا يعرف ماذا يحدث، والسؤال الملحّ الذي يفرض نفسه على الضمير الإنساني، يبقى: ما كان موقفي خلال ذلك، وماذا فعلت حتى لا نرى العالم يغرق في دوامة أخلاقية جديدة.