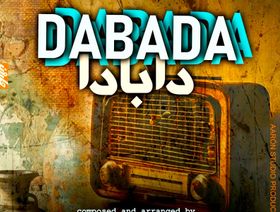على امتداد صفحات الكتاب، تنسج الكاتبة الأميركية ربيكا سولنيت في "شهوة التجوال: تاريخ للمشي"، الصادر عن دار تكوين الكويتية (2024)، ترجمة نوال العلي، سرداً يتجاوز التأريخ أو التوثيق، ليصبح المشي مدخلاً لفهم الإنسان ومحيطه.
ومن خلال التجربة الشخصية والسرد الروائي، المدعّم بمراجع وشهادات لكُتّاب وناشطين وأشخاص عاديين، شكّل المشي، الذي غالباً ما يُنظر إليه كأمر عابر، جزءاً جوهرياً من حياتهم.
يتنقّل النص بسلاسة بين الشوارع والغابات، بين الحدائق العامة وأسوار المعابد، ويتحوّل المشي إلى أكثر من مجرد فعلٍ جسدي؛ يصبح أداة لاكتشاف الذات، ووسيلة للتعبير، وأحد الشعائر الدينية في آنٍ معاً.
تتوقّف الكاتبة عند طقوس الحج الروحي، التي يمارسها بعض شعوب أميركا الشمالية، ممن يقطعون المسافات الطويلة سيراً على الأقدام نحو "سانتواريو دي تشيمايو" في ولاية نيو مكسيكو. وتبيّن كيف يتحوّل الجسد السائر إلى حاملٍ للنية، ووسيطٍ بين الأرض والمقدّس.
غير أن النص لا يكتفي بهذا البعد الروحي، بل يوسّع من عدسته ليتناول العلاقة المعقّدة بين المشي والتنظيم العمراني؛ فتستعرض الكاتبة تاريخ الحدائق العامة، وتخطيط الشوارع، وسياقات تسلّق الجبال، وصولاً إلى سرديات الحياة اليومية كما تتجلّى في خطوات المارّة العابرين أو المرتحلين.
تضيء على التجوال باعتباره ممارسة ثقافية مشروطة بالمكان والزمن، وتستعرض كيف أن نوادي المشي التي ظهرت في أزمنة حديثة، ليست سوى امتداد لفكرة قديمة حول "المشي كفعل اجتماعي".
زمن التسارع
تفرّق الكاتبة بين المشي بوصفه وسيلة تنقّل، كأن يصل موظف المكتب إلى القطار، وبين المشي بوصفه فعلاً محمّلاً بالمعنى، يشبه في تعقيده الثقافي أفعالاً مثل الأكل أو التنفس حين تتحوّل إلى رموز إيروتيكية أو روحانية. بهذا المعنى، فإن المشي ليس فقط انتقالاً فيزيائياً، بل حركة ثقافية ساهمت في تشكيل المدن، والخرائط، والأساطير، والشعر، والتاريخ.
في كل مكان مرّ فيه الإنسان على قدميه، ترك أثراً ونسج حكاية. من هنا، يصبح المشي أداة للخيال بقدر ما هو أداة للحركة. إنه الذي صاغ المسارات، وخلق الطرق، وحمل الحجّاج، والعشّاق، والثوّار، والمفكّرين عبر الجبال والصحارى، والحدائق والنزهات الصيفية.
لكن هذه الرؤية للمشي تواجه تهديداً في العالم المعاصر، حيث تآكلت المساحات العامة، وصارت المدن تخطط لتناسب السيارات والمولات أكثر من الأقدام. لم تعد الشوارع الرئيسية تمتلك الأرصفة، ولا توجد ساحات أمام المباني العامة، فيما صار الدخول إلى الأماكن مشروطاً بالحواجز والبوابات.
في مواجهة هذا التشظي، يصبح المشي موقفاً ثقافياً مضاداً. إنه مقاومة صامتة لزمن التسارع، ومحاولة لاستعادة العلاقة بين الجسد والمنظر الطبيعي. لا يعود السفر حكراً على الطائرات والقطارات، بل يمكن أن يحدث حين نسير إلى نهاية الشارع. فـالمشي ليس وسيلة فقط، بل غاية بذاتها، إنه الشكل الأكثر بداهة وصدقاً من السفر، حيث يسافر القريب والبعيد، الداخل والخارج، الجسد والفكر.
فعل ثقافي وروحي
لا يُفهم المشي كمجرد حركة في المكان، بل كفعل ثقافي وجسدي وروحي، وشبكة معقّدة من المعاني والدلالات التي تجعل من كل خطوة فعلاً يحمل أثراً.
إنها دراسة شاملة لا تخلو من جهدٍ بحثي، ترصد وتتبّع وتفكك وتعيد تركيب المشهد الكامل لهذه الممارسة الإنسانية القديمة، في محاولة للإحاطة بالموضوع من كل جوانبه، لتمنح القارئ في نهاية المطاف، فهماً أعمق للعلاقة بين الجسد، والمكان، والذاكرة.
تشير سولنيت إلى أن تاريخ المشي، رغم كثافته في التجربة الإنسانية، لا يدوّن غالباً ضمن التأريخ الرسمي، بل يظل متشظياً، يمكن اقتفاء أثره عبر الأغاني، والقصص، والشوارع، والتجوالات الفردية. إنه تاريخ لا ينتمي إلى السلطة، بل إلى الهواة، مثله مثل الفعل نفسه: متواضع، فردي، ومفتوح على احتمالات لا نهائية.
بإشارة لطيفة من الكاتبة، تستحضر طقساً يمارسه شعب الأسكيمو، حيث يُنصح الغاضب بأن يمشي في خط مستقيم في الطبيعة، إلى أن تهدأ مشاعره، فيُقاس مدى غضبه بطول الطريق الذي قطعه. ومن هذه البداية الرمزية، تُدخلنا في فكرة المشي بوصفه طقساً نفسياً وروحياً، لا يقلّ أهمية عن طقوس العبادة أو التأمل.
في هذا السياق، يصبح المشي أقرب إلى تجربة عقلية وجسدية مركّبة، تربط بين الداخل والخارج، بين النفس والمنظر الطبيعي. وتقول: "يخلق إيقاع المشي نوعاً من إيقاع التفكير"، وهو ما يجعل كل خطوة أشبه بعبور داخلي، تماماً كما هي عبور في المكان.
المشّاؤون المعاصرون
في واحدة من أكثر تأملاته عذوبة وصدقاً، كتب جان جاك روسو في الاعترافات: "لا يمكنني التأمل إلا عندما أمشي؛ عندما أتوقف، أتوقف عن التفكير؛ عقلي يعمل فقط مع ساقي".
بهذه العبارة يفتتح المشّاؤون المعاصرون تاريخاً غير مكتوب للمشي بوصفه فعلاً للتفكير والحرية والوعي، لا مجرد وسيلة للوصول. صحيح أن المشي أسبق من الإنسان في تاريخ التطوّر، غير أن المشي بوصفه ممارسة ثقافية واعية بذاتها، ليس قديماً كما نعتقد، بل ظاهرة حديثة نسبياً، تعود جذورها – على الأقل بوصفها أسلوباً للتأمل والتعبير – إلى مفكري القرن الثامن عشر، وفي مقدّمهم روسو.
منذ روسو، بدأ المشي يخرج من كونه مجرد نقلٍ فيزيائي للجسد إلى أن يصبح نوعاً من التجربة الذهنية والجمالية. كثير من الفلاسفة مثل جيريمي بنثام، وجون ستيوارت ميل، إلى توماس هوبز، عرفوا قيمة المشي الطويل، واعتادوا على ارتياد الطرقات بعقول منفتحة.
هوبز، على سبيل المثال، كان يحمل معه أثناء نزهاته عصاً صغيراً (دفترًا) مزوداً بمحبرة، كي يدوّن ومضات أفكاره عندما تولد.
لكن إيمانويل كانط، رغم مشيه اليومي المنتظم حول كونيغسبرغ، لم يكن يرى في المشي أكثر من تمرين صحي بعد العشاء. أما نيتشه الشاب، فكان يعترف بلا تردّد: "ألجأ إلى ثلاثة أشياء لأسترخي: شوبنهاور الذي أحبه، موسيقى شومان، وأخيراً... المشي بمفردي".
يقدّم الفيلسوف الفينومينولوجي إدموند هوسرل تأمّلاً عميقاً في العلاقة بين الجسد والعالم من خلال فعل المشي. في مقاله "عالم الحاضر المعيشي وتكوين العالم الخارجي المحيط بالكائن الحي" (1931)، لا ينظر إلى الإدراك عبر الذهن أو الحواس المجرّدة، بل من خلال الجسد المتحرك.
يرى أن الجسد هو "المكان الدائم لـ (هنا)"، بينما "هناك" تتغيّر، وتتقدّم نحونا. المشي إذاً هو ما يجعل استمرارية الذات ممكنة وسط تغيّر العالم، وما يربط الداخل بالخارج، الشعور بالمكان والشعور بالذات.
من يستطيع المشي؟
في منتصف القرن العشرين، يبرز مشّاء آخر من نوع مختلف: الشاعر الأميركي غاري سنايدر، أحد رموز حركة "البيت. قبيل رحيله إلى اليابان عام 1956، أخذ صديقه جاك كيرواك في نزهة جبلية ليلية إلى قمّة تامالبايس.
هناك، وسط الصخر والريح، قال له: "كلما اقتربت من المادة الحقيقية – الصخر، الهواء، الحطب – يكون العالم أكثر روحانية، يا ولد".
هذا التوتر الجميل بين المادي والروحي، بين المشي والروحانية، يُشكّل العمود الفقري لفكر سنايدر، ولفكر العديد من كتّاب الطبيعة والتأمل الجبلي. يرى الباحث ديفيد روبرتسون في هذه العبارة جوهراً لممارسة جوهرية: الاكتراث - أي الاهتمام بالعالم كما هو، بالشجرة كما الشِّعر، بالحطب كما بالحكمة. المشي الطويل، عند سنايدر، ليس نزهة، بل موقف سياسي وروحي واجتماعي. إنه وسيلة "لإعادة اكتشاف الجسد، والعالم، والثورة".
لكن، من يستطيع أن يمشي فعلاً؟ هذا السؤال، رغم بساطته الظاهرة، يخفي وراءه طبقاتٍ كثيفة من التاريخ الاجتماعي، ومن النضال الطبقي على الزمان والمكان والسيادة على الجسد. فالمشي، حين لا يكون قسراً أو ضرورةً اقتصادية، بل خياراً حراً من أجل التأمل أو المتعة أو الفضول، لا يتحقّق إلا بتوافر ثلاث حريات: الوقت، والمكان، والقدرة الجسدية.
الطبقات العاملة
لهذا، لم يكن نضال الطبقات العاملة من أجل تحديد ساعات العمل مجرد مطالبة بالراحة، بل كان في جوهره دفاعاً عن حقّ الإنسان في أن يمشي، في أن يخرج من بيته لا إلى المصنع أو السوق، بل إلى الشارع، إلى الطبيعة، إلى نفسه.
من هنا، لم تكن الحدائق العامة الكبرى، كمشروع "سنترال بارك" في نيويورك مثلاً، مجرد مخططات حضرية جمالية، بل أدوات لإعادة توزيع الفضاء، إذ منحت سكان المدن الفقراء شيئاً من "الريف المستعار"، حيزاً يُمكّنهم من اختبار حرية الجسد خارج شروط العمل والإنتاج.
في خلفية كل خطوة حرة، إذًا، يقف تاريخ طويل من الكفاح ضد الزمن المملوك والحيز المسيّج والجسد المقيد. هنا، يكتب والاس ستيفنز في كتابه "من سطح الأشياء": "في غرفتي، العالمُ أكبر من استيعابي، ولكن عندما أمشي، أرى أنه ثلاث أو أربع تلالٍ وغيمة".