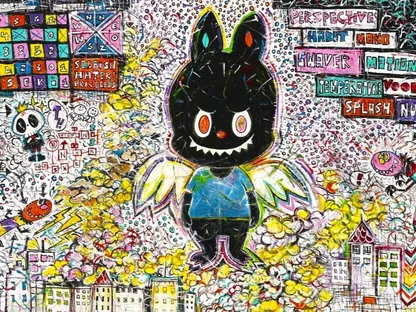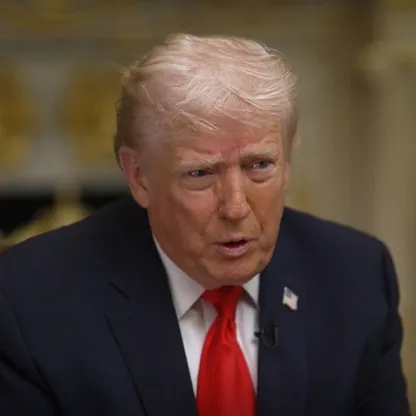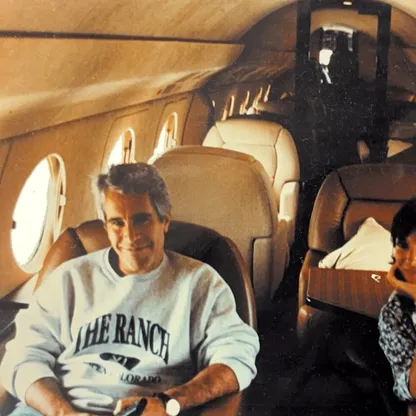من الناحية التشكيلية، تعدّ البطيخة مادة ثرية للعين والمخيّلة؛ فقشرتها الخضراء المخطّطة ولبّها الأحمر المشتعل بالعصارة، يخلقان ما يشبه الصدمة الحسية. إنه تمازج عنيف بين الغلاف الصلب والداخل الطري، بين التوتر والراحة. ليست هذه سمات نباتية فحسب، بل تمثيلات جمالية تستحضر لغة الجسد، والإغواء.
جماليات البطيخة
في تاريخ الفن الغربي، لا سيما في القرن الثامن عشر، حضرت البطيخة في أعمال الطبيعة الصامتة، بوصفها تجسيداً للغنى الحسّي والبصري. في لوحة الفنان الأميركي روبرت سبير دانينغ، "حياة ساكنة من الفاكهة والعسل والسكاكين" (1867)، تظهر البطيخة مقطّعة ومبللة بالعصير، تلمع تحت ضوء خافت، يدعو العين إلى تذوّقها بصرياً.
أما الرسام الإسباني لويس إيخيديو ميلينديز، فقدّمها في عمله "طبيعة صامتة مع البطيخ والكرز والجبن والخبز والنبيذ" (1779)، وسط مائدة ريفية تشي بالوفرة؛ لكن خلف هذا المشهد الريفي البسيط، تُستبطن معاني مرتبطة بالشهوة والأنوثة.
في العصر الحديث، لم يفتر الحضور الرمزي للبطيخة، بل تضاعف. في فيلم "طعم البطيخة" (2005) للمخرج التايواني تساي مينغ ليانغ، تغدو البطيخة عنصراً شهوانياً يرمز للعطش الجسدي والروحي في آن، متجاوزة كونها ثمرة، إلى كونها استعارة للمحرّم والمكبوت.
كذلك نجد توظيفاً بصرياً قوياً للبطيخة في سلسلة "Empire Line" للفنانة الأميركية روبن ستايسي، حيث تتقاطع رمزية البطيخة مع تاريخ العبودية والتمييز العرقي في الولايات المتحدة، وتتحوّل إلى تعبير عن الأنوثة السوداء، ومقاومة السرديات الاستعمارية.
تاريخ سياسي للفواكه
في كتابه "التاريخ السياسي والثقافي للفواكه" (2025)، يشير فيديريكو كوكسو، إلى أن العلاقة الخاصة بين الأفارقة الأميركيين، والبطيخة، نشأت في القرن التاسع عشر، جراء عملية نيل حريتهم خلال الحرب الأهلية الأميركية.
كانت البطيخة من أبرز وسائل كسب العيش لديهم آنذاك زراعة وبيعاً. وهكذا، أصبحت هذه الفاكهة رمزاً للكليشيه العنصري، الذي يصوّر "الزنجي" في صور يُفترض أنها فكاهية، لكنها كانت تهدف بوضوح إلى تحقيرهم.
شكّلت الإعلانات الحديثة الناشئة آنذاك، أرضاً خصبة لهذا النوع من الصور، حيث استُغلت بكثرة في الإعلانات الصحفية، والبطاقات البريدية، وملصقات العروض المسرحية، مثل ذاك الملصق المحفوظ في مكتبة الكونغرس، الذي يعود إلى عام 1900.
وعلى مدار القرن التاسع عشر وبداية العشرين، أصبحت البطيخة في الثقافة الشعبية الأميركية رمزاً عنصرياً، يُستخدم لتكريس صورة نمطية مهينة للأفارقة الأميركيين: كُسالى، راضون بقوتهم اليومي، يضحكون ببلاهة أمام قطعة بطيخ.
هذه الصورة المكرّسة في الثقافة البيضاء، كانت تهدف إلى الحطّ من شأن السود بعد نيلهم حريتهم، وجعلهم موضوعاً للسخرية لا للتمكين.
لكن تلك الصورة انقلبت على صانعيها، حين بدأ الفنانون السود، بإعادة امتلاك البطيخة كرمز فخر وتمكين، وتحويلها إلى أداة مقاومة ضد الاستعمار الثقافي والتمييز العرقي. البطيخة هنا لم تعد أداة تهميش، بل منصّة تعبير.
اللون كهوية وطنية
في المكسيك، تبرز البطيخة كعلامة وطنية مشبعة بالدلالات الرمزية، إذ وظّفها فنانون كبار، مثل فريدا كاهلو، في لوحاتها الأخيرة مثل "عاشت الحياة"، كإعلان عن الحياة في وجه الموت الوشيك. اللون الأحمر داخل البطيخة، عند كاهلو، لا يشير فقط إلى النضج والغواية، بل أيضاً إلى الدم والمقاومة والرغبة في التمسك بالحياة رغم الألم.
كما شكّلت البطيخة، في مخيلة الفن المكسيكي، جسراً بصرياً بين الريف والتراث الشعبي وبين خطاب الهوية القومية بعد الثورة.
وفي سياق مغاير، لعبت البطيخة دوراً أكثر قرباً من الهوية الوطنية في المكسيك. فقد جسّدها الفنان روفينو تامايو في لوحته "بطيخ" كاحتفاء بالجسد المكسيكي، بالأرض والثقافة الشعبية.
بديل ذكي
في فلسطين، تجد البطيخة رمزيتها الأقصى، فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ومع تصاعد الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع رفع العلم الفلسطيني أو حتى عرض ألوانه (الأحمر، الأخضر، الأسود، والأبيض)، تحوّلت البطيخة، التي تجمع هذه الألوان مجازاً، إلى بديل ذكي للعلم. لم يكن ذلك مجرد مصادفة لونية، بل إعادة صياغة بصرية للنضال الفلسطيني ضد المحتل.
في عمله المفاهيمي "هذه ليست بطيخة"، يوظّف الفنان الفلسطيني خالد حوراني، استلهاماً من لوحة ماغريت الشهيرة "هذا ليس غليوناً"، ليعيد طرح سؤال جوهري: هل المنع يشمل الشكل أم المعنى؟ هل يكفي منع العلم إذا كان يمكن التعبير عنه ببطيخة؟
يؤكد حوراني، أنه "قدّم هذه الحيلة الفنية في حينه، كنوع من السخرية واقتراح البديل، وللتدليل على المكان الذي وصل إليه عقل الاحتلال وخياله المريض من جهة، ومن جهة ثانية للتدليل على تمسّك الفلسطينيين بعلَم بلادهم واعتزازهم به كغيرهم من الشعوب".
في المقابل، قدّمت الفنانة الأردنية سارة حتاحت، سلسلة فنية بعنوان "مقاومة البطيخ" (2021)، وظّفت فيها البطيخة كأداة احتجاج رمزية في اللوحات والمنشورات العامة، ولاقت صدىً واسعاً في الفضاءات الرقمية والشبابية.
في مكانها الصحيح
هكذا، ومن كونها رمزاً صيفياً عذباً، إلى أيقونة سياسية نضالية، تتجلى البطيخة كمثال فريد على قدرة الثقافة البصرية على قلب المعاني. إنها تذكّرنا بأن الأشياء العادية قد تحمل تحت قشرتها قوى استثنائية، وأن الرموز ليست حكراً على السلطة، بل تتخلق من فعل الحياة اليومية والمخيال الشعبي.
وفي زمن الحظر والمصادرة، لا تحتاج مقارعة المحتل دائماً إلى شعارات أو أسلحة؛ أحياناً، يكفي أن تكون البطيخة في مكانها الصحيح، لتقول ما لا يمكن قوله علناً.