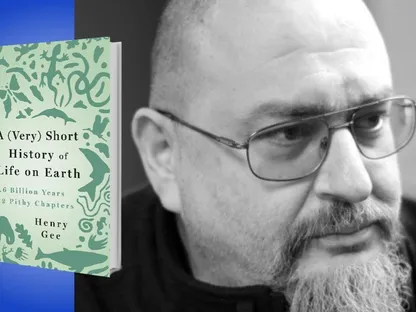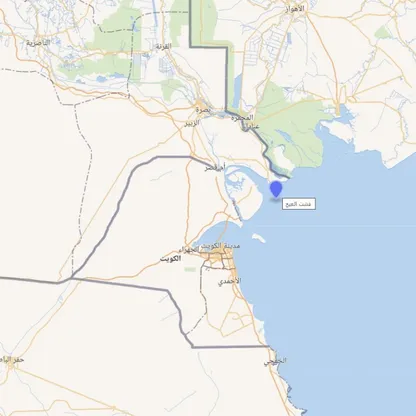الحقيقي هو الصدفة لا غير ..
كتب بول أوستر الذي رحل عن دنيانا في الثلاثين من أبريل، عن عمر ناهز 77 عاماً، حتى آخر لحظة من حياته.
أصيب الروائي الأميركي العام الماضي بمرض عضال، لم يمنعه من نشر آخر رواية له "بومغارتنر"، التي ترجمت إلى الفرنسية في فبراير 2024، واعترف في فورة إشراق ذهني، بأنها "آخر ما سيكتب".
رحل أوستر ولدى عشّاق أدبه وكتاباته وعوالمه غصّة، لأنه لم ينل جائزة نوبل للأدب، هو الذي استحقّها بالفعل. إذ كان اسمه مطروحاً منذ سنوات طويلة، لكن لجنة الجائزة في استوكهولم، اختارت أسماء أخرى في دوراتها الماضية.
قوّة الحكاية
نشر أوستر أكثر من ثلاثين كتاباً، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من أربعين لغة، ما جعله يتبوّأ الدرجة العليا في الأدب الأميركي، ووضعه إنتاجه في مصافي الكاتبَين إرنست همنغواي، وسكوت فيتزجرالد، وذلك عكس مجايليه من الكُتّاب، على الرغم من أهميتهم الأدبية الكبرى، على غرار بول روث.
تمكّن بول أوستر بأسلوبه الأدبي، أن يجعل أي قارئ يتماهى بيسر عجيب مع أجواء وشخصيات رواياته، نظراً لسلاسة السرد، وبساطة الجمل، وقوّة الحكاية التي تغتني وقائعها من بعضها البعض، بقدرة ملفتة للنظر، في الربط المنطقي الذي تعلنه، ويجعلها أشبه بالواقع.
بالنسبة له، كل حياة تتصل بالضرورة بحياة ثانية، وتلك تلامس حياة ثالثة، بشكل سريع وآني، ما يخلق تسلسلاً لا يمكن حساب حلقاته.
الصدفة لزوم السرد
الأجمل أن تلك الحيوات، تعتمد على الصدفة والحظ، كخاصّيتين سرديتين، تميّز بها بول أوستر دون غيره، لكنها الصدف المقبولة لذاتها، والحظوظ غير المتعسّفة الحضور، كما لو لم تكن صدفاً وحظوظاً.
لقد سبق أن قال في "مدينة الزجاج" (1985): "لا شيء حقيقي سوى الصدفة".
الكاتب مُحقّقاً
يكفي للوقوف على هذا الأمر، الاطلاع على ثلاثيته النيويوركية الشهيرة، تلك التي جلبت له الشهرة عالمياً: "مدينة الزجاج" (1985)، "الأشباح" (1986)، "الغرفة المغلقة" (1987).
ستكون تلك الثلاثية هي أوّل ما سيتذكره الناس إثر سماع خبر وفاته، وذلك لقوة باطنها، حيث نجد شخصياته ومنهم من يحمل اسمه ذاته، تسعى للبحث عن هويتها الخاصة على طريقة مُحقق يتحرّى في متاهة نيويورك، حيث ناطحات السحاب تبدو مثل لوحات لا نهائية من الزجاج والمرايا والأضواء، جاعلة كل شيء يظهر على غير ما هو عليه في الحقيقة.
إنها مجرد انعكاس وزيف.. فبالنسبة له، المُحقّق والكاتب يتبادلان الأدوار نفسها. لا يفعل الكاتب إلا أن يرصد آثار ما تمّ ارتكابه، كي يصل إلى الفاعل.
يرى القارئ العالم من خلال عيون المُحقّق/ الكاتب، ومن خلال تتابع هذه الآثار، بعضها إثر البعض، وهي عبارة عن كثرة التفاصيل التاريخية والاجتماعية والحياتية اليومية، وكأنه يلتقيها للمرّة الأولى.
ويمكن التأكد من ذلك أكثر، عبر قراءة رواياته "مون بالاس" (1989)، و"اختراع العزلة" (1982)، و"كتاب الأوهام" (2002) ، والروايات والكتب الأخرى.
وما استرعى انتباه قرّاءه في كل أنحاء العالم، هو أن أغلب هذه الشخصيات، إما تعيش بإحساس الغربة، أو في خضم العزلة، أو على أرصفة الهامش الحياتي، أي تعيش قدرها الوجودي باحثة عن هويتها، وباحثة عن المعنى الكامن خلف الحياة.
المدينة هي نيويورك
يقع كل هذا في ارتباط قوي بالمدينة، والمدينة لديه هي نيويورك، "جاذبية نيويورك تتجلى في الكثافة والضخامة والتعقيد. "عندما يتملكك حب هذه المدينة حدّ الشغف، فإن بقية أميركا تبدو مقذعة"، قال في حوار مع البرنامج الفرنسي "المكتبة الكبرى"، نقله موقع "فرانس إنفو".
لكن المحقّق لديه داخل هذا الفضاء المديني، لا يروم حل الحبكة في المقام الأوّل، فهي وإذ يتبدل ملمحها، كأنها تنتقل من حال إلى حال. أي تجوب آفاق ثم تعود إليها، وتغادرها مرّة ثانية في تيار سردي لولبي، بحسب الروائية الأميركية الكبيرة جويس كارول أوتس.
وهكذا فإن المحقّق في النهاية، لا يبحث عن حلّ لها في الأصل، بل عن أجوبة حول سرّ الوجود والإنسان. وبالتالي فإن تعقيد العالم، يجد بساطته التي يبحث عنها في آخر المطاف، لدى بول أوستر، فيقترب القارئ من فهمه، لكن عبر لذّة القراءة.
حكاية قلم الرصاص
لم تأت الكتابة بالنسبة لأوستر من فراغ أو من قدر مفاجئ. جاء في صحيفة لوموند نقلاً عن كتابه "لماذا الكتابة؟" (2 مايو 2024)، "أن بول أوستر الطفل، طلب من لاعب كرة شهير، وهي اللعبة التي كان يعشقها، والحاضرة في بعض رواياته، إهداءه توقيعاً بخط اليد.
لكنه لم يكن بمقدوره الحصول على قلم رصاص، الشيء الذي أحزنه وأبكاه. منذ ذلك اليوم، صار يقتني ما يكفي من أقلام الرصاص التي لا تغادر جيبه. لكن القلم، يجب أن يُستعمل لشيء ما، فكانت الكتابة، وبفضله صار كاتباً.
في الفترة نفسها، أهدته جدّته مجلدات روايات "ستفنسون"، التي حاول أن ينسج على منوالها حكايات، ولم يكد يبلغ العاشرة من العمر. ثم كتب الشعر ودبّج الصفحات تلو الصفحات بلا هوادة.
شيء ما حدث في باريس وكانت الانطلاقة
مثل جيل الكُتّاب الضائعين، على حد قول الكاتبة الأميركية جرتورد شتاين، ومن ضمنهم من ذكرناهما أعلاه، عاش بول أوستر في باريس بين سنة 1971 إلى سنة 1975. وكان قد حلّ بها بعد دراسته الجامعية للآداب الإنجليزية والايطالية والفرنسية في جامعة كولومبيا، وبعد أن توفّر لديه المال اللازم، جرّاء عمله في باخرة لنقل النفط.
هناك في غرفة خادمات، عاش رفقة زوجته الأولى الكاتبة ليديا ديفيس، التي قاسمته محنة العيش ومهنة الترجمة قبل أن يفترقا. (بعدها تزوج كاتبة أخرى سنة 1981 هي سيري هوسدفيت، قاسمته بدورها الحياة والكتابة).
في باريس قام بترجمة نتاج شعراء وكُتّاب فرنسيين كبار، وتاه في حياة وإبداعات باريس. كتبت نيويورك تايمز في مقال النعي (30 أبريل 2024):"أوّل شيء نسمعه حين نقترب من قراءة بول أوستر في كل مكان في العالم هو: الفرنسية. وإذا كان هو مجرد كاتب بسيط لدينا، فهو بمثابة نجم لموسيقى الروك في باريس".
إنها المدينة، حيث استوحى بعض مبادئ الكتابة السريالية المُتّسمة بالتداعي الحرّ للكلمات، والاعتماد على الأحلام والاستيهامات، من دون اعتناقها، حين ترجم أشعار زعيمها الأدبي أندري بروتون. وهي المدينة التي اكتشف فيها تيار ما بعد الحداثة، التي أدمجها مع خاصيات الرواية السوداء.
لكنه عندما وظّف هذه التركيبة في روايته الأولى "مدينة الزجاج"، بعد عودته إلى نيويورك، تمّ رفضها من قِبل 17 ناشراً. في حين نُشرت أول رواياته، اختراع العزلة، سنة 1982.
ومنذ ذلك الحين، لن يتوقف عن الكتابة والنشر. خاصة بعد أن ورث عن أبيه الذي لم يكن كريماً بما فيه الكفاية، مالاً جنّبه الفاقة والعمل في مجال آخر غير الكتابة. وروى هذا الأمر الأخير في أحد كتبه البيوغرافية الصريحة، التي ترجمت تحت عنوان "تباريح العيش".
تجريب في السينما
تحضر باريس في علاقة بول أوستر بالسينما، التي كانت بالنسبة له حلماً. فكتب بعض السيناريوهات، وكاد أن يدرس بالمدرسة العليا للسينما الشهيرة، المسماة حالياً "لافيميس". لكن لم يكمل مساره السينمائي بسبب خجله، كما روى للمخرج الألماني المعروف فيم فندرز، الذي كان صديقاً له.
لم يعد الكاتب الراحل إلى مجال الفن السابع إلا في التسعينيات من القرن الماضي، حين ألّف سيناريو فيلم معروف هو "Smoke" أو "الدخان"، وهو توليف حكائي جميل عن جماعة من النيويوركيين، في جلسة استرخاء وكلام في متجر تبغ، يشبهون كثيراً شخصيات رواياته من حيث التيه والقلق والهوس بالأسئلة الوجودية.
بعدها كتب وصوّر فيلم "رقصة بروكلين أو الأزرق على الوجه"، في ذات السنة وخلال بضعة أيام، لكنه خضع لتوليف دام لشهور. وكان عن حارته بروكلين. ثم أخرج "ليلي فوق الجسر" سنة 1998، عن رحلة عازف موسيقى الجاز، بعد تعرّضه لطلقة رصاص طائشة في الملهى حيث كان يعزف.
كما أخرج أوستر فيلم "الحياة الباطنية لمارتن فروست" (2006)، الذي يروي قصّة كاتب وجد ذات صباح امرأة جميلة في سريره، فحسبها عروسه.
تجربة بول أوستر في مجال السينما لم تكن بدرجة القوة إبداعياً، كما هو الأمر بالنسبة لكتاباته، على الرغم من جاذبيتها ونغمة الحنين التي تخصّها. اعتبرت تجريبية ومكمّلة لمشواره الأدبي المتميّز، وتدور في فلكه، موظّفة الصورة واللغة السينمائية بدل الكلمات والسرد الأدبي.
الكتابة وعضلات الأصابع
بول أوستر كاتب توفّرت لديه خاصية الإمتاع والتشويق الأدبي، من دون توخي السهولة واليسر كما في الحكي المتسلسل الواضح.
نفهم بعض أسباب ذلك إذا ما عرفنا بأنه يكتب بيده، ليقوّي عضلات أصابعه كما يقول، ولأنه يشعر بالكلمات تخرج من جسده، قبل أن يقوم بكتابتها على الصفحة البيضاء. "كانت الكتابة دائماً تتمتع بهذه الجودة الملموسة بالنسبة لي. هي تجربة جسدية"، يقول في مقال لـ "نيويورك تايمز".