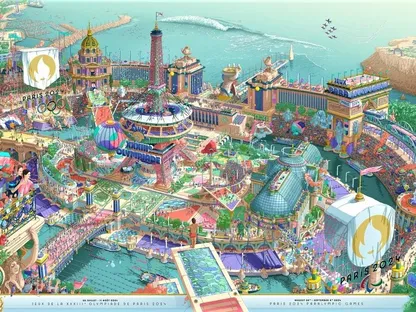يقول إيمانويل كوكسيا، الفيلسوف من أصول إيطالية: "لا نبني بيوتاً من أجل حماية أنفسنا من العوامل الجوية، ولا من أجل أن نوفّق بين الحيّز المكاني وذوقنا الجمالي، نبني البيوت كي نستقبل جزءاً من العالم، وكل بيت هو واقع أخلاقي".
وتقول الشاعرة الروسية مارينا تسفتايفا: "أولئك الذين لم يبتنوا بيتاً، لا يستطيعون العودة إلى التراب".
لا يُعدّ البيت أول مسعى أنثروبولوجي مَديني لاستقرار الإنسان فحسب، بل يشمل الموجودات الحيّة كلها، فالتربة هي بيت الأشجار والنباتات، كما البحر هو بيت الأسماك، والفضاء هو بيت الطيور.
"الشرق" زارت بعض بيوت الأدباء الفرنسيين في باريس، وتعرّفت إلى أماكنهم الأكثر خصوصية، وأين عاشوا، وكيف كتبوا.
فيكتور هوجو: فخامة العيش
عاش فيكتور هوجو في الطابق الثاني من مبنى 6 في ساحة "فوساج"، "الملوك" سابقاً، في منطقة تاريخية تشتهر بجمالها المعماري الفريد، وذلك بين 1832و 1848.
هناك كتب أشعاره ومسرحياته، تعبيراً عن الأدب الثوري الرومانسي حينذاك، رمزاً للاشتراكية والتمرّد والانفتاح، بعد أن كان عضواً مُحافظاً في البرلمان الفرنسي.
كتبَ هوجو في بيته جزءاً كبيراً من روايته "البؤساء" (تحوّلت إلى فيلم شهير بشخصية جان فالجان)، كما أنجز روايته الشهيرة التي أثّرت في الأدب الفرنسي خاصة والعالمي عموماً "أحدب نوتردام"، صدرت عام 1831، مستعرضاً مآثر كاتدرائية نوتردام الشهيرة وسط باريس.
استقبل في ذلك البيت ذي الطراز المعماري الذي يشي بذوقه الرفيع، شخصيات أدبية مهمة مثل لامارتين، ألفريد دي فيني، ألكسندر دوما وبلزاك.
تصميم المنزل
يتميّز منزل هوجو بتصاميمه التي تعكس شخصيته وذوقه الفني الخاص، وهو اشتهر بجمع اللوحات والعناية بالتحف الثمينة. يتألف المنزل من غرف كثيرة مزيّنة بأثاث، يعود إلى القرن التاسع عشر، فضلاً عن مقتنياته الشخصية مثل مكتبه وأقلامه ورسوماته.
يحتوي المنزل على بعض اللوحات الفنية التي جمعها هوجو أو أهديت له، وكذلك على صفّ من أواني السيراميك الصينية الجميلة، ما يعطي غرفة المعيشة طرازاً صينياً فريداً، إذ عاش في المنفى 15 عاماً.
تحوّل البيت بعد وفاته عام 1903 إلى متحف يضمّ مجموعة كبيرة من المخطوطات الأصلية، والرسائل، والرسومات، والصور الفوتوغرافية، فضلاً عن الأعمال الورقية وأخرى جرافيكية، فالكاتب كان رمزاً وطنياً وتاريخياً تفتخر به فرنسا، وهو القائل: "أنا ألبست الأدب الفرنسي قبّعة الجمال".
يكتب واقفاً
عُرف هوجو بعاداته الغريبة في الكتابة، ويُقال إنه كان يكتب واقفاً، مستعملاً طاولة مرتفعة تحاكي جسده الضخم، لدرء الملل والخضوع تحت طائلة الجلوس الطويل، تحفيزاً للإبداع والتحرّر من عادات الكتابة التقليدية، لكنه كان يحتفظ بكرسي وطاولة للكتابة عند الحاجة. إنها طريقة غير شائعة لدى الأدباء.
بلزاك والحي اللاتيني
يقع المنزل في حي "سان جرمان" المجاور للحي اللاتيني وسط باريس. هناك عاش الكاتب وشهد تأسيس مقاهٍ أدبية، كما وصفت رواية "الحي اللاتيني" للكاتب المصري يوسف إدريس المنطقة نفسها.
اشتهر بلزاك بالمواظبة على الكتابة وفق برنامج صارم، أتاح له كتابة "الكوميديا الإنسانية"، ورواية "المرأة المهجورة"، و"الأوهام الضائعة"، فضلاً عن الدراسة النفسية لأوضاع المرأة "العذراء القاتلة".
يتألف البيت ذي الطابع الباريسي الفخم من غرف ضيقة وحديقة، وتمّ تزيينه بلوحات من الفن الكلاسيكي، عاش فيه متخفّياً عن دائنيه، جاعلاً منه ملاذاً اجتماعياً وأدبياً.
15 ساعة من الكتابة
كان يكتب على طاولة خشبية لساعات طويلة، تصل إلى 15 ساعة ليلاً حتى الصباح، مستهلكاً القهوة بشكل غزير، كي يبقى محافظاً على وعيه.
اشتهر بردائه الأبيض للكتابة، كما استقبل فيه الشاعر بودلير، وألكسندر دوما، والكاتبة جورج صاند، ولامارتين، وهوجو، والروائي ستاندال.
بيت الشاعر مالارميه: نهر السين أدبياً
يقع في منطقة ريفية هادئة في "فونتن بلو"، بالقرب من نهر السين، حيث قصر نابليون بونابرت (عاش فيه بعض من ملوك فرنسا، لكن نابليون قام بتوسيعه، فاشتهر باسمه).
عاش مالارميه شاعر الرمزية في آواخر حياته في هذا البيت الذي تحوّل إلى متحف، وكتب هناك قصيدته المشهورة "رمية نرد"، وجمع قصائده الآخرى، يسمح للزوّار بمعاينة مقتنيات الشاعر الشخصية، بما في ذلك أثاثه الأصلي؛ كتبه، ومجموعة من المخطوطات والأعمال الفنية، فضلاً عن لوحات كلاسيكية وبورتريهات شخصية ورسائل أدبية، فهو ارتبط بصداقات كثيرة مع أدباء فرنسا.
اشتهر الشاعر مالارميه بكرمه وضيافته وهو الشخصية الرفيعة في الأدب الفرنسي والعالمي، وكان يستقبل في بيته الشاعر بول فاليري، وفرلين، والناقد أندريه جيد، وأناتولي فرانس، وبروست.
العيش في مكتبة
يمكن استشراف فكرة عن طريق كتابة الأدباء وأسلوب حياتهم من خلال التمعّن في بيوتهم، إذ اتسم كل من هوجو وبلزاك ومالارميه، بالانضباط الشديد في الكتابة، من خلال جدول يومي صارم لم يحيدوا عنه، وبعادات كتابية تختلف في ما بينها، وبأسلوب عيش متقشّف وزاهد، ما عدا فيكتور هوجو، الذي اشتهر بفخامة وأرستقراطية عيشه.
يعني بيت الكاتب، مكتبه وصالة استقباله للضيوف، التي يوليهما عناية فائقة جداً، تفوق أحياناً غرفة النوم؛ هكذا، نلاحظ اهتمام الكُتّاب الفرنسيين بطاولة الكتابة، وأقلام الحبر والعناية بوجود مكتبة كبيرة، وجمع اللوحات والمقتنيات الشخصية والهدايا، فضلاً عن إنارة مكتبية، هي مزيج من استعمال الشموع والقناديل.
بيوت الكُتّاب العرب
تعتبر الدول كُتّابها تراثاً وطنياً وحضارياً باقياً ومستمراً أكثر من تراث رجال السياسة، فهم الأبقى ولا خلاف عليهم بتاتاً.
في أثناء انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، تمّ سحل تمثال لينين وماركس، بينما لم يعتدِ أي شخص على تمثال بوشكين وغوركي، وماياكوفسكي شاعر الثورة الاشتراكية؛ إذ ما يزال الروس، يتعارفون في محطته، ثم يتزوجون تحت تمثال بوشكين.
في الوقت الذي لا نرى فيه اهتماماً ببيوت الفنانين والأدباء العرب من قِبل دولهم بشكل خاص، باستثناء حالات قليلة. كما نلاحظ، أن الأديب في عالمنا العربي، بالكاد يدبّر عيشه، فكيف يستطيع الاهتمام بتاسيس بيت يتفق مع شخصيته وطموحاته الأدبية والفنية؟
والأنكى هو لجوء الكاتب العربي إلى المنافي قسرياً، والتنقّل بين بلد وآخر، لكن هذا، لا يمنع الاهتمام ببيوت الفنانين والأدباء العرب، وتحويلها إلى متاحف ومؤسسات.
المنفى بيتاً للكاتب العربي
احتاج الشاعر محمود درويش إلى سردية المنفى العربي، وهو يقول: "علاقتي القوية بالبيت نَمت في المنفى أو في الشتات".
عندما تكون في بيتك لا تمجّد البيت ولا تشعر بأهميته وحميميته، لكن عندما تُحرم منه يتحوّل إلى صبابة ومشتهى، وكأنه هو الغاية القصوى من الرحلة كلها.
المنفى هو الذي عمّق مفهوم البيت والوطن، كون المنفى نقيضاً لهما. البيت هو الوصول إلى "إيثاكا" كما يقول الشاعر كافافيس.
هكذا، يتمّ الربط (مشرقياً) ما بين الوطن والبيت، المنفى والبيت، بينما هناك مسافة (ربما) لدى الكاتب الغربي ما بين الوطن والبيت.