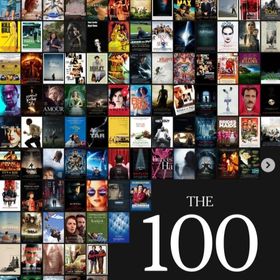لعل التاريخ لم يشهد على سر معروف للعالم، مثل سر امتلاك إسرائيل لسلاح نووي، فعلى الرغم من السرية والتكتم الشديدين اللذين تحيط بهما تل أبيب تفاصيل برنامجها النووي العسكري، إلا أن الشك لا يساور أحداً من المراقبين بشأن امتلاكها ترسانة نووية يُختلف على حجمها، ولا يُختلف على وجودها.
وعلى الرغم من حرص المسؤولين الإسرائيليين على عدم ذكر أي إشارة في أحاديثهم على مر الحكومات المتعاقبة منذ قيام إسرائيل قبل 75 عاماً بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي أو ترسانة الأسلحة النووية، إلا أن وزير التراث عميخاي إلياهو، وقع أخيراً، في خطأ لا يُعرف إن كان عفوياً أم مقصوداً، عندما دعا إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية.
وبغض النظر عن ردود الأفعال الصاخبة داخل إسرائيل نفسها، وفي العالم العربي، ودول عدة حول العالم، إلى جانب المنظمات الدولية، المستهجنة لتصريحات إلياهو، إلا أن حديثه أعاد إلى الواجهة قضية البرنامج النووي الإسرائيلي، الشبيه بـ"شبح ضخم هلامي الملامح"، لا يُرى بوضوح، ولكن حضوره محسوس على الدوام.
برنامج إسرائيل النووي
وبحسب مؤسسة التراث الذري، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، فبعد إعلان قيام إسرائيل في مايو عام 1948، لم يضع رئيس حكومتها الأول ديفيد بن جوريون وقتاً طويلاً قبل أن يوجه بتطوير برنامج نووي، وفي العام التالي أجرى الجيش الإسرائيلي مسحاً جيولوجياً لصحراء النقب، حيث عثر على نسبة من اليورانيوم في مناجم الفوسفات.
كما اهتم بن جوريون باستقطاب علماء للإشراف على البرنامج النووي الإسرائيلي الوليد آنذاك، ووقع اختياره على الكيميائي ذي الأصول الألمانية إرنست ديفيد بيرجمان، ليرأس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية عام 1952، كما ترأس إدارة البحث والبنية التحتية التابعة لوزارة الدفاع، والتي تحولت عام 1985 إلى هيئة تطوير التسليح "RAFAEL" وكُلفت بتصنيع قنبلة نووية.
ومع ذلك، لم يكن بيرجمان هو القائد الفعلي للبرنامج النووي الإسرائيلي، إذ وقعت تلك المهمة اعتباراً من عام 1955 على عاتق مدير وزارة الدفاع آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عقود، شمعون بيريز، الذي كان موضع ثقة كبيرة لبن جوريون، ليشكل الرجال الثلاثة، الإدارة العليا للبرنامج النووي الإسرائيلي خلال سنواته الأولى.
ما دور فرنسا في دعم تل أبيب نووياً؟
وكانت الحكومة الإسرائيلية حينها، تُدرك جيداً حاجتها إلى مساعدة خارجية للحصول على قنبلة نووية، ففي عام 1955 وافقت الولايات المتحدة على بيع مفاعل أبحاث تحت رعاية برنامج "الذرة من أجل السلام" إلى تل أبيب، وهو المفاعل نفسه، الذي حصلت عليه إيران، عبر مساعدة واشنطن، لبرنامجها النووي في الفترة ذاتها.
وعلى الرغم من أنه لم يكن مسموحاً لإسرائيل بموجب اتفاق البيع، إنتاج عنصر البلوتونيوم، إلا أن تقريراً سرياً لبيرجمان كشف لاحقاً نية تل أبيب تحويل مفاعل الأبحاث الأميركي كنواة لمجمع أبحاث نووية أكبر.
وذكر خطاب لمسؤولي مشروع الأبحاث النووية عام 1956 عن "تحديث" مفاعل الأبحاث الأميركي، من أجل "اكتساب خبرة أكثر تقدماً في فصل البلوتونيوم"، وفقاً لـ"مؤسسة التراث الذري".
وكان من الواضح أن هذه المساعدة الأميركية المحدودة لن تكون كافية لتطوير برنامج نووي ذي شأن، وسرعان ما طُرحت فرنسا بوصفها الحليف الأقدر على "مد يد المساعدة"، إذ أمن بيريز الحصول على دعم باريس للبرنامج النووي الإسرائيلي، على الرغم من أن برنامج فرنسا النووي نفسه كان لا يزال في طور تشييد شبكة مترامية الأطراف من المفاعلات النووية في أنحاء البلاد.
ويتذكر الكيميائي برتران جولدشميدت، وهو الفرنسي الوحيد الذي عمل في "مشروع مانهاتن" لإنتاج أول قنبلة نووية أميركية، اجتماعاً سرياً عُقد في سبتمبر 1956 بين ممثلي الحكومتين الفرنسية والإسرائيلية، اتفقوا خلاله على "توسيع القدرات النووية الإسرائيلية"، على أن يظل الأمر سراً محصوراً على أضيق نطاق بين المسؤولين المعنيين، إذ لم تشأ باريس إثارة مشاعر عدائية تجاهها في العالم العربي، كما خشي الطرفان أن تتحفظ واشنطن، وتفرض قيوداً على البرنامج النووي الإسرائيلي، تغليباً لاعتبارات منع الانتشار النووي.
وبعد شهر واحد من هذا الاجتماع، شنت بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل، "العدوان الثلاثي" على مصر رداً على قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وفيما أجبرت واشنطن "قوى العدوان" على إنهاء الحرب والانسحاب من شبه جزيرة سيناء، إلا أن تلك الحرب أعطت دفعة قوية للتعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي، وساهمت في رفع مستوى الدعم المقدم للبرنامج النووي الإسرائيلي من باريس.
وشرعت فرنسا عام 1957 ببناء مفاعل نووي بطاقة 24 ميجاواط لإسرائيل، واشترت تل أبيب من النرويج 20 طناً من الماء الثقيل اللازم لسلسلة التفاعلات النووية، كما ساعد مهندسون فرنسيون في تشييد منشأة النقب للأبحاث النووية قرب ديمونة في صحراء النقب.
وبحلول نهاية الخمسينيات كان هناك نحو 2500 فرنسي يعملون في تخصصات مختلفة يقيمون سراً في ديمونة، وكان محظوراً عليهم مراسلة أقربائهم ومعارفهم مباشرة، إذ كان بريدهم يُرسل إلى عنوان بريدي وهمي في أميركا اللاتينية.
ويُعتقد أن المساعدة الفرنسية للبرنامج النووي الإسرائيلي مضت إلى ما هو أبعد من تطوير الطاقة النووية، فيقول المؤرخ الإسرائيلي آفنر كوهين إن هناك قرائن تشير إلى حضور علماء إسرائيليين أول تجربة فرنسية لتفجير قنبلة ذرية، في منطقة صحراوية جنوب غربي الجزائر عام 1960، على الرغم من عدم ثبوت حضور علماء إسرائيليين هذه التجربة بشكل قطعي، وفقاً لـ"مؤسسة التراث الذري".
شكوك أميركية
ولم تخطئ التوقعات الأميركية التعاون النووي الخفي بين إسرائيل وفرنسا، على الرغم من إنكار باريس المتكرر. وفي عام 1958 رصدت أقمار اصطناعية أميركية للمرة الأولى مجمع ديمونا النووي، وانتابت الاستخبارات الأميركية شكوكاً بشأن شروع تل أبيب في تطوير برنامج نووي عسكري، إذ جاء في تقرير لـ CIA عام 1960 أن "الغموض والسرية اللذين يلفان ما يجري (في منشأة ديمونة) ينبئان بأنها مخصصة جزئياً على الأقل لإنتاج البلوتونيوم على مستوى عسكري".
وعلى الرغم من هذه الشكوك، لم تبدأ الولايات المتحدة ممارسة ضغوط جدية لمنع إسرائيل من تطوير أسلحة نووية سوى بعد تولي الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي رئاسة البلاد عام 1961، إذ خشيت واشنطن من أن يخل حصول تل أبيب على أسلحة نووية بتوازن القوى في الشرق الأوسط، على نحو يدفع الدول العربية للاصطفاف مع الاتحاد السوفيتي في "الحرب الباردة".
وفي لقاء جمع بن جوريون وكينيدي في مايو 1961 بمانهاتن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأميركي أنه "لا نية لدى إسرائيل لتطوير قدرات نووية عسكرية"، حسبما ذكرت "مؤسسة التراث الذري".
ومن أجل طمأنة المخاوف الأميركية، وافقت إسرائيل على السماح لمفتشين أميركيين بزيارة المنشآت النووية، وفي ذات الشهر الذي انعقد فيه لقاء كينيدي وبن جوريون، أوفدت هيئة الطاقة الذرية الأميركية أول بعثة مفتشين إلى ديمونة، والتي خلصت إلى أن "الغرض من المجمع النووي، هو اكتساب الخبرة في تشييد المنشآت النووية لتهيئة الإسرائيليين للحصول على الطاقة النووية على المدى الطويل".
مجمع ديمونا النووي
وأبدى أعضاء البعثة الأميركية ارتياحهم بعد عمليات التفتيش، معتبرين أن الإسرائيليين لم يخفوا عليهم شيئاً، وأن مجمع ديمونا النووي ذو طابع سلمي، كما أكد ممثلو الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة.
وعلى المنوال ذاته، خلصت بعثة تفتيش أميركية ثانية في سبتمبر 1962 إلى أن "ديمونة" لا يضم سوى مفاعل أبحاث، لا يملك القدرة على إنتاج البلوتونيوم لأغراض عسكرية.
وبدت واشنطن حينها راضية عن نتائج بعثات التفتيش، ومع ذلك حذّرت تقارير أخرى من أن عمليات التفتيش "لم تكن سوى أضحوكة"، إذ لم يُسمح للمفتشين باستخدام معداتهم الخاصة أو جمع عينات.
كما لاحظ أحد المفتشين وجود بعض الجدران في مجمع ديمونا بدت وكأنها حديثة الإنشاء والطلاء، ولكن بغض النظر عن كيفية إجراء التفتيش، فقد بات من الواضح الآن أن الولايات المتحدة تعرضت لخداع كبير بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي في ذلك الوقت، وفقاً لـ"مؤسسة التراث الذري".
ولم تخل أولى خُطى البرنامج النووي الإسرائيلي من عثرات خطيرة هددت بفشله في المهد، ولا سيما مع وصول شارل ديجول إلى الرئاسة الفرنسية عام 1958، وتحفظه على التعاون النووي مع إسرائيل، الأمر الذي دفع الأخيرة للبحث عن شركاء آخرين.
وقاد تل أبيب البحث عام 1963 إلى إبرام اتفاق مع الأرجنتين لشراء 100 طن من اليورانيوم الخام، المعروف أيضاً باسم "الكعكة الصفراء"، ولكن الاستخبارات الكندية كشفت للولايات المتحدة أمر هذه الصفقة عام 1964، ومع ذلك راوغ المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الأميركيين، ولم يقدموا أي إجابات شافية بشأن مدى التقدم الذي أحرزه البرنامج النووي الإسرائيلي.
وخلص تقرير صادر عن مكتب الاستخبارات الأميركية عام 1964 إلى تقييم خاطئ بشأن عدم قدرة إسرائيل على تطوير برنامج أسلحة نووية، لعدم امتلاكها منشأة لفصل البلوتونيوم.
وبالنظر إلى سرية الأرشيف النووي الإسرائيلي، يستحيل تحديد التاريخ الدقيق الذي حصلت فيه إسرائيل على أول سلاح نووي إسرائيلي، وإن كان يُعتقد أنه في وقت ما بين عامي 1965 و1968، ويُرجح بتحديد أكبر أنه كان في عام 1967.
وأصبح المسؤولون الأميركيون بحلول عام 1969 موقنين بأن البرنامج النووي الإسرائيلي وصل إلى درجة من التقدم، بحيث بات لدى تل أبيب جميع المكونات اللازمة لإنتاج سلاح نووي، ولم يبق سوى خطوة تجميع هذه المكونات واختبار سلاح نووي، الأمر الذي أوقع واشنطن في حرج كبير، بوقت كانت تضغط فيه على دول العالم للتوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وكانت إسرائيل بطبيعة الحال مترددة بشأن التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والتي كان من شأنها أن تلزمها بالتعهد بعدم تطوير أسلحة نووية، كما لم تشأ حكومة تل أبيب في إذاعة سر برنامجها النووي لئلا يطلق شرارة سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقبل لقاء جمع الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون، ورئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير، في البيت الأبيض في 26 سبتمبر 1969، أبلغت الخارجية الأميركية، نيكسون بأن "إسرائيل ربما تكون لديها قنبلة نووية الآن"، أو على الأقل "لديها المقدرة الفنية، والموارد المادية اللازمة لإنتاج اليورانيوم اللازم لصنع عدد من القنابل".
وعلى الرغم من أن محضر لقاء نيكسون ومائير لا يزال خاضعاً للسرية، يُعتقد على نطاق واسع أنهما توصلا إلى تفاهم ما بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، وفق "مؤسسة التراث الذري".
ويشرح المؤرخ آفنر كوهين أن الخطوط العريضة لهذا التفاهم تضمنت أن تمتنع إسرائيل عن إجراء أي تجارب نووية، وألا تعلن رسمياً عن برنامجها، أو تتحدث عنه في محافل علنية، وبالمقابل تغض واشنطن الطرف عن برنامج تل أبيب النووي، وتكف عن الضغط عليها لتوقيع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
حرب 1967 والاستعراض النووي
على الرغم من أن إسرائيل لم تعترف قط بوجود برنامجها النووي، تكهن بعض المراقبين بأن تل أبيب فكرت في إجراء اختبار نووي إبان حرب يونيو 1967. ويقدّر كوهين أنها شرعت في تجميع مكونات سلاح نووي عشية الحرب، وتوصلت إلى قرار باستخدامه كحل أخير في حال لم تسر مجريات الحرب في صالحها، وهو ما لم يحدث.
ودرست إسرائيل، مرة أخرى، إجراء اختبار نووي إبان حرب أكتوبر 1973، إذ اجتمعت مائير في 7 أكتوبر مع مسؤولين كبار بالحكومة والجيش، واقترح وزير الدفاع حينها، موشي ديان القيام بـ"استعراض نووي" ضد مصر وسوريا، ولكن اقتراحه قوبل بالرفض من مائير.
وحتى الآن، وعلى عكس جميع القوى النووية الأخرى، لم تجر إسرائيل أي اختبار نووي، أو بعبارة أدق لم تجر أي اختبار نووي معروف، لأن ثمة تكهنات بأن وميضاً مزدوجاً رصده القمر الاصطناعي الأميركي Vela Hotel في 22 سبتمبر 1979 على مقربة من جزر الأمير إدوارد في المحيط الهندي قبالة سواحل جنوب إفريقيا، في ما عُرف بـ"حادث فيلا"، كان ناجماً عن اختبار نووي مشترك بين تل أبيب وبريتوريا، إذ قدمت إسرائيل خلال السبعينيات مساعدة فنية للبرنامج النووي الجنوب إفريقي، مقابل شحنات من اليورانيوم الخام.
وآنذاك، تلقى رئيس اللجنة الفرعية للطاقة والانتشار النووي بمجلس الشيوخ الأميركي، ليونارد ويس، تحذيراً من الحديث علناً عن "حادث فيلا"، لأن انكشافه كان من شأنه التسبب بحرج كبير للولايات المتحدة وأزمة في سياستها الخارجية.
سياسة "الغموض النووي"
ولطالما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي"، فارضة طوقاً من السرية على برنامجها، الذي لم تعترف به رسمياً قط، ولا تسمح لأي من المطلعين على تفاصيله بالحديث عنه، وتحتفظ بسجلات هيئة الطاقة الذرية طي الكتمان، ولا تفرج عن أي وثائق أرشيفية حكومية تخص برنامجها النووي.
وذكر كوهين في مقال على موقع أرشيف الأمن القومي التابع لجامعة جورج واشنطن الأميركية، أن سياسة الغموض النووي الإسرائيلي (عميموت - وهي كلمة عبرية تعني التعتيم) عبارة عن جهد مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ تلعب الأخيرة دور الوصي والحامي للبرنامج النووي الإسرائيلي وسريته.
وأشار المؤرخ الإسرائيلي إلى أن واشنطن التي تُعد أرشيفاتها ووثائقها التاريخية المفرج عنها باباً خلفياً للاطلاع على أرشيفات ووثائق دول أخرى، تتعامل مع ملفات البرنامج النووي الإسرائيلي بـ"حرص شديد"، فلا ترفع السرية عن أي مادة تشير إلى معرفة أميركا الفعلية بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، ويبدو أن دولاً أخرى على صلة ببرنامج إسرائيل النووي، مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، تتبع سياسة مماثلة.
ومع ذلك، فنظراً لحضور الولايات المتحدة القوي في البرنامج النووي الإسرائيلي، لم يكن ممكناً أن يكون الدور الأميركي في هذا الملف صندوقاً أسود محكم الإغلاق بالكامل، فبعض تقارير الاستخبارات والمذكرات المرفوعة إلى المسؤولين المعنيين تُرفع عنها السرية بموجب قوانين حرية المعلومات، وهي وإن كانت لا تتضمن عبارات صريحة أو معلومات تفصيلية عن البرنامج النووي الإسرائيلي والدور الأميركي فيه، فإنها تشتمل على إشارات متناثرة يشكل جمعها معاً دخاناً يشي بوجود نار ما.
ويجادل كوهين في كتابه "السر الأسوأ: صفقة إسرائيل مع القنبلة" على موقع الرابطة الأميركية للحد من التسلح، بأن سياسة التعتيم لا تهدف إلى فرض سرية مطلقة على البرنامج الإسرائيلي، بقدر ما تهدف إلى خلق تأثير رادع، مع الاحتفاظ بهامش حركة للإنكار والتملص، لكن لئن كانت هذه السياسة فعالة في مرحلة تاريخية معينة، فهي الآن قد عفا عليها الزمن، وأمست محرجة أكثر من كونها ناجحة، لأن امتلاك إسرائيل أسلحة نووية لم يعد سراً ببساطة، حتى وإن لم تتكشف ملامح البرنامج النووي الإسرائيلي بالتفصيل.
وأوضح أن تفاهم نيكسون ومائير المشار إليه آنفاً هو حجر الزاوية الحاكم، ودليل الإرشادات المتبع لدى الرؤساء الأميركيين المتعاقبين، في ما يتعلق بما يسميه المؤرخ الإسرائيلي "صفقة القنبلة النووية"، أي "ما يكفي من الأدلة ذات المصداقية لردع الأعداء، وما يكفي من الغموض وقلة المعلومات للسماح للأصدقاء بغض الطرف".
وطوال العقود الماضية، التزمت إسرائيل بسياسة التعتيم وتفاهم نيكسون ومائير، حتى إنها في أحلك لحظات الخطر مثل حرب أكتوبر 1973 امتنعت عن تهديد مصر أو سوريا صراحة باستخدام السلاح النووي.
بل إن كوهين ومؤرخين آخرين يذهبون إلى أن المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي لم يفكر قط خلال الحرب باستخدام سلاح نووي، وإن رفع حالة تأهب صواريخ "أريحا" الحاملة لرؤوس نووية، رداً على رفع حالة تأهب صواريخ "سكود" سوفيتية الصنع في مصر، كان غرضه بالأساس تخويف الولايات المتحدة لدفعها إلى مد جسر جوي لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من الأسلحة والذخائر التقليدية، في سبيل طمأنتها وثنيها عن استخدام أسلحة نووية.
وينبش كوهين في كتابه كومة صغيرة للغاية من المعلومات المتوافرة عن هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية، التي يصفها بالوكالة الحكومية الأكثر سرية، ومكتب الأمن التابع لوزارة الدفاع، ويُعد أكثر إداراتها سرية أيضاً، والمسؤول عن حماية سرية البرنامج النووي، ومكتب الرقيب العسكري المسؤول عن محاصرة التناول الإعلامي للمعلومات الحساسة.
وأشار إلى أن الكنيست (البرلمان) لم يطرح البرنامج النووي الإسرائيلي قط للمناقشة والمراجعة، ويُعد رئيس الوزراء الإسرائيلي هو المرجعية العليا والنهائية في القرار النووي، بما في ذلك تعيين كبار المسؤولين عن الملف النووي.
ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تكشف أي تفاصيل عن حدود التخصصات، أو سلسلة القيادة النووية، أو عقيدة استخدام الأسلحة النووية، أو ضمانات منع الاستخدام غير المصرح به، أو منع تسريب الأسلحة أو المواد النووية.
ومع ذلك، يعترف كوهين بأن سياسة التعتيم لم تلحق الضرر بإسرائيل، فهي ساهمت في بناء الردع وإتاحة حرية الحركة لتطوير برنامجها النووي، والحفاظ على الولايات المتحدة كشريك ضمني، والتحرر من أي قيود تفرضها معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبعبارة أخرى يقول كوهين إن "سياسة (عميموت) سمحت لإسرائيل بالعيش في أفضل العوالم الممكنة، من خلال امتلاك القنبلة النووية دون الاضطرار إلى تحمل العديد من العواقب السلبية المترتبة على ذلك".
كشف المستور
لئن أفلحت سياسة التعتيم على البرنامج النووي الإسرائيلي في خلق تأثير رادع، فإن غرضها الأساسي المتعلق بصيانة سرية البرنامج النووي الإسرائيلي تلقى ضربة قاصمة من الداخل، ضربة عنوانها اسم لا يزال يتردد في إسرائيل، ويندر من يتحدث عنه بحياد وموضوعية، ذلك هو موردخاي فعنونو.
وموردخاي فعنونو، هو يهودي مغربي من مواليد مدينة مراكش عام 1954، هاجرت عائلته إلى إسرائيل عام 1963، وفي عام 1976 تسلم عمله كفني في مفاعل ديمونا النووي، واستمر به حتى عام 1985، عندما تقرر تصنيفه كعمالة زائدة وتسريحه من العمل.
وإلى جانب عمله في مفاعل ديمونا، درس فعنونو الفلسفة في جامعة بن جوريون، وبدأ يشعر بالاستياء حيال بعض سياسات الحكومة الإسرائيلية، ولفت أنظار السلطات إليه عندما شرع مع طلاب جامعيين يهود وعرب بتشكيل حركة داعية للسلام ومتعاطفة مع الفلسطينيين، كانت تصنف باعتبارها حركة "متطرفة" من منظور حكومة تل أبيب، وكان ذلك هو الوقت الذي انتابت فعنونو فيه "أزمة ضمير"، تتعلق بعمله في مفاعل ديمونة الذي كان ينتج أسلحة نووية سراً.
وبدأ فعنونو بالتقاط صور لمفاعل ديمونة، دون أن يستقر على ما ينوي فعله بها، وبعد تسريحه عام 1985، قضى وقتاً في السفر والتجول حول العالم، ثم استقر به المقام في أستراليا، وعمل في مهن متواضعة، وهناك قرر اعتناق الدين المسيحي على المذهب الأنجليكاني، وعُمِّد عام 1986، ولكن الأهم أنه بدأ خلال جلساته مع معارفه الجدد في الكنيسة الإفصاح عن بعض التفاصيل التي عرفها إبان عمله بمفاعل ديمونة، وكان من بين معارفه الجدد هؤلاء صحافي كولومبي يُدعى أوسكار جيريرو، شجعه على كشف كل ما لديه من أسرار.
وتواصل فعنونو مع عدد من الصحف الأسترالية، لم يجد لدى أي منها أذناً صاغية، ثم تواصل مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، التي كلفت الصحافي الاستقصائي بيتر هونام وفريقه بالتحري عن الأمر، وتم الاتفاق مع فعنونو على أن يتوجه إلى لندن، حيث أمكن ترتيب لقاءات له مع بعض العلماء النوويين الناشطين في حركات السلام، وأدلى بكل ما لديه من معلومات وصور.
ونشر هونام تحقيقه بصحيفة "صنداي تايمز" في 5 أكتوبر 1986، والذي كان بمثابة فضيحة مدوية لإسرائيل، ولكن فعنونو كان قد اختفى قبل نشر التحقيق، ففي تلك الفترة انتابه شعور بالتململ والاستياء بسبب التأخر في نشر التحقيق، وفي هذا الوقت بالتحديد تعرف على امرأة تُدعى سيندي قدمت نفسها له بوصفها سائحة أميركية.
ورغم نصيحة هونام، لفعنونو بأخذ الحذر من سيندي، إلا أنه قد وقع تحت تأثيرها إلى حد كبير، ووافق على اقتراحها بقضاء عطلة معاً في روما، وهناك اختطفه عملاء للاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، وخدروه وهربوه على متن سفينة إلى إسرائيل، حيث أدين بتهمة الخيانة والتجسس في محكمة سرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 عاماً، قضى معظمها في سجن انفرادي، قبل أن يُسمح له بالاختلاط مع سجناء آخرين، وأُطلق سراحه في 21 أبريل 2004، وعاش بعدها تحت رقابة وقيود صارمة قُبض عليه أكثر من مرة لمخالفتها.
كم عدد الرؤوس النووية لدى إسرائيل؟
وبحسب مركز الحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، يُعتقد أن إسرائيل تمتلك 90 رأساً حربياً نووياً صنعتها من البلوتونيوم، إلى جانب أنها أنتجت ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 إلى 200 سلاح نووي، وفي حين يشكل مخزون بهذا الحجم حداً أدنى من الردع، فإن عدم وجود برنامج مخصص لاختبار هذه الأسلحة قد يثير مخاوف بشأن فعاليتها.
ويقول المركز في تقريره، إن مخزون المواد الانشطارية الصالحة لصنع الأسلحة النووية داخل إسرائيل جاء من مصدرين، الأول هو مجمع الأبحاث النووية في ديمونة بصحراء النقب، حيث جرى هناك إنتاج البلوتونيوم المخصص لبرنامج الأسلحة النووية.
ولا يخضع مجمع ديمونة النووي لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما لا يُسمح لمفتشيها بالذهاب إلى هناك، بينما قدرت دراسة غير سرية أُعدت لصالح الكونجرس الأميركي عام 1980، أن مفاعل ديمونة النووي قادر على إنتاج من 9 إلى 10 كيلوجرامات من البلوتونيوم الانشطاري سنوياً بدءاً من عام 1965.
أما عن المصدر الثاني للمواد الانشطارية، فتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن تل أبيب تمكنت من نقل 300 كيلوجرام من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة النووية من مصنع لتصنيع وقود مفاعل الدفع البحري الأميركي في أواخر الستينيات، وبالتالي كان بوسع إسرائيل تخزين هذه الكميات لاستخدامها في صنع الأسلحة النووية، أو حتى خلطها باليورانيوم الطبيعي واستخدامها في مفاعل ديمونة النووي لإنتاج التريتيوم، والذي يعمل على تعزيز قوة الانفجار النووي عند دمجه بمادة الديوتيريوم.
وتمتلك إسرائيل مفاعلاً نووياً خاصاً بالأبحاث في مركز سوريك للأبحاث النووية وسط البلاد، ويعمل هذا المفاعل باليورانيوم عالي التخصيب، لكنه يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمكنت إسرائيل من الحصول على الوقود النووي من الولايات المتحدة لهذا المفاعل في أواخر خمسينيات القرن الماضي، لكنها حالياً غير قادرة على شراء المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب، لأنها ليست طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ما هو الثالوث النووي؟
وتمتلك إسرائيل عدداً من الأصول الجوية، والبحرية، والأرضية، القادرة على إطلاق أسلحة نووية، أو بمعنى آخر، يمكن القول إن إسرائيل تمتلك ثالوثاً نووياً مكتمل الأركان.
وذكرت مجلة National Interest الأميركية، في تقرير، أنه في سبتمبر 2016 سُربت رسالة عبر البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الأميركي الأسبق، كولن باول، ألمح فيها إلى أن تل أبيب تمتلك ترسانة نووية مكونة من 200 سلاح نووي، وبينما يبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه، فليس هناك أدنى شك في أن إسرائيل تمتلك مخزوناً صغيراً من الأسلحة النووية، ولكنه قوي للغاية وموزع على أفرع الجيش الإسرائيلي.
ووفقاً للمجلة، فإن الأسلحة النووية تهدف إلى حماية إسرائيل من الهزيمة في حرب تقليدية مع جيرانها، وردع خصومها المحتملين عن شن هجمات نووية وكيميائية وبيولوجية ضدها، أي أن الهدف الرئيسي لهذا الثالوث النووي هو حماية "الدولة اليهودية" من الانهيار.
قوة الثالوث النووي الإسرائيلي الجوية
يشير مركز الحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى أن إسرائيل قادرة على نشر أسلحة نووية على متن طائرات F-15، وF-16، وF-35 الأميركية، وجميعها قادرة على حمل قنابل نووية في نسخها المعدلة.
ويبلغ مدى المقاتلة F-16 أقل من 1600 كيلومتر، ومع ذلك فهي الطائرة الأكثر احتمالاً لإسناد المهام النووية إليها، نظراً إلى أنها تقوم بنفس الدور لدى الجيش الأميركي وبعض أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما تعتبر إسرائيل أكبر مشغل أجنبي لمقاتلات F-16 باستحواذها على أكثر من 250 طائرة من هذا الطراز، وفقاً لمجلة Military Watch المتخصصة في الشؤون العسكرية.
ومع ذلك، تعمل إسرائيل حالياً على استبدال أسطولها الضخم من مقاتلات F-16 بمقاتلات الجيل الخامس F-35 والقادرة أيضاً على حمل أسلحة نووية، إذ من المقرر أن يصبح لدى إسرائيل 50 طائرة من هذا الطراز بحلول عام 2024، سبق أن طلبتها من الولايات المتحدة.
غواصات نووية إسرائيلية
تشير بعض التقارير إلى أن إسرائيل نشرت أسلحة نووية على متن عدد من أصولها البحرية، ويُعتقد أنها وضعت هذه الأسلحة على متن غواصات من طراز Dolphin التي اقتنتها من ألمانيا.
وتمتلك إسرائيل، وفقاً لما نقله مركز الحد من التسلح ومنع الانتشار عن بعض الخبراء، 6 غواصات من طراز Dolphin القادرة على حمل صواريخ كروز ذات رؤوس نووية لشن هجمات على مواقع برية، لكن المركز أشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود دليل قوي على صحة هذه المعلومات.
وجادل المركز بأنه، حتى لو كانت هذه الغواصات قادرة على حمل أسلحة نووية، أو يمكن تعديلها وتحديثها لغرض نووي، فإن ذلك لا يؤكد أن إسرائيل قادرة على نشر غواصة تحمل سلاحاً نووياً بشكل مستمر في البحر.
وعلى النقيض، تقول مجلة National Interest، إن إسرائيل تحتفظ بغواصة واحدة على الأقل من طراز Dolphin في البحر، للحفاظ على ما يسمى بـ "القدرة على توجيه الضربة الثانية"، أي أنه في حال استهداف إسرائيل بضربة نووية جرى خلالها القضاء على أسلحتها النووية، سيظل جزءاً من الردع النووي الإسرائيلي في البحر غير معرض للضربة النووية الأولى، ما يضمن لتل أبيب القدرة على شن هجوم نووي مضاد.
وتعمل الغواصات الإسرائيلية الست بالديزل والكهرباء، وكانت آخر غواصة من فئة Dolphin انضمت إلى البحرية الإسرائيلية أغسطس الماضي، ووفقاً لبعض التقارير، فإن الغواصة الجديدة أكبر حجماً من كل الغواصات السابقة، وقادرة على حمل صواريخ باليستية متقدمة.
صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية
يشير تقرير مركز الحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى امتلاك إسرائيل مجموعة من صواريخ "أريحا" (Jericho) القادرة على حمل رؤوس نووية، ضمن سلاح الثالوث النووي الخاص بها، إذ بدأ إنتاج هذه الصواريخ بشراكة مع شركة Dassault الفرنسية في ستينيات القرن الماضي لإنتاج صواريخ باليستية أرض-أرض، لكن الإنتاج نُقل فيما بعد إلى إسرائيل بعد حرب عام 1967، لأن فرنسا فرضت حظراً على توريد المعدات العسكرية الجديدة إلى إسرائيل، بسبب اعتراضها على الحرب.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن إسرائيل تمتلك 3 فئات من صواريخ "أريحا" هي: "أريحا 1"، و"أريحا 2" و"أريحا 3".
"أريحا 1": تم تصنيع هذا الصاروخ بشكل مشترك بين فرنسا وإسرائيل، ودخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي عام 1973، ويصل طوله إلى 13.72 متراً ويعمل بالوقود الصلب، ويصنف باعتباره صاروخاً باليستياً قصير المدى، إذ يتراوح مداه بين 500 و720 كيلومتراً، ويمكن إطلاقه من قاذفة نصب ناقلة، أو عربة سكك حديدية، أو منصة إطلاق صاروخية.
"أريحا 2": صُنع هذا الصاروخ بشكل مستقل في إسرائيل، ودخل الخدمة عام 1989، وهو صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، يبلغ طوله 15 متراً، ووزنه 22 ألف كيلوجرام، ومداه يتراوح بين 1500 و3 آلاف و500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من قاذفة نصب ناقلة، أو عربة سكك حديدية أو منصة إطلاق صاروخية.
"أريحا 3": دخل الصاروخ الخدمة في الجيش الإسرائيلي عام 2011، وهو صاروخ باليستي بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ طوله 16 متراً، ووزنه 29 ألف كيلوجرام، ومداه يتراوح بين 4 آلاف و800 و6 آلاف و500 كيلومتر، ويمكن إطلاقه من قاذفة نصب ناقلة، أو عربة سكك حديدية أو منصة إطلاق صاروخية.