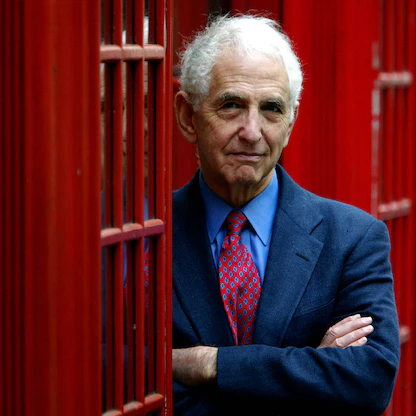بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، تعهدت الولايات المتحدة بـ"دعمها الثابت لسيادة كييف"، وتجسّد ذلك في حزم مساعدات عسكرية تجاوزت قيمتها 75 مليار دولار.
وتبنى الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاباته النهج الداعم لكييف. وخلال زيارته مصنع "لوكهيد مارتن" بولاية ألاباما، في مايو من العام الماضي، قال إن الولايات المتحدة "صنعت الأسلحة والمعدات التي ساعدت في الدفاع عن الحرية والسيادة في أوروبا منذ سنوات، وهي اليوم تكرر ذلك من جديد".
لكن هناك من يرى أن خطاب بايدن لا يتناسب مع الواقع، إذ أدى النقص في الإنتاج والعمالة، وانقطاع سلاسل التوريد إلى إعاقة قدرة الولايات المتحدة على تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وعدم تعزيز القدرات العسكرية للبلاد على نطاق أوسع.
وبحسب تقرير لمجلة "Foreign Affairs"، رأى مايكل برينس، الخبير الاستراتيجي والمتخصص في التاريخ بـ"جامعة ييل" الأميركية، أن هذه المشكلات لها علاقة كبيرة بتاريخ الصناعة العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح برينس أن "موجة الخصخصة خلال الحرب الباردة، بالإضافة إلى تقلص الاستثمار الفيدرالي، ساهما في انعدام الكفاءة، وهدر الأموال، وعدم ترتيب الأولويات، الأمر الذي بات يُعقد مسألة المساعدات الأميركية لأوكرانيا حالياً.
وبعد سقوط جدار برلين، قلّص القائمون على الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة من الإنتاج والقوى العاملة، كما سعوا إلى إبرام عقود حكومية لأسلحة تجريبية باهظة الثمن للحصول على أرباح أكبر على حساب إنتاج الأسلحة الصغيرة والذخيرة.
ونتيجة لذلك، كانت الصناعة، وفقاً لتقرير المجلة الأميركية، غير مستعدة لمواجهة الأزمة الأوكرانية، كما أنها لا تلبي احتياجات الأمن القومي الأوسع للولايات المتحدة وحلفائها. وعلى الرغم من قابلية الأمر للإصلاح، إلا أنه لا توجد حلول سريعة لهذه المشكلة الداخلية.
دروس الحرب العالمية
يبدأ تقرير "Foreign Affairs"، الذي نُشر 3 يوليو الماضي، في سرد أصل المشكلة عائداً بالزمن إلى الحرب العالمية الثانية، حيث عقد مقارنة بين نظام الإنتاج الحربي الأميركي آنذاك، وبين وضع الصناعة العسكرية اليوم.
خلال ذلك الوقت، كانت الصناعة في الغالب تُديرها الحكومة الأميركية، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل فرانكلين روزفلت والذي عرف بـ "الصفقة الجديدة"، فتح الباب لإنشاء مجلس الإنتاج الحربي عام 1942، الذي عمل على تخصيص الشركات والموارد لما يخدم جبهة القتال. وتركّز إنتاج الأسلحة على بناء السفن والطائرات، وكانت الحكومة تمتلك ما يقرب من 90% من الطاقة الإنتاجية للطائرات والسفن والمدافع والذخيرة.
واستشهد برينس بما حدث عندما قصف اليابانيون ميناء "بيرل هاربور" عام 1941، حيث سمحت السيطرة الفيدرالية بالتحول السريع من الإنتاج الحربي المدني إلى الإنتاج الحربي العسكري في شركات مثل "فورد" و"جنرال موتورز"، فانتقلت من صناعة السيارات إلى صناعة القاذفات. ودعمت الحكومة الفيدرالية الشركات الصغيرة التي أنتجت المواد المتعلقة بالحرب في المصانع التي تُديرها الحكومة.
وفي تلك المرحلة السابقة، لم تُهيمن مجموعة الشركات الكبيرة على الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة، وذلك على عكس ما يحدث اليوم مع الشركات الخمس الكبرى: "بوينج"، و"جنرال داينامكس"، و"لوكهيد مارتن"، و"نورثروب غرومان"، و"رايثون".
وتشكل العناصر التجارية في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد عن 88% من عقود المشتريات الجديدة منذ عام 2011، وتستثمر الشركات الخاصة أكثر من 6 مليارات دولار سنوياً في الصناعة العسكرية.
ورغم أن حجم إنتاج الأسلحة لصالح أوكرانيا لا يوازي ما كان مطلوباً خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن تلك الفترة لا تزال تُقدم رؤية ملهمة في ظل المشكلات المعاصرة.
خصخصة الصناعة العسكرية
مرحلة الجهود الفيدرالية الأميركية لتحفيز التوظيف العسكري في الستينيات انتهت، وضغطت الشركات العسكرية على الكونجرس لتخفيف اللوائح الحكومية لخصخصة عمليات الصناعة حتى قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وكشفت التعبئة العسكرية خلال الحرب الكورية عن القوة المتنامية للمؤسسات الخاصة في الشؤون العسكرية الأميركية، فعندما اندلعت الحرب عام 1950، اعتمد الرئيس الراحل هاري ترومان على الأوامر التنفيذية وتشريعات الكونجرس لتحفيز الاستثمار الخاص في الجيش. وأوضح المؤرخ تيم باركر أن 90% من الإنتاج الحربي خلال الحرب الكورية جاء من التمويل الخاص.
وبعد انتهاء الحرب الكورية، اتجهت الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى توفير فرص عمل في القطاع العسكري الخاص وفي الجامعات التي تعمل على المشاريع الممولة من البنتاجون، لتعزيز "التعاون بين العلم والصناعة"، على حد تعبير الرئيس الراحل دوايت أيزنهاور.
الحكومة الأميركية سعت أيضاً إلى التفوق على الاتحاد السوفيتي في سباق الفضاء والتسلح من خلال زيادة القوة العاملة، إذ فوجئ أيزنهاور بإطلاق السوفييت القمر الاصطناعي "سبوتنيك" عام 1957، فوقّع قانون تعليم الدفاع الوطني بعد ذلك بعام، والذي قدّم منحاً وقروضاً حكومية للأميركيين الذين يسعون للحصول على درجات علمية في العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالصناعة العسكرية، ما ساهم في رفع العديد من الأميركيين إلى الطبقة المتوسطة.
وخلال إدارتي الرئيسين جون كينيدي (1961-1963) وليندون جونسون (1963-1969)، وضع وزير الدفاع روبرت ماكنمارا سلسلة إصلاحات قلّلت التركيز على إنتاج الأسلحة التقليدية. وفي 1965، خلال تصاعد العمليات العسكرية الأميركية في فيتنام إلى حرب كاملة، لم تعد معظم المنشآت العسكرية في ملكية أو تحت إدارة الحكومة.
وفي السنوات التالية، اعتمدت الصناعة بشكل كبير على المصانع المملوكة للحكومة التي تديرها الشركات الخاصة، والتي حصلت على مزيد من الحرية للإشراف على الصناعة. وأدى الاستقلال الكبير للصناعة وتقليل المساءلة إلى رد فعل عنيف خلال سنوات فيتنام، ففي عام 1970، أعرب عضو الكونجرس الديمقراطي، ويليام بروكسمير، عن استيائه من هدر ميزانية وزارة الدفاع "البنتاجون" في أسلحة باهظة الثمن "تُسلم بعد فوات الأوان، وتعمل بأقل بكثير من مواصفاتها".
وبعد حرب فيتنام، تسارع معدل الخصخصة وتراجع إشراف الكونجرس على الصناعة، وتطلعت وزارة الدفاع الأميركية إلى مساعدة الشركات على تحقيق مزيد من الأرباح عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص في المصانع العسكرية، وإنتاج الأسلحة التي مهدت الطريق لمرحلة الثمانينيات والتسعينيات.
تدهور مستمر
كانت فيتنام آخر حرب تقليدية كبرى للصناعة العسكرية الأميركية، فمع انتهاء الحرب عام 1973 وبدء تقلّص ميزانية الدفاع، تحولت الصناعة إلى بيع الأسلحة للخارج، وارتفعت صادرات الأسلحة إلى دول جنوب العالم من 404 ملايين دولار عام 1970 إلى 9.9 مليار دولار عام 1974، مع تراجع التصنيع والاستعانة بشركات خارجية للتصنيع العسكري لصالح دول أجنبية.
وتسبب هذا في إغلاق المصانع وفقدان الوظائف في الصناعة المحلية الأميركية، فانخفضت القوى العاملة العسكرية في الولايات المتحدة بنسبة 9.8% من 1960 إلى 1975، وشهدت مناطق مثل "نيو إنجلاند" انخفاضاً بنسبة 50% على مستوى العمالة المدنية والعسكرية.
وبحلول الثمانينيات، تزايد قلق كل من البنتاجون والكونجرس بشأن نقاط ضعف القاعدة الصناعية العسكرية، وأعرب المشرعون عن قلقهم من أن "اعتماد الولايات المتحدة المتزايد على المصادر الأجنبية"، من شأنه أن يُعرض الاستعداد العسكري للخطر. وفي 1988، حذّر البنتاجون من العواقب الوخيمة للاعتماد على المصادر الأجنبية في حالة الطوارئ الوطنية.
ورغم أن الرئيس رونالد ريجان سعى إلى تعزيز القطاع العسكري، من خلال زيادة الإنفاق بنحو الضعف من 176.6 مليار دولار عام 1981 إلى 325.1 مليار دولار عام 1990، إلا أنه أعطى الأولوية للمشاريع التجريبية، مثل صاروخ MX ومبادرة الدفاع الاستراتيجي، وهو نظام دفاع صاروخي مقترح يحمي الولايات المتحدة من هجوم نووي محتمل.
كما أنفقت الحكومة الأميركية على برنامج "حرب النجوم" 30 مليار دولار قبل أن يلغيه الرئيس بيل كلينتون عام 1993. وكانت إدارة ريجان ضخّت الأموال في طائرات متقدمة مثل القاذفة الشبح B-2 والمقاتلة الشبح F-22، على حساب المدفعية والذخيرة.
وفقاً لتقرير "Foreign Affairs"، فشل ريجان في تحديث المصانع العسكرية بشكل صحيح في الولايات المتحدة، وعجز عن إنعاش القوى العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، بينما انتعش سوق الشركات الكبرى في عهده على حساب المقاولين الصغار الذين اتجهوا إلى مصادر أخرى لإيراداتهم.
كما أدى تبني فلسفة التجارة الحرة وخفض التكاليف والكفاءة إلى تسريع الاستعانة بمصادر خارجية، ما دفع الصناعة العسكرية إلى مواصلة التخلص من العمالة الأميركية، إذ تراجعت منذ الثمانينيات من 3.2 مليون عامل، إلى العدد الحالي البالغ 1.1 مليون عامل.
العشاء الأخير
عندما أدت نهاية الحرب الباردة إلى مناقشة "ثمار السلام"، وبدأ صانعو السياسة الأميركيون في إعادة تقييم المبلغ الذي سينفقونه على المجال العسكري، شعر المتعاقدون أنه يتعين عليهم الاختيار بين الاندماج أو الهلاك.
وفي عام 1993، خلال حفل عشاء في البنتاجون، عُرف عسكرياً بـ"العشاء الأخير"، حذّر قادة الدفاع رؤساء أكبر الشركات العسكرية في البلاد من أن الميزانية المخصصة للقطاع على وشك الانخفاض بشكل حاد.
بدورها، استوعبت الشركات الرسالة، وبدأت في الاندماج، وانخفضت مصانع الصواريخ التكتيكية من 13 إلى 3، وتقلص عدد الشركات المتخصصة في الطائرات من 8 إلى 2. وكان الرئيس بيل كلينتون يأمل في أن يؤدي الدمج إلى خفض التكاليف وتبسيط عملية التعاقد، لكن ذلك لم يتحقق، بل أدى ذلك إلى خسارة الآلاف لوظائفهم.
وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العسكري مرة أخرى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، لكن لم يتغير الكثير في الصناعة العسكرية الأميركية، فاستمرت موجة الاندماج خلال "الحرب على الإرهاب" حتى وصلت الآن إلى أرقام قياسية بسبب تأثير الشركات الخاصة. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن أكثر من 500 شركة تم شراؤها من قبل القطاع الخاص في العقدين الماضيين.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن معدل الديون المستحقة المرتفع على الشركات الخاصة، وعدم المساءلة أمام الرقابة العامة، وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد، لا يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. إلى جانب أن الشركات الناشئة في المجال العسكري في وادي السيليكون على مدى السنوات العديدة الماضية، وعدت بالابتكار وتحديث القاعدة الصناعية الدفاعية، لكن تلك الوعود لم تتحقق بعد.
وكان هناك اهتمام بسلع باهظة الثمن على حساب شراء ذخائر منخفضة التكلفة، حيث تُقدر تكلفة برنامج "F-35 Joint Strike Fighter" بـ 1.6 تريليون دولار. وحتى وقت قريب، لم يكن من المربح إنتاج الأجزاء الصغيرة كمحركات الصواريخ والذخيرة الفولاذية وغيرها من المواد اللازمة للأوكرانيين، وكان أقل أهمية للحكومة الأميركية والشركات العسكرية.
كما أدت السياسات ضيقة الأفق والضغوطات، إلى تغيير أولويات البنتاجون وإجبار الجيش على الاحتفاظ بعقود لبرامج عتيقة مثل السفن الحربية الساحلية. ورغم ذلك، تُواصل الصناعة العسكرية الأميركية الاستثمار في الطائرات والصواريخ المتقدمة مثل القاذفة الشبح B-21، والصاروخ الباليستي العابر للقارات LGM-35 Sentinel، رغم التكلفة الباهظة لهذه الأنواع من البرامج، التي يتعين على المواطن الأميركي دفعها من ضرائبه.
نتيجة حتمية
التاريخ الممتد على مدى 70 عاماً من الدمج والخصخصة والاستعانة بمصادر خارجية وخفض الوظائف وتعطيل الدور الفيدرالي، والبحث عن مكاسب أكبر، أدى بحسب التقرير، إلى عرقلة عملية المساعدة الأميركية العسكرية لأوكرانيا، وربما يطال تأثيره الصراعات المستقبلية أيضاً.
فكما ورد في تقارير "Politico" و"The Wall Street Journal"، لا تملك الولايات المتحدة القوة العاملة اللازمة لإنتاج عدد صواريخ "جافلين" التي طلبتها أوكرانيا، حتى بعد أن استهلكت كييف في الأشهر الستة الأولى من الحرب، كمية من هذه الصواريخ كانت تكفي 5 سنوات. والأمر ذاته حدث في غضون 10 أشهر مع صواريخ "ستينجر" التي كانت تكفي 6 سنوات.
وفي عام 2021، انفجر أحد المصانع القليلة المملوكة للحكومة الأميركية، والتي يُديرها المقاولون، وكانت تنتج البارود الأسود اللازم لقذائف المدفعية، لكن لم يجر إعادة بناء هذا المصنع لأنه لم يُحقق ربحاً كافياً.
ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر الانقطاعات في سلاسل التوريد العالمية على الصناعة العسكرية في المستقبل القريب، ورغم توقعات زيادة المبيعات والأرباح خلال 2024، إلا أن الولايات المتحدة لا تستطيع تصحيح المشكلات القائمة على المدى القصير، فالأمر يتطلب حلولاً شاملة بمشاركة حكومية وسيطرة أقوى على الصناعة على المدى القريب والبعيد. فعلى الإصلاح العسكري أن يتجاوز الاستحواذ أو التدقيق إلى ما هو أبعد من ذلك، على الرغم من الحاجة إلى تغييرات على كلتا الجبهتين.
مراجعة شاملة
وحض تقرير المجلة الأميركية في الجزء الأخير منه على ضرورة تبنى الكونجرس إعادة تصوّر للإصلاح العسكري، وأن يستخلص الدروس من المرة الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة "ترسانة الديمقراطية" بشكل حقيقي، إذ إن هناك حاجة إلى مزيد من التدخل الفيدرالي في الصناعة العسكرية إذا كانت ترغب في إنتاج أسلحة "غير مربحة".
وكان الشاغل الرئيسي بين المحللين هو كيفية تجديد مخزون الأسلحة لضمان عدم استنفاد الولايات المتحدة ترسانتها الشاملة، إلا أن تخزين الأسلحة أمر مستحيل بالنظر إلى ندرة العمالة الأميركية الماهرة.
كما أن توظيف عمال مهرة في القطاع العسكري غالباً ما يتطلب تدريباً مهنياً أو دراسة لمدة عامين، وهو وقت لا تملكه أوكرانيا في الوقت الحالي، ولذلك ينبغي على الولايات المتحدة دعم توفير فرص العمل في جميع قطاعات التوظيف، لا القطاع العسكري فحسب، حتى يتمتع الأميركيون بالمهارات المطلوبة والتدريب اللازم لأوقات الأزمات.
ويحاول الرئيس جو بايدن معالجة هذا الأمر من خلال قانون الرقائق والعلوم "CHIPS and Science Act"، الذي وقعه عام 2022، ويهدف إلى منافسة الصين، عن طريق تمويل الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
كما يُمكن لإدارة بايدن أن تتبع سياسات إضافية تدعم التعليم العالي، وتخلق فرص عمل في وقت السلم، وعليها أيضاً توسيع قوتها العاملة على المدى الطويل، بما يعود بالنفع على ديمقراطيتها ككل، لا من أجل مصالحها الأمنية المتعلقة بروسيا والصين فقط، بحسب المجلة الأميركية.
ولفتت إلى أنه "خلال حربي العراق وأفغانستان، واجه الجنود الأميركيون نقصاً في المعدات والذخيرة، وكان لهذا علاقة كبيرة بحقيقة أنه بحلول عام 2004، أنتج مصنع واحد فقط في ولاية ميزوري ذخيرة للجيش الأميركي بأكمله، بدلاً من 5 مصانع خلال حرب فيتنام، إضافة إلى أنه كان هناك مصنع واحد فقط للدروع الواقية".