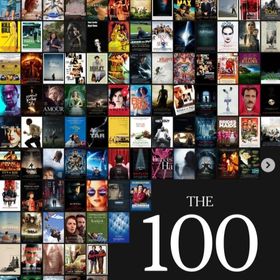تخيل أن تعيش يوماً كاملاً من دون تيار كهربائي ولا لحظة واحدة، وهذا يعني من دون مكيفات تبريد أو تدفئة، من دون استحمام، من دون شاحن لبطارية هاتفك أو جهازك المحمول، ومن دون وقود لسيارتك، ومن دون وسائل نقل عامة أو مواد أولية في السوق.
هذه الفرضية، هي واقع يعيشه السوريون منذ نحو 10 سنوات مع اشتداد سنوات الحرب. وازداد الوضع سوءاً مع بدء جائحة كورونا، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، وأخيراً الزلزال المدمّر الذي ضاعف معاناتها ومشاكلها ومصاعبها الاقتصادية والحيوية.
بناء على ما تقدم، ثمة تفاصيل كثيرة تحيط بـ"أزمة المحروقات" التي تفتك بسوريا وانعكاسها على جميع مفاصل الحياة اليومية في بلد أنهكته الحرب منذ ما يزيد عن عشر سنوات. في ما يلي بعض من تواريخ ومحطات وأرقام.
كيف بدأت الأزمة؟
وصل إنتاج سوريا قبل بدء الحرب في عام 2011 إلى 85 ألف برميل يومياً، تصدّر ثلثه تقريباً، وتستهلك ثلثيه الباقيين ضمن السوق المحلية، ما حقَّق طيلة عقود اكتفاءً ذاتياً في ما يخص المحروقات ومشتقاتها، وفقاً لما أفاد به مصدر في وزارة النفط السورية "الشرق".
لا يتجاوز ما تنتجه الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية اليوم، 18 ألف برميل، في وقت تحتاج البلاد إلى 50 ألف برميل يومياً، ما يُجبر الحكومة على البحث عن طرق بديلة للاستيراد أو إحضار الوقود والفيول من "الحلفاء والأصدقاء".
ومع اشتداد الصراع على الأراضي السورية في عام 2013، وسيطرة القوات الكردية بدعم من واشنطن على مناطق شرق الفرات الأغنى بحقول النفط، خرجت 90% من إيرادات الدولة النفطية من تلك المنطقة، ولم يبق تحت سيطرتها إلا بضعة حقول تقع في مناطق غرب نهر الفرات في ريف حمص الشرقي.
وزادت هذه الأزمة تدريجياً منذ ذلك الوقت، وتفاقمت بداية مع بدء تطبيق "قانون قيصر" في عام 2019 من قبل الولايات المتحدة، والذي يمنع ويجرّم معظم التعاملات مع حكومة دمشق، ومع أسماء وشخصيات تشملهم عقوبات متجددة.
وتفاقم الوضع أكثر فأكثر مع بدء جائحة كورونا عام 2020، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وأخيراً جاء الزلزال المدمّر، ليُجهز على ما تبقى من محطات الوقود وشبكات الكهرباء والبنية التحتية المتهالكة في البلاد.
عتمة وبرد
بمجرّد غياب قرص الشمس عن العاصمة دمشق، تدخل المدينة في عتمة تزدادُ تدريجياً لتشمل في ساعات طويلة جميع أحيائها وشوارعها، وتشمل الإضاءة العامة وإشارات المرور.
ظلام دامس تغرق فيه المدينة، وتكسره أضواء السيارات التي تشقّ طريقها بصعوبة، أو هواتف محمولة بأيدي أشخاص يقطعون الشارع، ويُشيرون بهواتفهم للفت النظر إلى وجودهم خشية الحوادث.
في دمشق أيضاً، وتحديداً في أيام كهذه في فصل الشتاء، تنخفض درجات الحرارة. وأثَّر فقدان المشتقات النفطية على قطاع الكهرباء بشكل رئيس، فمحولات الطاقة في سوريا تعمل على الغاز أو على الفيول، وكلاهما غير متوفر إلا بكميات محدودة، ما أجبر الحكومة على تطبيق نظام تقنين قاسٍ، يصل أحياناً إلى 20 ساعة انقطاع مقابل ساعتي وصل للكهرباء في اليوم الواحد.
وقال حسَّان نظام (42 عاماً)، وهو موظف حكومي لـ"الشرق": "نتجمّد من البرد يومياً، لا كهرباء لتشغيل المكيفات، ولا مازوت لوضعه في المدافئ.. نعتمد بشكل أساسي على اللحف والبطانيات، لكننا نوشكُ يومياً أن نموت من البرد".
في دمشق القديمة، تلتفُ عائلة نظام في غرفة صغيرة تحت البطانيات، وعيونهم على بطارية هواتفهم المحمولة التي لا يتجاوز شحنها في الغالب الخمسين في المئة بأحسن الأحوال.
تعوَّد الناس هنا على هذه الحالة، واستعانوا ببطاريات كبيرة تكفي لإنارة بسيطة، لكنها لا تستطيع تشغيل أي أداة كهربائية، بما في ذلك مضخّة دفع المياه.
يُضيف نظام: "لا إضاءة ولا ماء ولا كهرباء، حتى مياه الاستحمام تحتاج للتيار الكهربائي كي تصل إلى منازلنا.. نشعرُ أننا نعيش في القرن التاسع عشر قبل اختراع الكهرباء".
في المنازل الأقل حظّاً ومقدرة مادياً، أعيد استخدام الشموع للإنارة، والفوانيس القديمة والطرق التقليدية للطبخ مثل الطهو على الحطب.
ويتابع الرجل الأربعيني: "الحطب أداة ممتازة لتعدد استخداماته، للطبخ والتدفئة والإنارة، وغالباً ما تتجمع العائلة حول موقد الحطب.. مع ذلك وصل سعر طن الحطب الذي يكفي لمدة شهر تقريباً إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية".
طوابير الانتظار
الانتظار ليس عادة غريبة على السوريين، لا بل أصبح عادة مألوفة مع سنين الحرب، فطوابير الانتظار تبدأ عند الأفران، وتمرّ بالمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العامة، لتصل لمحطات الوقود.
يبقى أن العامل المشترك في جميع طوابير الانتظار، هو غياب المحروقات.
قبل ثلاثة أشهر تقريباً، أعلن رئيس "جمعية الحلويات" بسام قلعجي في حديث لإذاعة محلية أن "نصف الأفران الخاصة توقفت عن العمل في دمشق، و30% من النصف المتبقي تعمل بشكل محدود".
وتمدد ذلك ليطال الأفران الحكومية، إذ إن أزمة المشتقات النفطية "جعلتها تعمل لساعات محدودة يومياً" وفق المصدر، ما يؤدي لتشكل طوابير الانتظار على الأفران.
وفي "شارع الثورة" وسط دمشق، يتجمع العشرات عند المواقف العامة، ويرتفع عددهم إلى مئات في ساعات الذروة في انتظار أي حافلة أو وسيلة نقل عامة، مع تراجع أعدداها للسبب ذاته والذي يرتبط بنقص مخصصاتها من المحروقات.
وقال مدير الهندسة المروية في ريف دمشق بسام رضوان في ديسمبر عام 2021: "تم تخفيض مخصصات السرفيس (خدمة للنقل العام بسوريا) بحدود 40%، وبالتالي فإنَّ سيارات السرفيس لا تحصل على مخصصاتها بشكل كامل، وهذا يؤثر في الحركة والتنقل".
وتُعاني الطالبة في كلية الآداب، زهرة شيخ البساتنة، بشكل يومي لتصل إلى جامعتها في منطقة المزة. وتحتاج أن تستقلّ يومياً حافلتين على الأقل.
وتقول: "أضطرّ للتغيّب عن جامعتي بشكل أسبوعي، ولا أتمكن من الدوام إلا يومين أو ثلاثة أيام.. لا تستطيع عائلتي تحمّل نفقات سيارات الأجرة، والسرافيس والحافلات العامة غير متوفرة".
وتمتد معاناة زهرة من منزلها إلى جامعتها، فحتى قاعات المحاضرات "غير دافئة" ويضطرّ المدرسون أحياناً للاستعانة بأجهزة الإسقاط الخاصة بهم لاستكمال المحاضرات بعد انقطاع الكهرباء.
صمتٌ يلفّ المدن الصناعية
لطالما كانت مدينة حلب عاصمة البلاد الاقتصادية، وحاضرتها الصناعية الأولى. واستطاعت المدينة التي تقع على طريق الحرير التجاري قديماً، وعلى طريق التصدير إلى تركيا وأوروبا حديثاً، أن تسجل اسمها ذائع الصيت على كبريات المنتجات القطنية والصوفية بشكل رئيسي.
"صنع في حلب" عبارة تسويقية كافية لتسويق كامل الكميات التي كانت تنتجها أكثر من 100 ورشة ومدينة صناعية في المحافظة الشمالية.
يقول بسام جبيلي، صاحب ورشة صناعة صابون الغار الشهير لـ"الشرق": "رحم الله تلك الأيام التي كنا لا نتوقف فيها عن العمل ولا لحظة واحدة، أما اليوم فنحنُ محكومون بالتقنين، نعمل مع مجيء التيار الكهربائي، ونقف مع انقطاعه".
ويقول جبيلي إن الانتاج تراجع بأكثر من 80% مقارنة مع أيام ما قبل الحرب، مضيفاً: "لا نستطيع إحضار وقود بأنفسنا، فكلفته مرتفعة للغاية، والمولدات تحتاج لمئات الليترات يومياً. اضطررنا لتقليص عملنا وإنتاجنا، وتسريح العشرات من العاملين في ورشاتنا".
ويلفّ الصمت "مدينة الشيخ نجار الصناعية" في ريف حلب، وهي أكبر مدينة صناعية في سوريا. لا معامل مفتوحة، ولا ورشات تعمل إلا بشكل محدود. واضطرّ أغلب أصحاب المعامل لتسليم معداتهم أو بيعها، بعد تقطع السبل بهم في تشغيل آلاتهم.
يُتابع الجبيلي: "أمنوا لنا الوقود، وسنؤمن لكم الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسوق السورية بأكثر من عشرين مادة، أبرزها المتعلقة بالملابس والمنظفات".
الموارد الحالية
لا تؤمن حقول النفط الواقعة حالياً تحت سيطرة الحكومة أكثر من 10% من الاحتياج الفعلي. وتعتمدُ البلاد بشكل أساسي على الخط الائتماني الإيراني الذي يؤمن كميات من الوقود، وعلى مساعدات محدودة من روسيا والجزائر والعراق، وبعض الدول الصديقة لدمشق، لكن ذلك لا يكفي.
يقول مصدر في وزارة النفط فضل عدم الكشف عن هويته لـ"الشرق": "هذه الإعانات هي بمثابة كميات إنعاش حتى لا تموت البلاد بشكل كامل، لكننا في الحقيقة نحن بحاجة لكميات كبيرة ومتواصلة من الفيول والغاز من الدول الشقيقة والصديقة، أو استعادة حقولنا التي تقع شرق نهار الفرات والمسيطر عليها حالياً من قبل الولايات المتحدة الأميركية".
ويُضيف: "الوقود هو عصب الحياة لأي بلد، والمشغل الأساسي لكل المؤسسات الحيوية، ومن دونه تموت البلاد سريرياً، ويعيش المواطنون تخت خطّ الفقر والبرد".
غلاء الأسعار
في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة، تبدو الأوضاع أحسن حالاً نظراً لاختلاف مصدر الوقود، ومع ذلك يعاني الأهالي هناك من ارتفاع أسعار المحروقات، كما تواجه جهود الإنقاذ في تلك المناطق مشاكل ذات صلة بالوقود.
وقال حسين عثمان الذي يعيش في شمال غربي سوريا لـ"الشرق": "حالياً المحروقات متوفرة بشكل كبير، وأينما ذهبت تجدها بمحطات الوقود، لكن المشكلة في غلاء أسعارها"، مشيراً إلى أنَّ "غالبية السكان تحت خط الفقر، والكثير غير قادر على شراء المحروقات".
الواقع المذكور أعلاه، انعكس على التدفئة، إذ يشتكي قصي قريش من انعدام التدفئة مشيراً إلى أنَّ "مصادر التدفئة عندي على الحطب، حتى أن الحطب غالي الثمن، وسعر المحروقات غالي أيضاً".
وأوضح مصطفى شريف أنَّ مصادر التدفئة تعتمد على المحروقات، وهناك أنواع عدة من المحروقات الرخيصة تكون رديئة وذات رائحة كريهة، أو ما يسمى محلياً المكرر أو المحسّن، وهو عبارة عن تكرير الفيول القادم من مناطق الإدارة الذاتية شرق الفرات.
وأضاف: "أما الديزل المستورد أو ما يسمى الأوروبي غالي الثمن، وكثافته منخفضة لذلك لا يعتبر من المحروقات الفعالة للتدفئة".
عرقلة جهود الإنقاذ
وأوضح عضو مجلس إدارة منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أحمد يازجي، أنَّ نقص المحروقات أثر على جهود الإغاثة.
وكشف أن فرق الدفاع المدني العاملة في شمال غرب سوريا، كانت بحاجة كبيرة إلى الوقود لمواصلة عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وانتشالهم وهم على قيد الحياة.
وتابع: "كان على عاتق فرق الدفاع المدني، تعبئة الوقود للآليات المدنية التي تم استقطابها من الجهات المدنية، والمحلية، لضمان استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض".
وأوضح أنه إلى جانب عمليات الانتشال، والآليات الثقيلة، تقوم فرق الدفاع المدني بعمليات إزالة الأنقاض من الطرق الرئيسة وفتحها، ما يزيد الحاجة إلى الوقود، مؤكداً أنَّ "هناك استهلاكاً كبيراً للوقود، بجانب استهلاك للمعدات التي تحتاج إلى عمليات صيانه دورية لكي تستمر في تلك العمليات".
وشدد على أنَّ نقص المساعدات اللوجستية، ومعدات البحث والإنقاذ "التي سبق أن تم طلبها"، أثر بشكل كبير، وأدى إلى وفاة أشخاص.
واعتبر أنه كان بإمكان تلك المساعدات أن تنقذ حياة عدة أشخاص. وقال إن "الأصوات التي كنا نسمعها في الأيام الأولى لم نعد نسمعها بعد قضاء 72 ساعة، لذلك، أثّر تأخير المساعدات أثر على فرص البحث وإنقاذ من كانوا على قيد الحياة".