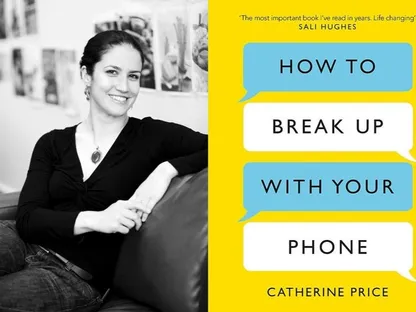الحياة مجرد أسابيع متلاحقة..
كلنا ندرك أن الوقت لا يكفي، وجميعنا مهووسون بالمهام الكثيرة التي يجب إنجازها، الواتساب مليء بالرسائل، وبريدنا ينتظر الردود، وكذا مشتت وواجب مهني وعائلي، ينبغي أن نتعامل معه منذ بداية اليوم.
كيف ندير الوقت، وقتنا الذي يصل إلى 4 آلاف أسبوع؟ سؤال يحاول الإجابة عنه الكاتب البريطاني أوليفر بوركمان، في 288 صفحة من كتابه "أربعة آلاف أسبوع.. كيف يدير الإنسان وقته المحدود في الحياة".
يشكّل الكتاب محاولة لإعادة التفكير في كيفية الاستفادة القصوى من الوقت، ويقدّم أسلوباً بديلاً للسعي المهووس الذي لا نهاية له، لإكمال قائمة المراجعات وتحسين الجدول الزمني.
"لا نقضي سوى وقت قصير جداً على هذه الأرض، ومتوسط عمر الإنسان قصير بشكل سخيف، ومرعب، ومهين".
بدءاً من العنوان، يتبادر إلى الذهن سؤال استفهامي: ما هي الأربعة آلاف أسبوع؟ ما الذي تحدّده هذه المدّة الزمنية؟ ويشرع البعض في حساب هذه المدة بالشهور والسنوات. لكن الكاتب يتحمّل عنا هذه المهمة منذ الصفحة الأولى، قائلا "بأنها تعني ثمانين سنة، أي متوسّط عمر الإنسان في عصرنا الحالي".
بعد ذلك يتنامى السؤال الأهم: لماذا هي بالضبط؟ فيجيبنا في الحال: "وفق هذا المُعطى، لا نقضي سوى وقت قصير جداً على هذه الأرض. إذ إن متوسط عمر الإنسان قصير بشكل سخيف، ومرعب، ومهين".
ومن ثم يرتبط السؤال الأول بالاستفهام الذي يفرض نفسه: كيف يمكن استخدام هذا الوقت، أي هذه الأسابيع القليلة، بأفضل طريقة ولأفضل هدف؟ بمعنى قضاء حياة سعيدة هانئة ومجدية؟
يبدو أن ما راكمه الكاتب والصحفي البريطاني المقيم في نيويورك، الذي اشتهر بعموده الصحفي حول القضايا السيكولوجية، لأكثر من عشر سنوات في صحيفة "ذا غارديان"، تحت عنوان "هذا العمود سوف يغيّر حياتك"، هو ما أملى عليه هذا الكتاب.
يقول بوركمان على موقعه: "إن أربعة آلاف أسبوع (كما آمل) هو دليل ترفيهي وفلسفي، ولكنه في نهاية المطاف دليل عملي للغاية، للمسار البديل المتمثّل في العودة إلى الواقع، وتحدّي الضغوط الثقافية لمراودة المستحيل، والقيام بما هو ممكن بشكل مفيد. يتعلق الأمر هنا بتحقيق أشياء ذات معنى، في عملنا وفي حياتنا معاً، مع العلم أنه لن يكون هناك وقت لفعل كل شيء".
محدودية الوقت
نعم، ما يجب أن ندركه هو أن الوقت لن يكفي لفعل كل ما يجب فعله. إذ إن فترة الحياة على الأرض تتميّز بالمحدودية. تلك هي الحكمة الأولى التي يدرسها بوركمان. هذه المحدودية لا تشكّل عائقاً، ولا تعني ضيق الوقت. بل إن المشكلة هي في الأفكار التي أوجدناها حول العلاقة مع هذا الوقت، مع مرور الزمن والعصور.
هنا يذكر الكاتب كيف كانت العلاقة مع الزمن في العصور الفائتة، قبل اختراع الساعات الميكانيكية، ما يحتم العودة إلى الوراء كي نفهم كيف وصلنا إلى هذه الحالة.
يقول بوركمان: "في الماضي لم يكن الإنسان يحسُب ما ينتجه بالساعات والدقائق، ولم يكن هناك حدّ زمني يتوجّب الوصول إليه عند كل عمل نقوم به، كي يتصرّف تبعاً لإيقاع الحياة العامة حوله. أما في عصرنا الحالي، فهو يربط الوقت بالإنتاجية والكمية، وفي أقل مدّة زمنية. وهذا ما أدى إلى تعاظم المعضلة، وعزّز هاجساً يقضّ المضاجع".
يضيف: "إن الوقت الذي كان مُعطى مجرداً، صار حاسماً وهدفاً وفاعلاً، وله علاقة وثيقة الصلة بتحقيق السعادة والراحة والازدهار. وحين لا يتم التحكم به، وهو ما يحدث كثيراً، على المستوى الفردي، تسود الكآبة وانعدام الرضى".
إن البحث عن الكفاءة الإنتاجية يُقوّي الضغط والإرهاق من جهة، ويفوّت على الإنسان الاهتمام بالجودة والعلاقات الصالحة له من جهة أخرى، عائلياً ومهنياً وترفيهياً. وكيفما كان الحال، لن ينجز كل شيء نروم إنجازه.
يقول الكاتب: "كلما واجهتَ حقائق المحدودية، وعملتَ وأنت واعٍ بها بدلاً من العمل ضدّها، أصبحت الحياة أكثر إنتاجية وذات معنى وبهجة".
تعذّر السيطرة على الوقت يفترض أن نهتم بالآني القريب، وعدم الارتهان للمستقبل المرادف للقلق والهوس، فلا شيء يقِينِي ومؤكّد بخصوصه".
الوعي بالتناهي
هذا الواقع مردّه إلى عدم شعور الإنسان بتناهي الزمن. أي الحركة الدؤوبة نحو المستقبل، وهو مفهوم اقتبسه بوركمان من الفيلسوف الألماني الشهير مارتن هيدغر، الذي كان وراء تيارات الفلسفة في القرن العشرين وما بعده، من خلال كتابه الرئيس "الكينونة والزمان" (1927).
التناهي الذي يعني إدراكنا المُلزِم لمحدودية الوقت كمنطلق للحياة نحو الموت، لا نستطيع الجحود به كحقيقة وجودية، الذي يفرض علينا التصرف تبعاً لاختياراتنا الشخصية وقيمنا الخاصة، في سبيل تحقيق حياة أصيلة، أي بعيدة عن أوهام التحكّم في الزمن.
هنا يستحضر الكاتب خيار الاستسلام، الذي يُنظر إليه في هذه الحالة كفضيلة، أي القبول بالمحدودية ومواجهتها، لتلبية أولوياتنا وما هو هام وأساسي، وعدم الانجرار خلف ما هو ثانوي يُلهينا عن أنفسنا، وعن إرضاء ما يتوافق مع أهوائنا.
يأتي ذلك بدلاً من اختيار استراتيجية التجنّب، كي نقنع أنفسنا بأن لا حدود تحول دون ما نودّ تحقيقه، وبأنه بمقدورنا التمكّن من ضبط أيامنا وأسابيعنا كما نشتهي، أو اختيار التسويف والمماطلة السلبية، و"هي طريقة أخرى للحفاظ على الشعور بالسيطرة المطلقة على الحياة".
"عصر التشتت"
ليس الأمر سهلاً كما يؤكد الكاتب، "لأننا نملأ عقولنا بالنشاط والإلهاء لتخدير أنفسنا عاطفياً. وعصرنا الحالي لا يجعلنا نعرف المهم من التافه، أو المفيد لنا من غير المجدي، ولا يساعدنا على الانتباه، بل يسعى إلى الإلهاء".
فمثلاً تعدّ منصّات التواصل الاجتماعي، مجالاً للتدفّق المعلوماتي الهائل للمحتوى، "ما يُعيقنا من إدراك الواقع بشكل سليم وصحيح، والتعرّف على متطلباتنا الملحة والضرورية، وهو ما يجعلنا نهتم بالأشياء التي لا نريد الاهتمام بها"، على حد تعبير الكاتب.
من أبرز آثار الارتهان للمستقبل، أن الإنسان لا يستمتع فعلاً بوقت الفراغ أو الوقت الحرّ المخصّص للراحة.
إنه "عصر التشتّت" بامتياز، وهو يسهم في عدم السيطرة عليه وتدبيره بشكل فعّال، وهو ما يولّد نقصاً في الإنتاجية وانحساراً للفعالية، ويؤدي إلى غياب الشعور بالراحة والاطمئنان.
احتضان الحاضر
يعيد الكاتب تعريف مسلّمات يجب النظر إليها من زاوية مختلفة، وهي تتعلق بالحاضر وأوقات الفراغ والصبر. هكذا يرى بأن الحاضر ليس عابراً فقط، بل يكتسي أهمية كبرى حين ننظر إليه بمعزل عن السيرورة الزمنية.
فتعذّر السيطرة على الوقت، يفترض أن نهتم بالآني القريب، أي الحاضر الذي في المتناول، وعدم الارتهان للمستقبل المرادف للقلق والهوس، في حال غلب علينا التفكير به، فلا شيء يقيني ومؤكّد بخصوصه".
لذلك فإنه مصدر دائم للقلق والانفعال، حيث تصطدم انتظاراتنا بالواقع العنيد، المتمثّل في أن الوقت ليس في حوزتنا، ولا يمكن أن يكون تحت قبضتنا. بل وحده احتضان الحاضر، يَحُثّنا على إعطاء المعنى لحياتنا".
من أبرز آثار الارتهان للمستقبل، أن الإنسان لا يستمتع فعلاً بوقت الفراغ أو الوقت الحرّ المخصّص للراحة. لكن ربطه بالإنتاجية على أساس أنه سيساعد على تجديدها، وزيادة الفعالية والمردودية، يُفرغُه من هدفه.
يقول الكاتب في هذا السياق: "يمكنك أن تفعل ما تريد في وقت فراغك، طالما أنه لا ينتقص من فائدتك في العمل، ومن الأفضل أن يزيدها. هكذا نجعل وقت الفراغ مرّة أخرى، في خانة تدبير الوقت المُنتِج، فلا نستمتع به كحاضر آني نقضي فيه لحظات ترفيه واستمتاع مُنزّهة عما عداها".
يدل ذلك على رأي الكاتب حول انعدام الصبر عند الإنسان نتيجة الحياة المتسارعة التي يعيشها، التي تجبره على ألا يضيّع، ولو ثانية واحدة من وقته. في حين أن منطق الأشياء يفترض أن نمنح الوقت الكافي الضروري لما ينبغي إنجازه. وهو يفترض التحلي بالصبر، ومقاومة التسرّع والعُجالة، على عكس الفكرة السائدة في عالمنا الراهن، ما يساعد الفرد على التحكّم فيما يفعله".
تدبير الوقت
يعتقد بوركمان أن "التحدّي الذي يواجه الإنسان المعاصر، موصول بتحقيق توازن بين إقامة جدول بكل الأعمال الواجبة بشكل مستقل وشخصي، ومجاراة إيقاع العالم الخارجي، الذي يضع أمام الإنسان مُستلزمات يتوجّب الوفاء بها".
ويؤكد أن ذلك "يفرض بعض التضحية، والسماح بتدخّل العامل الخارجي (المدراء، الرؤساء، ضغط تحقيق نتائج ناجحة، الأرقام والإحصاءات الدالة على الفعالية، وغيرها)، بشكل معقول، يأخذ في الاعتبار متطلبات الذات لا الجماعة فقط".
كل ذلك برأي الكاتب، "يفرض على الإنسان أن يعي بأن وجوده في الكون ليس بذات الأهمية التي يعتقد، بأن عليه أن يشكّ ويسأل عن مصدر هوسه بهاجس التحكّم في الوقت. وهو ما يحدث عن طريق الوعي، الكفيل بجعله يعيش بشكل مُرضٍ ومفيد".
في نهاية المطاف، فإن تقليص الاهتمام المُبالغ فيه تجاه الوقت، يجلب التواضع والمراجعة الدؤوبة والعلاقة بالوقت. وبالتالي يُسهّل قضاء جزء كبير منه في السعي للوصول إلى ما يُسعد المرء، ويُحرّره من زيف الحصول على مَلَكَة ضبط الزمن.