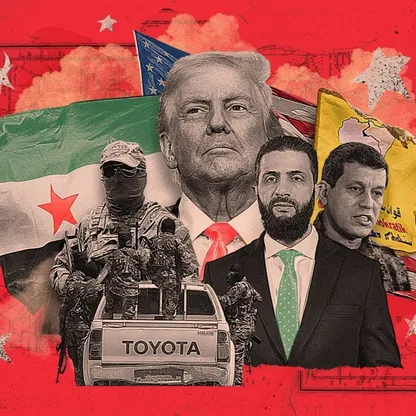مثّل سقوط الأندلس صدمة عاطفية وسياسية للعرب والمسلمين، وأبان كما يشهد الرحّالة الأوروبيون، فشل إسبانيا في التحاقها بالتطوّر الحضاري الأوروبي يومذاك؛ إذ انشغلت بتصفية إرث الأندلس الحضاري، بدءاً بحروب "الاسترداد"، وصولاً إلى طرد الأندلسيين وتهجيرهم قسراً.
"الشرق" حاورت في مدينة تطوان المغربية محمد رضى بودشار، الباحث في تاريخ المغرب والأندلس بعد سقوط غرناطة، حول كتابه "الأندلسيون الأواخر خلال الرحلات الأوربية إلى إسبانيا 1494-1862"، الحائز "جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" عام 2024، ويمنحها "المركز العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق" في أبوظبي.
تثير مسألة مهمّة جداً في كتابك وهي أن إسبانيا أسهمت بقضائها على الحضارة في الأندلس، بتأخّرها حضارياً كدولة مقارنة بأوروبا، كيف ذلك؟
للإجابة عن هذا السؤال، لا بدّ من التذكير بأن حَدَثين بارزَين، قد ميّزا بداية العصر الحديث، وهما سقوط غرناطة في 2 يناير ،1492 من قِبل المَلِكَين الكاثوليكيين إصبيل وفرنندو، ثم اكتشاف أميركا.
كان من المُنتظر أن تحقّق إسبانيا نهضة اقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في ذلك العصر، نظراً لحجم الخيرات والموارد التي كانت ترد إليها. لكن تمّ تسخير ذلك من أجل القضاء على الإرث الأندلسي وتجلياته، فضلاً عن أن العنصر البشري الأندلسي، الذي كان مؤهّلاً دون غيره في تحقيق التطوّر والتقدّم، هو الذي تعرّض للاضطهاد والطرد بسبب انتمائه الديني والحضاري.
فقدت إسبانيا نهضتها المأمولة بعد طرد الأندلسيين وحملة التطهير العرقي والديني
وبذلك لم تتمكن الدولة الإسبانية من حفظ الاستمرارية الحضارية الأندلسية، بل عملت على التخلص منه، والقيام بحملة تطهير عرقي وديني، من أجل تحقيق وحدة سياسية ودينية لملكية مطلقة ناشئة في أوروبا، في نهاية القرن الخامس عشر.
لقد أرادت أن تصبح دولة أوروبية خالصة، لكن وجدت نفسها خارج السياق الأور,بي السائر نحو الأنوار والحداثة يومذاك، بسبب خضوع الدولة لهوى الكنيسة وهيمنة التعصّب الديني، إضافة إلى سوء التدبير الإداري والسياسي.
الاصطلاح الشائع في ما يتعلق بالعرب والمسلمين، الذين تعرّضوا للتنصير الإجباري والذين هجّروا قسراً، هو "الموريسكيون"، لكنك تجترح في كتابك توصيفاً "الأندلسيون الأواخر" لماذا؟
عندما تختار جماعة بشرية اسماً لها، فمن الواجب على الجميع أن يناديها بذلك الاسم، ومن ثم فإن المعنيين بالأمر كانوا يُسمّون أنفسهم "أندلسيون". المصادر العربية لم تستعمل مصطلح "موريسكي" إلا في وقت متأخّر مع الأمير شكيب أرسلان، وظلّ اعتمادها على مصطلحات مثل: الأندلسيون، بقايا الأندلس، بقية المسلمين..
لكننا آثرنا إضافة نعت "الأواخر" للتمييز بين مرحلتين فارقتين: قبل سقوط غرناطة وبعدها. في حين نجد أن الإسبان، كانوا يستعملون هذا المصطلح الموريسكي (ة)، تعبيراً عن المنتجات المادية والثقافية للمسلمين الإسبان؛ أي كل ما أنتجه "المورو" = المسلم في تلك البلاد، هو موريسكي.
بيد أنه بعد الشروع في علمية التنصير القسري سنة 1502، أضحى يطلق على الجماعة الأندلسية المنصّرة: مسيحيون جُدد من أصل "مورو"، أي من أصل مسلم.
لم يتوان الرحّالة الأوربيون، عن التعبير عن انبهارهم بالحضارة الإسلامية في إسبانيا، ومهارة الأندلسيين وجدّيتهم في العمل
كيف نظر الرحّالة الأوربيون في تاريخ الأندلس حضارياً وعلمياً وكحكومة "إسلامية" في وسط أوروبي – مسيحي (ثمانية قرون)، وفقاً للوثائق التي اكتشفوها وبحسب أدبائهم أيضاً بعيداً عن السياسة والعنصرية؟
لم يتوان الرحّالون الأوربيون، بدءاً من الألماني هيرونيموس مونتزر، الذي زار إسبانيا سنة 1494، أي سنتين بعد سقوط غرناطة، إلى شارل دفيي الذي زارها سنة 1861، عن التعبير عن انبهارهم الكبير بالحضارة الإسلامية في إسبانيا.
فالأوّل على الرغم من استعماله بعض التسميات الدالة على التباين الحضاري والديني بخصوص المسلمين من قبيل: الوثنيون، الكفّار، السرزانيون، المحمديون، أتباع دين محمد، فإنه أشاد كثيراً بمهارة هؤلاء الأندلسيين في الزراعة وتقنيات الريّ، والعمارة والبناء، وصناعة الحرير، فضلاً عن جدّيتهم في العمل على عكس "المسيحيين".
شكّلت محاكم التفتيش وصمة عار وأسهمت في تشكيل ما يعرف بـ"الأسطورة السوداء" في تاريخ إسبانيا.
بل أكثر من ذلك، يعدّ مونتزر نفسه، شاهداً على الخراب الذي أصاب الأراضي التي خرج أو طُرد منها المسلمون. وهذه كلها ميزات، تعكس مجتمعاً متحضّراً ومتطوّراً. وقد تكرّرت هذا التوصيفات في الرحلات الأخرى لإسبانيا في أزمنة لاحقة، إذ كانت ترصد أوجه الفرق بين المجموعتين البشريتين المقيمتين في الأراضي الإسبانية: الأندلسيون أو الموريسكيون، والإسبان.
الأندلس في لوحات الرسام غوستاف دروي
كلّ تلك المؤهّلات، جعلت من إسبانيا القبلة المفضّلة للبريطانيين الذين زاروها في القرن 18، في سياق ما عُرف بـالرحلات الكبرى "Grand Tour"، وكذلك الفرنسيين الذي أمّوا إليها في القرن 19، في ظل تيار الحركة الرومانسية.
في هذا الخصوص، نذكر "شارل دفيي"، الذي لم يكتف بتوصيف الآثار الإسلامية بإسبانيا، وإنما عمل على ترميم الكثير من القطع الأثرية، والتعريف بهذا الكنز في فرنسا وأوروبا، ورافقه في رحلته تلك الرسام "غوستاف دروي"، الذي خلّد لوحات ورسومات، فكانت بذلك هذه الرحلة متميّزة جداً لأنها تجمع بين المكتوب والمرسوم.
تعرّض "الأندلسيون" للتعذيب والتنكيل بعد سقوط دولتهم رغماً من إشهار البعض المسيحية، وتمّ التجسّس عليهم لمعرفة دينهم الجديد من عدمه، وذلك بمراقبة جريان الماء يوم الجمعة، كيف رصد الرحّالة الأوربيون هذا التطهير المنهجي؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، يمكن القول إن محاكم التفتيش، تعدّ إحدى وسائل دفاع الكاثوليكية عن نفسها أوّلاً تجاه الأديان غير المسيحية (الإسلام واليهودية)، وتجاه باقي المذاهب وخصوصاً منها البروتستانتية، غير أن هذا العمل شكّل وصمة عار لها، وساهم في تشكيل ما يعرف بـ"الأسطورة السوداء" في تاريخ إسبانيا.
يمكن القول إن الحديث عن محاكم التفتيش، واضطهادها للمسلمين في إسبانيا في القرن الثامن عشر، كان أحد أهم الموضوعات التي تطرّق إليها الرحّالة الأوربيون، بحيث تحدث البريطاني "جوزيف تاونزند" عن إيقاف محاكم التفتيش سنة 1726، لأكثر من 360 عائلة بتهمة ممارسة "الديانة المحمدية"، وأنها كانت على يقين من وجود عدد من المحمديين = المسلمين، لائذين بالجبال، وهي الرواية نفسها التي نجدها عند "هنري سوينبرن"، مع اختلاف في بعض التفاصيل والأرقام.
إن هذا العمل الشنيع الذي قامت بها السلطات الكنسية يومئذ، تعرّض لانتقادات حادّة من لدن الرحّالين الأوروبيين، الذين أخذت تهبّ عليهم رياح الأنوار، وكأن لسان حالهم يقول إن إسبانيا حينما أرادت أن تصير أوروبية تماماً، عن طريق التطهير الديني، وجدت نفسها مرّة أخرى خارج أوروبا مرّة ثانية، التي أضحت تنبذ هذه الأشكال من التعصّب الديني.
الفرق الجوهري بين الرحّالة المغاربة والأوروبيين، يتجلى في تلك العاطفة الجيّاشة التي سادت نصوص المغاربة، والحزن على سقوط الأندلس. هكذا كانوا يقولون عنها "أعادها الله دار إسلام" ..
الاستثناء الوحيد الذي وقفنا عليه هو للرحّالة إدوارد كليرك، الذي نوّه بدور محاكم التفتيش في الحفاظ على الوحدة الدينية لإسبانيا. في الوقت الذي يذهب فيه الفرنسي "دو لا بورد"، إلى أن إجراءات محاكم التفتيش تعكس الفشل الذي مُني به رجال الدين في عملية تنصير المسلمين.
لم تكتف إسبانيا بإجراءات محاكم التفتيش، بل لجأت إلى طرد المسلمين بين أعوام 1609 و1614، إلى أيّ حد طغى هذا الموضوع في الرحلات التي درستها، وماذا كانت وجهة نظر أصحابها؟
منذ الرحلة الأولى، يتبدّى لنا أن المناطق التي خرج منها الأندلسيون قد آلت إلى الخراب.. هذه هي الحقيقة التي سعى الرحّالون الأوربيون إلى تأكيدها وإذاعتها، ومفادها أن إسبانيا، في الوقت الذي كانت فيه باقي بلدان أوروبا الغربية، تنجز نهضتها وتمرّ إلى الأنوار وقيم الحداثة تدريجياً، بالموازاة مع الخروج من هيمنة الكنيسة إلى تطوير العلم والتقنية وأنظمة العمل، عملت على تحقيق وحدة سياسية ودينية، وإقصاء بل وإبعاد خيرة مواردها البشرية، التي كانت على مستوى عالٍ من التجربة في ميدان الفلاحة والحرف والهندسة والمعمارية، على الرغم من إبقائها على القلة القليلة منها لحفظ ذلك، في خضم مسلسل إعادة التعمير، وحفظ جزء من تلك النظم الأندلسية.
والحاصل أن الرحّالين الأوروبيين، حمّلوا مسؤولية التأخّر الإسباني عن ركب التقدّم الأوربي إلى هذا الطرد الشنيع، من منظورَين: الأوّل أخلاقي إنساني، والثاني عملي براغماتي.
من المعروف أنه لدى المغاربة إرث تاريخي في أدب الرحلة، بما في ذلك إلى إسبانيا، ما الفرق بين رحلات الأوربيين ورحلات المغاربة إلى هذا البلد؟
كان المغاربة، لبواعث جغرافية وتاريخية، سبّاقين للرحلة إلى الديار الإسبانية، من أجل استرجاع مخطوطات المكتبة "الزيدانية"، والتفاوض بشأن إطلاق الأسرى المسلمين، وكذلك لإبرام معاهدات الصلح والتجارة.
نذكر في هذا السياق محمد الغساني الأندلسي، المهدي الغزالي الفاسي الأندلسي، وابن عثمان المكناسي. لكن الفرق الجوهري بين الرحّالين المغاربة والأوربيين، يتجلى أساسا في تلك العاطفة الجيّاشة التي سادت نصوص المغاربة، وذلك الحزن على سقوط الأندلس.
وهكذا، كانوا يقولون عنها "أعادها الله دار إسلام" ، ودونوا في رحلاتهم ألقاب الأندلسيين، ومماثلتها لألقاب أخوانهم الذي استقرّوا بالمغرب، إلى جانب الإشارة إلى مباينة أخلاقهم لأخلاق العجم. غير أنهم رصدوا، امتزاج عاداتهم وتقاليدهم مع عادات النصارى، وهو ما تأسفوا عليه كثيراً.
يقول مستشرق إسباني: تحت جلد أي إسباني، تجد عربياً تحته! هل أسهمت الأندلس بتكوين الشخصية الإسبانية، ثم بتاريخ إسبانيا الحديث لاحقاً؟
أثّرت التجربة التاريخية الأندلسية تأثيراً جلياً على إسبانيا الحالية؛ فعلى مستوى اللغة، تزخر الإسبانية بآلاف الكلمات العربية. كما تشكّل المعالم التاريخية مورداً مالياً مهمّاً للدولة الإسبانية، إلى جانب كونها مرجعية معمارية أساسية هناك.
أما على المستوى البشري، فيتجلى ذلك في ملامح بعض أهلها، وسلوكهم وتقاليدهم، وميلهم إلى الحياة الاجتماعية، وحب النكتة والمرح والكرم، لهذا اعتبرها الرحّالون الأوربيون بمثابة "الشرق القريب" أو "الشرق الداخلي".